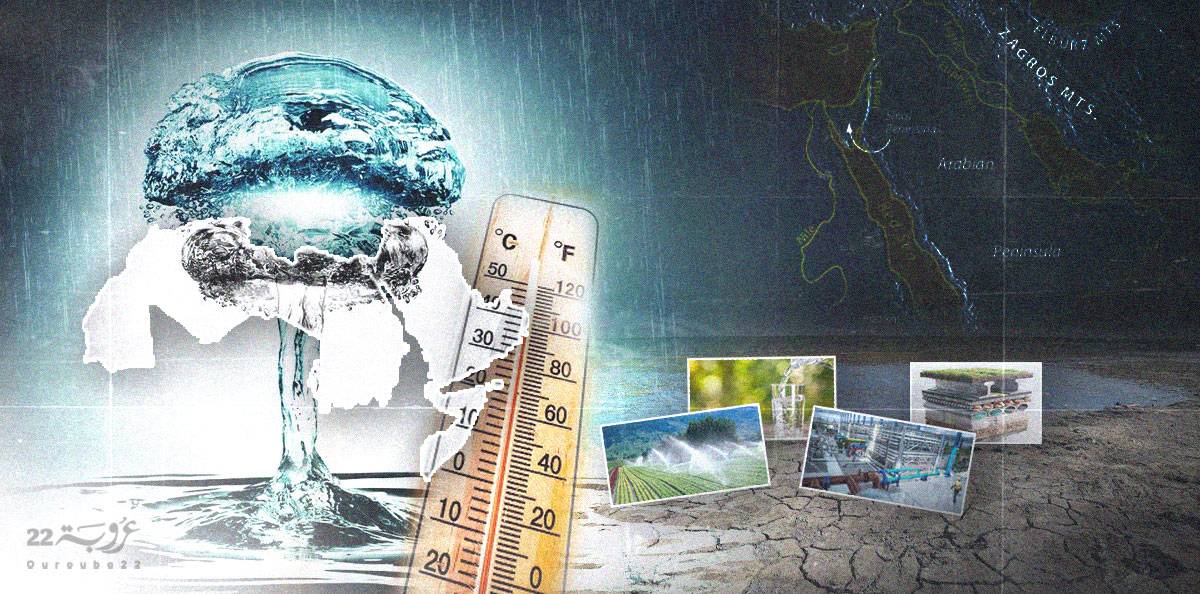بحسب تقارير الأمم المتحدة، ينمو الطلب العالمي على المياه العذبة بمعدل 1% سنويًا منذ ثمانينيّات القرن الماضي. وقد أدّى ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد المناطق المعرّضة لضغط مائي ونقص حادّ في الموارد. حاليًا، يعيش حوالى ملياري شخص في مناطق تعاني من ضغط مائي كبير، بينما يواجه نحو أربعة مليارات شخص ندرةً شديدةً في المياه على مدار ما لا يقلّ عن ثلاثين يومًا سنويًا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للمياه لعام 2019.
تحوّلت قضية الأمن المائي إلى ورقة ضغط سياسي تستخدمها الأنظمة الحاكمة لبسط النفوذ والسيطرة
وَضعت خطة التنمية المُستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 هدفًا خاصًا بالمياه ضمن أهدافها السبعة عشر، وهو الهدف السادس الذي يرمي إلى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي مع إدارتها بطريقة مستدامة. ويرتبط بهذا الهدف عدّة مقاصِد ووسيلتيْن للتنفيذ، تتناول مختلف جوانب المياه. ومع ذلك، فإنّ قضية المياه تتجاوز الهدف السادس، حيث تُعدّ عنصرًا مركزيًا في العديد من الأهداف والمقاصد الأخرى. تشمل تلك المقاصد ما هو أكثر من حقّ الإنسان في الحصول على مياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي مناسبة، لتتضمّن معالجة المياه الملوّثة وإعادة استخدامها، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات كافّة، والتصدّي لأزمة ندرة المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وحماية واستعادة النُظُم الإيكولوجية المرتبطة بالمياه.
هذه التحدّيات جعلت قضية المياه مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الأمن المائي، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية. وغالبًا ما تحوّلت قضية الأمن المائي إلى ورقة ضغط سياسي تستخدمها الأنظمة الحاكمة لبسط النفوذ والسيطرة. وبما أنّ أحواض الأنهار الدولية تُعدّ مصدر حياة لنحو 40% من سكان العالم، فقد أصبحت المياه عاملًا رئيسيًا يؤثِّر في القرارات السياسية والاقتصادية، ويُشكِّل محورًا هامًا للعلاقات الدولية، بل وحتى محرّكًا محتملًا للصراعات المستقبلية بين الدول التي تتنازع على استخدام تلك الأحواض واستغلالها.
في منطقة الشرق الأوسط، كانت إدارة الموارد المائية وتنميتها عنصرًا محوريًا عبر التاريخ في تحقيق التنمية وتطوّر الحضارات. فقد ازدهرت الحضارة المصرية القديمة على ضفاف نهر النيل، كما قامت الحضارة العراقية على نهرَي دجلة والفرات، مما يُبرز أهمية المياه في بناء المجتمعات المستقرّة. ويظل شرق وجنوب شرق البحر المتوسط من أكثر المناطق تعرّضًا لندرة المياه، مما يؤدّي إلى تفاقم التوتّرات المحلية والإقليمية.
يعاني العالم العربي من أدنى معدّلات نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة عالميًا، حيث يبلغ المتوسط أقلّ من 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقلّ بكثير من حدّ الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب.
في الدول العربية، يعيش حوالى 390 مليون شخص، أي ما يعادل 90% من سكان العالم العربي، في ظلّ ندرة مائية حادّة. أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ عام، فإنّ 83% من السكان يعيشون تحت ضغط مائي مرتفع للغاية. وتشيرُ التوقُّعات إلى أنّ الطلب العالمي على المياه سيزداد بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% بحلول عام 2050، مما يزيد من تفاقم الأزمة في المنطقة.
الحاجة إلى حلول مبتكرة أصبحت مُلحّة في إطار من التعاون الإقليمي للاشتباك مع قضية وجوديّة
يُمثّل الأمن المائي تحدّيًا رئيسيًا في العالم العربي، حيث المناخات الجافّة والموارد المحدودة من المياه العذبة، تلتقي مع تزايد النموّ السكاني لتُشكّل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.
يُشكّل العالم العربي 5% من سكان الكوكب، ويعتمد على 1% فقط من موارد المياه العذبة المتجدّدة في العالم. ومع انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجدّدة إلى نصف الحدّ الأدنى العالمي، فإنّ الحاجة إلى حلول مبتكرة أصبحت مُلحّة، بخاصّة إذا تمّ صياغتها في إطار من التعاون الإقليمي، للاشتباك مع قضية وجوديّة لا تنافسها أي قضية أخرى في الإلحاح. وتُعتبر التقنيات المتقدّمة بمثابة طوق النجاة، حيث تُقدّم حلولًا عملية وقابلة للتوسّع لتحقيق التوازن وسدّ الفجوات المائية.
في الأراضي الفلسطينية، يعتمد المزارعون على هطول الأمطار الذي يتسم بعدم انتظامه وعدم موثوقيته، بينما يتمتع المزارعون الإسرائيليون بأنظمة ريّ حديثة ومدعومة بكثافة من قبل السلطات، مما يعمّق الفجوة بين الطرفيْن. كما تعاني غزّة من نقص حاد في المياه، حيث إنّ 97% من مياه الطبقة الجوفية الساحلية غير صالحة للاستهلاك البشري.
في اليمن، يفتقر 80% من السكّان إلى الوصول إلى مياه شرب آمنة. أمّا سوريا، التي دمّرها عقد كامل من الصراع، فقد شهدت تدمير ما يقرب من ثلثي محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخّ. بينما تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، لكنّها تواجه تحدّيات بسبب التطوّرات في الدول الواقعة أعلى النهر.
وفي الوقت نفسِه، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات بشكلٍ كبيرٍ على تحلية المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يفرض ضغوطًا كبيرةً على استخدامات الطاقة. أمّا لبنان، فيواجه تحدّيات كبيرة في المياه، حيث تصل نسبة مَن يمتلكون مياه شرب آمنة إلى 48% فقط في بعض التقديرات.
تكاليف التشغيل والصيانة عنصر حيوي للبنى التحتية والنزاعات سبب رئيسي في تدمير مرافق المياه والصرف الصحي
ومن أبرز التحدّيات التي تواجه تحقيق الأمن المائي في المنطقة هو النقص الكبير في التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الخاصّة بالمياه والصرف الصحي. وتشير التقديرات إلى أنّ تحقيق هدفَي التنمية المستدامة المتعلقيْن بالمياه على مستوى العالم يتطلّب استثمارات ضخمة تُقدّر بحوالى 114 مليار دولار. وعلى الرَّغم من أن هذا التمويل لن يغطّي جميع التحديات، إلّا أنه يوضح حجم الاستثمار المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تُمثّل تكاليف التشغيل والصيانة عنصرًا حيويًا لضمان استدامة البنى التحتية للمياه، وهو تحدٍّ يتطلب التزامًا طويل الأجل. كما أنّ تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية التي دُمّرت بسبب النزاعات تضيف أعباء إضافية. ففي سوريا والعراق واليمن، كانت النزاعات سببًا رئيسيًا في تدمير مرافق المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال، قُدّرت تكلفة إعادة بناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العراق وحده بسبب النزاع الأخير مع تنظيم "داعش" بحوالى 600 مليون دولار.
(خاص "عروبة 22")