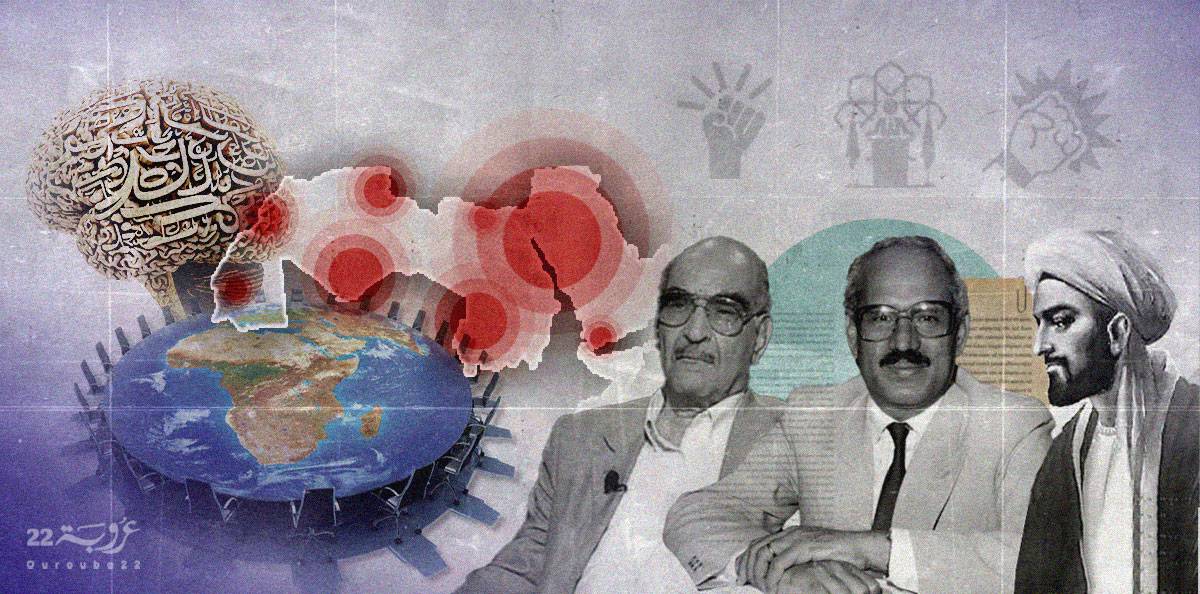العامل الأول يظهر في تفكّك وهشاشة الوجود السياسي العربي تاريخيًا لأسبابٍ تتعلّق بالفجوات الصحراوية الفاصلة بين الحواضر الكبرى وبالبنيات العشائريّة المانعة لتَشكُّل قطبٍ سياسيّ مركزيّ ثابتٍ، والعامل الثاني يبرز في ضحالة وعدم وضوح المُقاربات النهضوية في الخطاب العربي الحديث والمعاصر.
لا شكّ أنّ ابن خلدون قد وقف بالتفصيل عند طبيعة العامل الأول في منظوره المعروف للديناميكيّة العصبية التي هي في آنٍ واحدٍ القوّة المحرّكة للبناء السياسي ومِعول هدْم هذا البناء، ومن هنا كلامه المشهور حول "توحّش" العرب وميْلهم للتخريب والتدمير و"بُعدهم عن السياسة وتدبير الحُكْم". وعلى غرار الكثير من علماء السياسة والاجتماع المحدّثين، رأى الأنصاري أنّ نموذج ابن خلدون لا يزال ينطبق على الواقع العربي المعاصِر، على الرَّغم من كونه يعكس تاريخ الدولة العربية الوسيطة.
ابتلعت الدولة المجتمع الأهلي وامتصّت السياسة المجال العمومي بكامله
بيْد أنّ المشكل النظري الحاد الذي يطرحه تطبيق نظرية ابن خلدون على نمط الاجتماع السياسي العربي الرّاهن يكمن في الفارق الجوهري بين الدولة العصبيّة التقليدية - أو الدولة السلطانيّة حسب عبارة عبد الله العروي المستمَدّة جزئيًا من سوسيولوجيا ماكس فيبر - والدولة الوطنية الحديثة التي هي شكل الحُكْم المعتمد في البلدان العربية ما بعد الكولونيالية.
قد يذهب البعض إلى أنّ هذه الدولة لم تأخذ من الحداثة إلا قشورها، وظلّت في عمقها قائمةً على الهياكل العصبيّة، حتّى في البلدان التي رفعت شعار الاشتراكية والتقدّم وكانت في واقعها محكومةً بأنظمةٍ طائفيةٍ أو قبليةٍ "متخلّفة". وقد كان المرحوم محمد عابد الجابري يقول إنّ الحالة السياسية العربية لا تزال تخضع لثلاثيّة القبيلة والغنيمة والعقيدة التي هي ثوابت العقل السياسي العربي قديمًا وحديثًا.
إلّا أنّ هذا التحليل يظلّ قاصرًا عن فهم مسار الدولة العربية الحالية التي اعتمدت في بنائها المؤسّسي محدِّدات السياسة المدنية الحديثة، بغضّ النظر عن درجة التلاؤم معها، وأبرز هذه المحدّدات هي: الشرعية القانونية البيروقراطية، والسيادة المُطْلَقَة، واحتكار العنف المشروع، والفصل بين السلطات...
من الواضح أنّ هذا النموذج في بنائه الصُوَرِي والرّمزي يولّد واقعًا جديدًا، يستفيد منه المُمسكون بالحُكْم لتوطيد دائرة النفوذ والقرار في ما وراء الهامش الذي كان يُتيحه النظام السياسي التقليدي القائم على مبدأ الطّاعة المُطلقة لكن ضمن إطارٍ ضيّقٍ للمجال السياسي، وهو ما تستفيد منه أيضًا القوى المعارضة الشرعيّة وغير الشرعيّة لما توفّره البنية الجديدة للسلطة من إمكانات احتجاجيّة قد تكون مقيّدةً ومحدودةً لكنّها تظلّ قائمةً ومبرّرةً ولو مبدئيًا.
الدولة الوطنية هي القوة التحديثيّة الحاسمة للمجتمعات العربيّة
في الدولة العربية الوسيطة، كان الحاكم متمتّعًا بكلّ السلطات السياسية، لكن مجال السياسة كان ضيّقًا ومحدودًا في مقابل اتّساع وحيوية المجتمع الأهلي، كما كانت المعارضة نوعًا من البغي والتمرّد غير المشروع لا يمكن تبريره. في الحالة السياسية الجديدة، ابتلعت الدولة المجتمع الأهلي وامتصّت السياسة المجال العمومي بكامله، لكن الانزياح القائم بين السلطة والدولة فَتَحَ هوامش حركةٍ واحتجاج غير مسبوقة للقوى السياسية، قد تظلّ مقموعةً مؤقتًا لكنها في بعض اللحظات الحاسمة تخرج للعلن (كما حدث في العراق وليبيا وسوريا بعد سقوط الأنظمة الحزبية الأحادية).
كان الفيلسوف الألماني جورج فيلهلم فريدريش هيغل يقول إنّ الشكل غالبًا ما يُوَلّدُ المضمون، في جدليةٍ عميقةٍ بين الصورة والمِثال، وذلك ما يُترجَم في الواقع السياسي العربي بمسار التحوّل الذي لا بدّ أن تُفضي إليه الدولة الوطنية التي هي القوة التحديثيّة الحاسمة للمجتمعات العربيّة.
(خاص "عروبة 22")