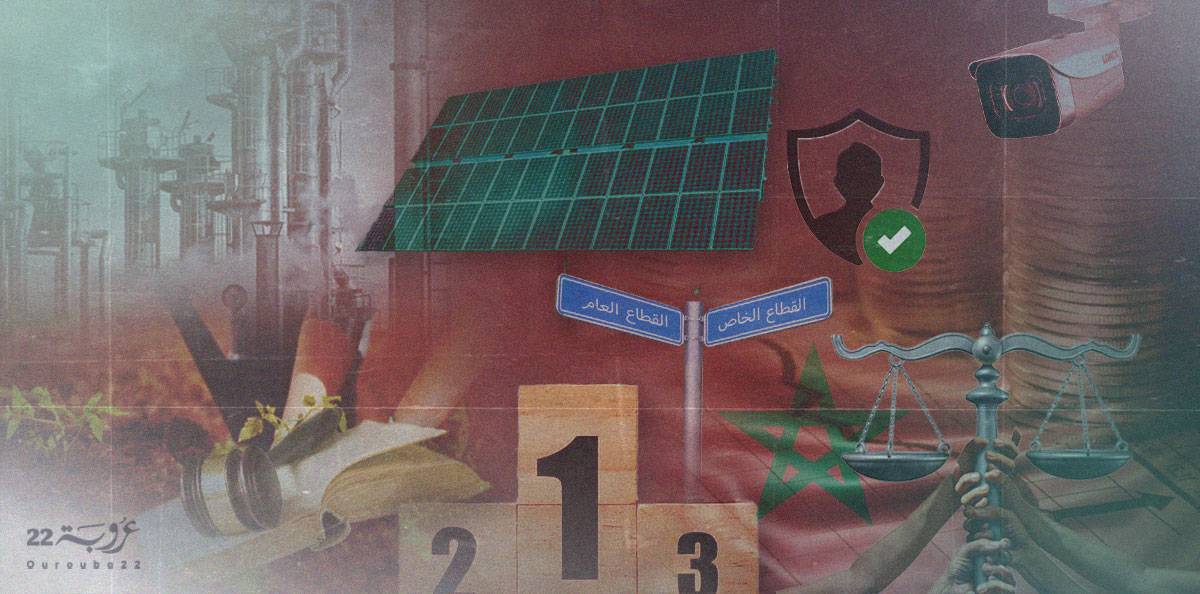في إطار هذا التحوّل، عملت هذه الدول على إرساء أُطرٍ تشريعيةٍ ومؤسّساتيةٍ جديدةٍ تتماشى مع هذه التوجّهات إذ اتخذت دول كالمغرب والجزائر خطوات مُهمّة من أجل تجديد الإطار التشريعي الخاصّ بالاستثمار بغية إفساح المجال أكثر فأكثر للخواص ومواكبة التحوّلات الاقتصادية التي شهدها ويشهدها العالم.
مخاوف مشروعة
إنّ ميثاق الاستثمار الجديد، الذي سبق عرض مضامينه على العاهل المغربي محمد السادس، يُجسّد ملامح العقيدة الاقتصادية الحديثة للمغرب، القائمة على تسريع التحوّل من اقتصادٍ هشّ وغير مستقر يعتمد على الفلاحة والخدمات، ويُهيمن عليه الفاعل الحكومي، إلى اقتصادٍ أكثر استقرارًا وتوازنًا يرتكز على الصناعة والطاقات المتجدّدة، وأكثر انفتاحًا على الاستثمار الخاص؛ وهي عقيدة يُواكبها سعيٌ مُتزايدٌ نحو توسيع مجال تدخل الفاعل الخاص في المشهد الاقتصادي المغربي.
فإلى جانب فتح آفاقٍ استثماريةٍ جديدةٍ في مجالاتٍ حيويةٍ كالصناعات الدفاعية والدوائية، والسعي لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية والطرقية والمينائية التي تتطلّب رؤوس أموال ضخمة تتجاوز قدرات الفاعل الحكومي، فإنّ حجم الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب، وما تفرضه من تعبئةٍ ماليةٍ هائلةٍ، جعلَ إشراك الفاعلين الخواص في المجهود الاستثماري ضرورةً ملحةً لا ترفًا. ولهذا، وضعت الحكومة معادلةً جديدةً تقضي بأن يُسند ثلثا الاستثمار للقطاع الخاص، والثلث الأخير للقطاع العام، في أفق عام 2030.
عجز المنظومة القانونية والمؤسّساتية عن الحدّ من تغوّل بعض اللوبيات الاقتصادية وعن فرض قواعد المنافسة العادلة
وعلى الرَّغم من مشروعيّة هذا الطموح، فإنّه لا يُبدّد المخاوف المتصاعدة من تضخّم الحضور الاستثماري للقطاع الخاص، وتراجُع دور الدولة في عددٍ من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة القطاع الخاص على التعويض، وقدرته أيضًا على الحفاظ على المبادئ العمومية المؤطّرة للمرفق العام، ومدى وجاهة انسحاب الفاعل العمومي في ظلّ تبنّي المغرب لشعار "الدولة الاجتماعية". فضلًا عن أسئلة حول فعّالية آليات التتبّع والرقابة، وإمكانيّة ضبط التنافسيّة بين الفاعلين، وحماية المُستهلك في ظلّ تكرار مظاهر التواطؤ والاحتكار والتركيز الاقتصادي، التي تتعارض مع قوانين المنافسة وحماية المستهلك.
لا شكّ أنّ هذه المخاوف مشروعة، بالنظر إلى العجز الظاهر للمنظومة القانونية والمؤسّساتية الحالية عن الحدّ من تغوّل بعض اللوبيات الاقتصادية، وعن قدرتها على فرض قواعد المنافسة العادلة. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى عددٍ من الحالات التي بَتَّ فيها مجلس المنافسة في قطاعاتٍ كالاتصالات والزيوت الغذائية والتعليم الخاص والمحروقات. فعلى الرَّغم من إصدار المجلس قرارات إدانة وتغريم المقاولات المعنية، فإنّ آثار هذه القرارات في المشهد الاقتصادي ظلّت محدودةً ومن دون أثر يذكر. ويُعزى ذلك إلى ما يبدو تخوّفًا لدى الفاعل الحكومي من تشديد العقوبات وتفعيل الجانب الزّجري في التشريع الاقتصادي، خشية المساس بجاذبية المغرب الاستثمارية، في زمنٍ تتسابق فيه الدول لاستقطاب كبريات الشركات وتوطين استثماراتها. وعلى الرَّغم من تفهّمنا لهذه "الخشية"، إلّا أنّه ينبغي أن لا تتحوّل إلى مُبرّرٍ لتحييد النصوص القانونية عن أهدافها، أو لتقزيم دور مؤسّساتٍ رقابيةٍ كمجلس المنافسة وتحويلها إلى أجهزةٍ رمزيةٍ تكتفي بإصدار الآراء وتقديم التوصيات.
المعادلة الصعبة، الزجر والمرونة
لا يجوز تكرار أخطاء الماضي، التي قامت على تحصين الفاعل الاقتصادي، مهما كانت طبيعته (خاص أو عام)، من الرقابة والمساءلة، لأنّ ذلك قد يؤدّي إلى تغوّل اللوبيات وتحوّلها إلى حواجز حقيقيّة أمام تنفيذ السياسات العمومية، بل وقد يُعطل مؤسّسات دستورية واقتصادية وقضائية. وهذه خسارة لا يعوّضها ما يُرجى من منافع فتح الباب أمام استثماراتٍ غير منضبطة. كما أنّ ذلك يُهدّد الاستقرارَيْن الاقتصادي والاجتماعي، سواءً على المدى المتوسّط أو البعيد.
تقليص دور الفاعل العمومي لا يمكن أن يتمّ من دون تعزيزه على مستوى الرقابة والتخطيط والقضاء والزجر
ولا مَندوحة من الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ المغرب حرص، منذ تبنّيه سياسة التحرير والخوصصة، على وضع الأطر القانونية الضرورية لمواكبة هذا النهج، كما أنشأ منظومةً مؤسّساتيةً لمراقبة التنافس وضمان حماية المستهلك. غير أنّ التحوّلات العميقة التي يعرفها الاقتصاد المغربي كشفت عن مكامن خللٍ عديدةٍ، في مقدّمتها القدرة المحدودة لهذه المؤسّسات على تفكيك التواطؤات بين عددٍ من الفاعلين الخواص، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الحصص السوقيّة، الأمر الذي يخلق احتكاراتٍ فعليةً تمنع دخول فاعلين جدد، وتُعيق تطوّر المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما برز عجز هذه المؤسّسة عن مواجهة ممارساتٍ تهمّ تسقيف الأرباح عند مستوياتٍ عاليةٍ بطريقةٍ تتجاهل قواعد العرض والطلب. وهذان الأنموذجان أثارا جدلًا واسعًا في المغرب، ودفعا عددًا من المهتمّين إلى انتقاد النصوص المؤطّرة للمنافسة وحماية المستهلك، واتّهام المؤسّسات المكلّفة بإنفاذها بالعجز عن مجابهة لوبيات قوية، بات لها نفوذ واضح على القرار الحكومي، بل وحتّى على صياغة وإنفاذ النصوص التشريعية، بما فيها قوانين المالية.
حين يُنفَّذ القانون بمرونة يجب أن لا يفقد قوته الردعِيَّة كما أنّ المرونة ينبغي أن لا تتحوّل إلى تعطيل للمؤسّسات الدستورية
لا نروم هنا تقييم تجربة المغرب في الخوصصة والتحرير، ولا إصدار أحكام قيمة نهائية بشأنها، وإنّما نسعى إلى لفت الانتباه إلى أنّ تقليص دور الفاعل العمومي على المستوى الاقتصادي، لا يمكن أن يتمّ من دون تعزيزه على مستوى الرقابة والتخطيط والقضاء والزجر. إذ لا معنى لدولةٍ ترفع شعار الدولة الاجتماعية، من دون أن تفرض سيادتها الاقتصادية، وتُوجِّه الفاعلين وفق رؤية تنموية تُعلي من الشأن الاجتماعي وتُرسّخ مبدأ التوازن. وهو أمرٌ ممكنٌ، بحكم أنّ الوثيقة الدستورية، إلى جانب الإطار التشريعي المغربي، يمنحان الدولة الصلاحيات الكافية لبسط رقابتها وضبط التوازنات، من دون أن يعني ذلك التضييق على الاستثمار الخاص. فالقانون، حين يُنفَّذ بمرونة، يجب أن لا يفقد قوته الردعِيَّة، كما أنّ المرونة المنشودة ينبغي أن لا تتحوّل بأي شكل إلى تغاضٍ عن الخروقات، أو إلى تعطيلٍ لعمل المؤسّسات الدستورية.
(خاص "عروبة 22")