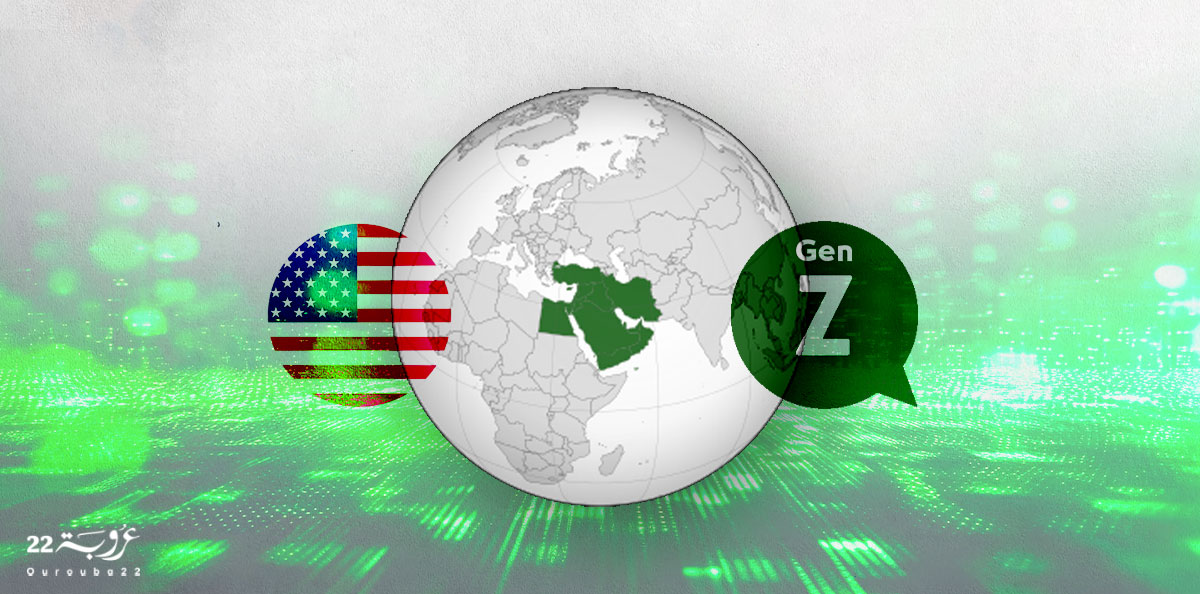من الإنصاف القول إنّ الهجمة الأميركية هذه المرّة على يد ترامب، خاصةً منذ قبول العرب والمسلمين خطته لإنهاء الحرب في غزّة، تحتوي على تصميمٍ أكبر بسبب توافر حوافز إيديولوجية ومصالح شخصية لترامب وعائلته ومبعوثيه إلى المنطقة "كوشنر وباراك وويتكوف... إلخ". وتحتوي على اندفاعٍ غير محسوبٍ يعود في جزءٍ منه لخفّة هؤلاء المبعوثين القادمين من عالم الأعمال الذين يحتقرون حذر وعقلانية الديبلوماسيين التقليديين ويسخرون من اهتمامهم بجذور الصراعات، ويعتمدون على آليتَيْ عقد الصفقات والضغط الخشن على الأطراف المُختلفة.
يعتمد تصوّر ترامب وفريقه لتغيير الشرق الأوسط وخرائطه وحدوده على فكرتَيْن استشراقيتَيْن؛ الأولى أن الشرق الأوسط الحالي خطّته بالقلم الرّصاص وزارة المستعمرات في لندن. وإذا كان البريطانيون استطاعوا فعل ذلك، فما الذي يمنع أميركا من أن تُكرّر ذلك هذه المرّة من غرفةٍ في واشنطن، ولكن بالذكاء الاصطناعي وليس بالقلم الرصاص. الفكرة الثانية أنّه ليس هناك دولة عربية حديثة بالمعنى الحقيقي وإنّما الموجود هو قبائل وعشائر يمكن إعادة توزيعهم ودمجهم في ترتيبات حدود جديدة تُحقّق مصالح واشنطن.
عجز النظُم عن حماية السيادة والكرامة الوطنية والأمن القومي قد يمثّل العامل المُحفّز لانفجار الغضب بصورة مفاجئة
ويتشجّع هذا التصوّر بما يعتبره حقيقتَيْن جيوسياسيتَيْن تجعلان تفرّده بصياغة الشرق الأوسط هذه المرّة يمرّ من دون مقاومة حقيقية:
- الحقيقة الأولى هي تسليم النظم العربية سواء تلك الغنية أو المأزومة اقتصاديًا، قيادها إلى الإرادة الأميركية ووضعها مفاتيح التسوية الفلسطينية في يدها.
- الحقيقة الثانية أنّ ما يُعرف بـ"محور الممانعة" وإيران، سينكفئ على نفسه لسنواتٍ، وبالتالي لن يستطيع اعتراض الترتيبات الأميركية - الإسرائيلية كما كان يفعل في الماضي.
هذه الحسابات الأميركية التي تقوم على الاعتماد حصريًا على العوامل الجيوسياسية والقوة الخشنة هي "كعب أخيل". فهم ينكبّون مثلًا على دراسة قضايا ظاهرةٍ مثل حتمية نزع سلاح "حماس"، وما هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه قدرة النظام السوري على تقديم تنازلاتٍ أمنيةٍ لإسرائيل؟ وهل يمكن تحويل التنافس التركي - الإسرائيلي إلى تعاونٍ استراتيجيّ تحت إمرتهم؟.
لكنّهم يدرسون قليلًا العوامل الكامنة التي تنتمي إلى القوة الناعمة مثل المشاعر والذاكرة والخبرة التاريخية والأحلام المُؤجّلة والمُجهضة.
سأكتفي هنا بذكر عاملَيْن يمكن أن يعرقلا المشروع الأميركي - الإسرائيلي أو يجعلانه قلقًا وقابلًا للهدم في مراحل لاحقة:
- العامل الأول هو طاقة الغضب الشعبي العربي ضدّ حكوماتهم والعداء ضدّ إسرائيل وأميركا، التي وصلت بعد حرب غزّة إلى مستوياتٍ مخيفةٍ تخطّت كلّ مستويات الغضب على النظم والعداء للغرب في كلّ جولات الحروب السابقة منذ 1948.
- العامل الثاني هو القوة الحاملة لطاقة الغضب الشعبي الحالي وهي الأجيال الجديدة خاصةً "جيل Z" و"جيل Alpha" اللّاحق له مع استمرار حضور "جيل X" الذي فجّر انتفاضات الربيع العربي.
سيتفاعل هذان العاملان مع بعضهما خصوصًا إذا حقّق الأميركيون هدفهم من الخطة وهي تسوية مُذلّة لغزّة تنتهي بسلطة انتداب استعمارية وفصل القطاع عن الضفّة وقوات عربية وإسلامية تتورّط في صراعٍ مع أشقائهم لنزع سلاح المقاومة فيما يقف الإسرائيلي آمنًا متفرّجًا عليهم. وإذا تمّ كذلك استئناف مسار التطبيع الإبراهيمي بقوةٍ وبدول من الوزن الثقيل مثل السعودية وإندونيسيا مقابل اعترافٍ دوليّ شكليّ بدولةٍ فلسطينيةٍ، فيما الأرض التي يُفترض أن تقوم عليها هذه الدولة تختفي تحت قضم الاستيطان الإسرائيلي الذي سيتوقّف قليلًا حتى تحدث خطوة التطبيع الجديدة ثم يُستأنف من جديد بعدها.
تراجُع شرعية الحكومات العربية وغليان الغضب الشعبي من وقوف حكوماته متفرّجةً أو متواطئةً عامَيْن كاملَيْن على حرب الإبادة والتجويع، سيصل إلى حدّ مرحلة نزعٍ لكامل الشرعية عن هذه الحكومات، إذا وافقت على تسويةٍ مُذلّةٍ للقضية الفلسطينية. وإذا كانت هذه الشعوب تتململ حاليًا من الإخفاق الاقتصادي والفقر والبطالة والغلاء والانسداد السياسي، فإنّ عجزًا من هذه النظُم عن حماية السيادة والكرامة الوطنية والأمن القومي قد يمثّل العامل المُحفّز لانفجار الغضب بصورةٍ مفاجئةٍ في هذا البلد أو ذاك وعلى المدى القصير أو المتوسط.
العامل الأهمّ هو الجيل حامل الغضب، فإذا كانت حرب 1948 قد تسبّبت في غضبٍ عارمٍ لجيلٍ - كان غالبًا من صغار الضبّاط في الجيوش - قام بتغيير معظم الحكومات العربية التي هُزمت في هذه الحرب فإنّ "جيلَيْ Z وAlpha" كأجيالٍ رقميةٍ كاملةٍ تتميّز بأنّها تسبق حكومات السنّ الكبير بأميالٍ ضوئيةٍ في التعامل مع تقنيات عصرها، وانتقلت بسلاسةٍ من عصر الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
حركة تمرّد عالمية تتحدّى النظام النيوليبيرالي الغربي وتتوحّد تحت مظلّة قضية إنسانية مثل فلسطين
هذا الجيل يحمل مشاعر غاضبةً ويسمّيه بعض علماء الاجتماع السياسي "جيل الرّفض"، وهو يحمل كلّ أشواق أجيال آبائه وإخوته الكبار في انتخاباتٍ حرّةٍ وحرية التعبير وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي والخروج من الفقر. كما انتقلت إليه الأحلام المُجهضة بعد فشل الانتفاضات العربية ونجاح ما يُعرف بارتدادات الثورة المضادّة. الفارق بينه وبينهم أنّ النظم السياسية لم تنجح حتى الآن في احتوائه كما فعلت مع الكثير من النّخب الأكبر سنّا. الفارق الأهمّ أنّها لا تحتاج إلى أحزابٍ علنيةٍ ولا تنظيماتٍ سريةٍ ولا تحتاج حتى لقيادةٍ مركزيةٍ، وهي قادرة على التفلّت من المراقبة الأمنية التقليدية والرقمية. وهي تستفيد بانتمائها لحركة تمرّد عالمية من أساليب مقاومة سلمية تتحدّى بها النظام النيوليبيرالي الغربي وتتوحّد تحت مظلّة قضية إنسانية مثل فلسطين.
وتُعتبر تظاهرات هذا العام لجيل "زد" وجيل "ألفا" من المغرب إلى تونس ومن نيبال إلى مدغشقر التي هزّت أسس النظام السياسي، مؤشّرًا على احتمالات انفلات الغضب والمقاومة للمشروع الأميركي لتغيير الشرق الأوسط وزعزعة قائمٍ أساسيّ يرتكز عليه وجود نظم عربية خاضعة له. الخبرة التاريخية تشهد أنّ الغرب لم يشهد عالمًا عربيًا معاديًا له مثلما حدث بعد انفجار الغضب العربي بعد النكبة، لما اعتبره سقوط شرعية الملكيات لهزيمتها في الحرب، ولما اعتبره دورًا غربيًا في تمكين إسرائيل من الاستيلاء على فلسطين وتشريد شعبها.
(خاص "عروبة 22")