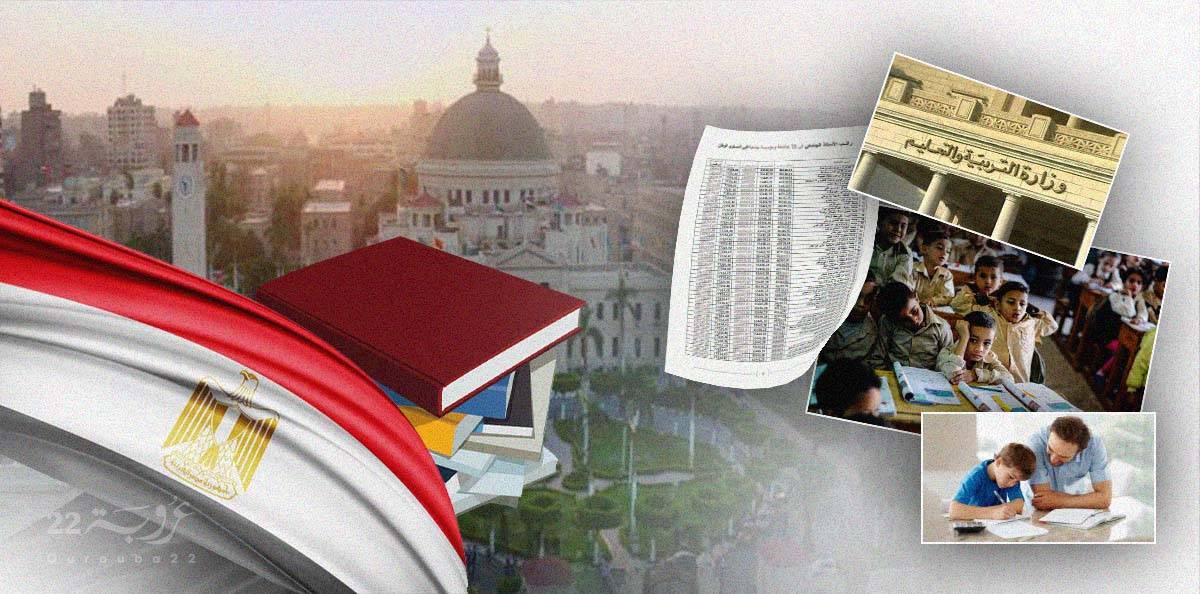في مصر ينصّ الدستور الأخير للبلاد (2014) على أنّ التعليم العام مجاني، وينبغي أن تُنفق عليه الدولة 4% من قيمة الناتج القومي الإجمالي، كما ينصّ على "استقلال الجامعة"، و"مجانية جامعات الدولة"، وفرض على الدولة أن تنفق عليه 2% من الناتج القومي الإجمالي.
التعليمان قبل الجامعي والجامعي معًا لم يحصلا على نصف ما حدده الدستور لهما
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية القاطعة التي أقسم على احترامها القيادات التنفيذية والتشريعية، ورغم أنّ قيمة الناتج القومي الإجمالي تصل إلى 12 تريليون جنيه مصري بحسب وثائق الدولة الرسمية، وهو ما يعني أنّ ما يجب أن يُنفق على التعليم 720 مليار جنيه مصري، يمثلون 6% من هذا الناتج القومي الإجمالي، بواقع 240 مليارًا للتعليم الجامعي والعالي و480 مليارًا للتعليم قبل الجامعي.
لكن الواقع يقول إنّ نصيب الإنفاق على التعليم العالي في العام الدراسي الأخير (2023/2024) قد بلغ فقط 99 مليارًا من الجنيهات، أما التعليم قبل الجامعي فقد بلغ الإنفاق عليه 229 مليارًا من الجنيهات، وهو باختصار ما يؤكد أنّ التعليمين -قبل الجامعي والجامعي- معًا لم يحصلا على نصف ما حدده الدستور لهما.
انعكس ذلك الفقر المالي على تدهور المرتبات والحالة المادية لأعضاء هيئة التدريس، إذ لا يبلغ مرتب الأستاذ الجامعي في أقصى حالاته نحو 20 ألف جنيه أي ما يساوي نحو 400 دولار أمريكي بالأسعار الرسمية للبنوك المصرية، وهو ما أدى إلى انشغال الأساتذة بالبحث عن موارد إضافية، ما ارتد بالسلب على تفرغهم لعملهم كأساتذة وباحثين، وسعى بعضهم نحو التعاقد مع جامعات عربية، أو بالبحث عن فرص عمل في الجامعات الخاصة، ما شكّل نزيفًا حادًا للكفاءات الجامعية.
وهناك ما هو أخطر من عدم تدبير نصيب التعليم الذى قرره الدستور، وهو إعلان القيادة السياسية عدم إيمانها بمجانية التعليم، ومن ثم توجهت القيادة السياسية نحو دعم التعليم الجامعي الخاص والدولي، وتركت الجامعات الحكومية لتواجه حالة الفقر المدقع التي تعانيها بالاعتماد على نفسها حتى ولو خالفت الدستور، ولذلك فقد راحت العديد من الكليات تسعى لزيادة مواردها المالية بإنشاء أقسام تُدرس باللغات الأجنبية تحت مسمى "الأقسام الخاصة" أو "المميّزة"، كما اضطرت إلى فرض مصروفات على مراحل الدراسات العليا بلغت نحو 10 آلاف جنيه في العام وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور.
صار الأمن يهيمن اليوم على الجامعة وأصبح هو من يحدد من يدخل إلى الحرم الجامعي ومن يُـمنع
لهذا لم يكن غريبًا أن تأتي جامعة القاهرة وحدها ضمن قائمة شنغهاي لأفضل 500 جامعة في العالم، وغالبًا تدخل ضمن تلك القائمة لأسباب فنية أو لحصول ثلاثة من خريجيها على جائزة نوبل.
ونأتي أخيرًا إلى واحدة من أخطر قضايا التعليم الجامعي وهي قضية استقلال الجامعة، وهي إحدى القضايا المحورية في التعليم الجامعي منذ قام رئيس وزراء مصر إسماعيل صدقي بنقل طه حسين من عمادة كلية الآداب سنة 1932، إذ صار الأمن يهيمن اليوم على الجامعة، فلا يقتصر وجوده سواء داخل أو خارج أسوار الجامعة على حماية المرافق فقط وإنما أصبح هو من يحدد من يدخل إلى الحرم الجامعي ومن يُـمنع، وهو من يجب الحصول على موافقته قبل إقامة أي فعالية أو نشاط جامعي.
.. وللتعليم قبل الجامعي من الأزمة المالية نصيب
أما إذا انتقلنا إلى التعليم قبل الجامعي فلا شك أنه بتقرير المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية المجانية فقد تم إهدار قيمتَيّ "مجانية التعليم وتكافؤ الفرص"، وهي المبادئ التي نادى بها عشرات من المفكرين والمثقفين منذ رفاعة الطهطاوي حتى طه حسين، وكانت أحد المبادئ الأساسية للحركة الوطنية المصرية مثلها مثل المطالبة بالجلاء والدستور سواء بسواء، حتى تم إقرارها كاملة في مؤسسات الدولة سنة 1961، وفي ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة فإنّ تقرير تلك المصروفات سيؤدي حتمًا إلى زيادة نسبة التسرّب من التعليم وخاصة لأبناء الأُسر الفقيرة.
من الوسائل العبثية الدعوة إلى التدريس بالتطوّع أو تكليف مجندي الجيش بالتدريس
وتشهد المدارس المصرية اليوم عجزًا في أعداد المعلمين يصل إلى نحو 400 ألف معلّم، إذ وتحت هيمنة الجهات المانحة والمقرضة على توجهات وسياسات الحكومة المصرية توقف تعيين الموظفين بالجهاز الحكومي – لم يتمّ تعيين معلمين منذ سنة 2014-، وهو ما أدى إلى هذا العجز الفادح في أعدادهم، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى مواجهة ذلك العجز بحيل ووسائل عبثية، فهي تعلن عن التعاقد مع بعض المدرسين لثلاثة أو ستة شهور، بمقابل هزيل لا يزيد عن ألف جنيه، وعندما تظهر في هذا التعاقد بعض المشكلات ويتم حلها تكون شهور ذلك التعاقد قد انتهت.
ومن تلك الوسائل العبثية الدعوة إلى التدريس بالتطوّع أو تكليف مجندي الجيش بالتدريس أو التدريس بالحصة التي لا تتعدى مكافأتها 20 جنيهًا فقط، وهى كلّها حلول تُعبّر عن مدى العجز والإفلاس في التعامل مع أزمة التعليم.
وتُعد مرتبات المعلمين من أحد أهم مظاهر العجز والإفلاس الذي يعاني منه التعليم المصري، فبالتأكيد هناك علاقة وطيدة بالمرتب الذي يحصل عليه الإنسان نظير قيامه بمهنة أو مهمة محددة وبين نظرة المجتمع لتلك المهنة واحترامه لها وحاجته إليها، ولن أتحدث عن معلمي العهد الملكي ولكني أشير إلى أنّ معلم سنة 1970 كان يتقاضى مرتبًا يبلغ 18 جنيهًا، وهو يساوي بحساب أيامنا هذه نحو 50 ألفًا من الجنيهات، إذا قارننا أسعار الذهب وقتها بأسعاره اليوم - كان جرام الذهب عيار 18 وقتها يبلغ 80 قرشًا، واليوم يبلغ الجرام نفسه 2500 جنيه-.
فقد التعليم كل القيم الوطنية التي كانت أحد أهم أهدافه منذ مأسسته قبل نحو قرنين
ولا شك أنّ هذا المرتب في ذلك التوقيت كان يكفل للمعلم وقتها حياة كريمة تسمح له بالتفرغ لمهنته الأصلية، وهو ما ينعكس تلقائيًا على كفاءته في أداء مهنته ومستوى طلابه، ويغنيه في الوقت نفسه عن اللهاث خلف الدروس الخصوصية أو عن البحث عن أي مهنة أخرى ليستكمل متطلبات حياته.
واليوم؛ يتقاضى المعلم في بداية حياته المهنية مبلغًا لا يزيد عن 2000 جنيه، أي أقل من 50 دولارًا، وهو أحد مشاهد المأساة التي غرق فيها التعليم اليوم، والتي لعبت دورًا هائلًا في افتقاد المدارس لجدواها ومعناها، ولم تعد الشهادات الدراسية تعني شيئًا حقيقيًا، إذ من الممكن أن يُنهي الطالب تعليمه في المدرسة المتوسطة بعد نحو 12 سنة دراسية دون أن يستطيع مجرد القراءة والكتابة، ومن ثم أصبحت الدروس الخصوصية ومراكز التقوية (السناتر) هي الوسيلة الفعلية للتعليم، وهو ما أفقد التعليم معنى "تكافؤ الفرص والعدالة"، كما أفقده كل القيم الوطنية التي كانت أحد أهم أهداف التعليم منذ مأسسته قبل نحو قرنين من الزمان.
لقراءة الجزء الأول
(خاص "عروبة 22")