الأسئلة أعلاه، هي بعض مما ترومُ الباحثةُ الفرنسيةُ من أصل مغارِبي، مريم بن رعد، الاشتغالَ عليه، في كتابِها حديثِ الإصدار تحت عنوان "الجغرافيا السياسيّة للغضبِ: من العوْلمةِ السَّعيدةِ إلى الغضبِ الكبير".
للتّذكير، المُؤَلِّفَة متخصّصةٌ في قضايا الوطنِ العربي، ومن ذلك الأوضاع في العراق، ولها عدّة إصداراتٍ في هذا السّياق، منها كتابٌ تحت عنوان "العراق، انتقام التاريخ"، (2015)، وكتابٌ آخر تحت عنوان "العراق، ما وراء الحروب"، (2023). كما اشْتُهِرَت بالاشتغالِ على الحالةِ الجهاديّة، وبخاصّة "الظّاهرة الداعشيَّة".
جاء الكتابُ الجديد موزّعًا على مقدمةٍ وثلاثة فصول: الغضب في/وضدّ العوْلمة؛ الفاعلون في الغضبِ العالمي؛ تحدّيات ديناميّة الغضب.
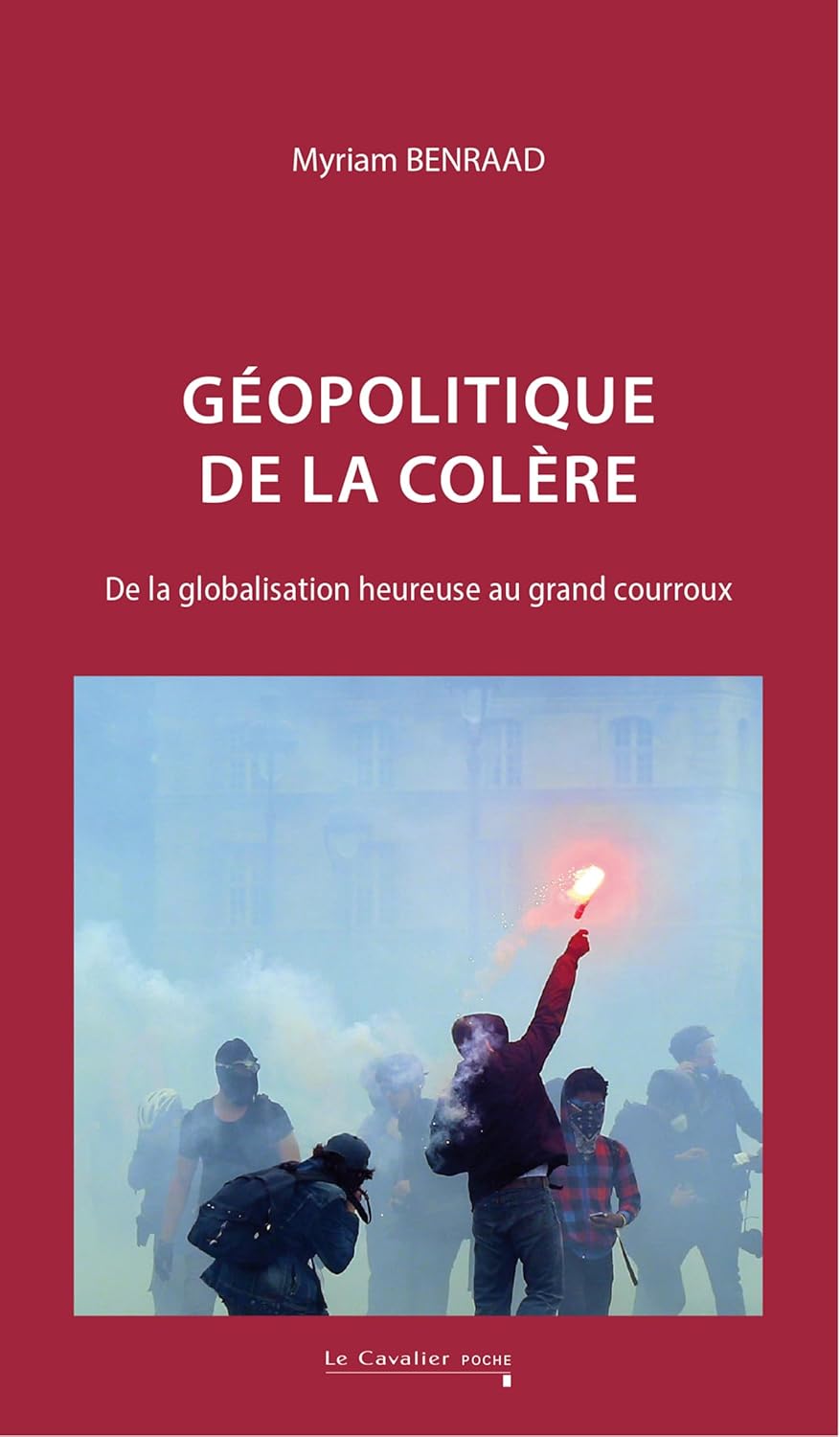
يتمحْورُ الكتابُ حولَ فلكِ جيوسياسةِ الغضبِ أو الجغرافيةِ السياسيّةِ للغضبِ في العالمِ بأسرِه، من العنفِ السياسي إلى الإرهابِ العابرِ للحدودِ الوطنيّة، وإنْ كانت لا تُفرّق هنا بين إرهابِ جماعات وإرهابِ دولة - وهذا موضوعٌ اشتغلَ عليه نعوم تشومسكي في كتابٍه "قراصنة وأباطرة" - كما اشتغلت المؤلِّفةُ على الانتفاضاتِ الشعبيّةِ والاحتجاجاتِ والتمرُّداتِ المسلّحةِ طويلةِ الأمَد، وصعودِ الشعبويّة، واستعادةِ الاستبدادِ والتوطيد، وكراهيّة الآخر.
من الأمورِ التي تثيرُ انتباهَ القارِئِ في كتابِها هذا، كثرةُ طرحِ الأسئلة، سواء في المقدّمةِ أو في مطلعِ فصولِ الكتاب، وهي أسئلةٌ بالعشراتِ، من دونِ أنْ تزعمَ بأنَّها تملكُ مُجْمَلَ الأجوبة، كأنّها تستفزُّ ذهنَ القارئ للمشاركةِ في البحثِ عن أجوبةٍ متشعّبةٍ بخصوصِ اندلاعِ الاحتجاجات، في القارَّات الأربع: أوروبا، أفريقيا، أميركا، آسيا.
ترى الكاتبةُ أنَّ الغضبَ يلتهمُ عوْلمةً وَصَفَهَا البعضُ ذات مرَّة بأنّها "عوْلمة سعيدة"، لولا أنَّ الأمثلةَ التي توردُها مريم بن رعد، تفيدُ بأنّ العوْلمةَ جعلَت من تلك المشاعرِ المؤسَّسَةِ على الغضبِ، تتجوَّلُ على نطاقٍ عالمي، بأبطال ورموز وديناميكيات ومخاطر، لم تَعُدْ موقتةً أو عابرةً، كأنَّها تؤشِّرُ إلى تغذيةِ مخاوف من القرنِ الحادي والعشرين، والذي قد يكونُ أكثر وحشيةً من القرونِ الماضيّة، أو على الأقلّ أقلَّ استقرارًا.
تُؤَكِّدُ المؤلِّفة أنّه يمكنُ أن يكونَ الغضبُ قُوّةً محفِّزَةً للتنظيمِ والمقاومةِ، كما يمكن للخوفِ من الغضبِ الجماعي في كلٍّ من المجتمعاتِ الدّيموقراطيّة والاستبداديّة أن يُحَفِّزَ مَن هُم في السُّلطةِ على تغييرِ طرقِهم في التّفاعلِ مع هذه القلاقِل - بصرفِ النَّظر عن معالمِ هذا التّفاعل - حتى إنَّ العديدَ من التّغييراتِ المُجتمعيَّة أصبحت ممكنةً اليوم بفضلِ غضبِ الفئاتِ الأكثر ضعفًا، وما أكثرَ الوقائِع في هذا السّياق، من التعبئةِ الأولى للعمّالِ إلى ثوراتِ الفئاتِ الأكثر حرمانًا، بما في ذلك حركات الإضرابِ الطلابيّة، التي انتهى معظمُها إلى إجبارِ حكوماتِهم على التّصرّف تحت وطأةِ الإقالة. وبالتّالي فإنَّ استبعادَ مؤشِّراتِ الغضبِ في النّقاشِ حولَ الحربِ وكذلكَ بشأنِ تغيّرِ المُناخِ هو وهمٌ بقدرِ ما يؤدّي إلى نتائجَ عكسيةٍ، لأنَّ هذه المشاعرَ بالذّات هي التي أثارَت وعيًا عالميًّا في السّنواتِ الأخيرة (ص 79).
العديد من الحالات المتطرِّفة اتّضح أنّ لديها غضَبًا حدَسيًا يتميّز بإحساس صريح ضدّ الاعتداءات التي يرتكبُها الآخر
بِحُكْمِ التّراكمِ البحثي الذي ميَّزَ أعمالَ المؤلّفة حول الظّاهرةِ "الجهاديّة"، فإنَّ هذا الموضوعَ كان حاضرًا في عدّةِ أمثلةٍ ضِمْنَ مضامين الكتاب، بما تطلَّب العودةَ إلى الأسبابِ المُتشعِّبةِ التي تقفُ وراءَ الظّاهرةِ نفسِها، ومن بينِ القواسمِ المشتركةِ هنا، حضور الغضب، معتبرةً أنَّ العديدَ من الملفاتِ الشخصيّةِ لحالاتٍ متطرِّفةٍ، اتّضحَ أنّ لديها غضَبًا حدَسيًا، يتميّزُ بإحساسٍ صريحٍ ضدّ الاعتداءاتِ التي يرتكبُها الآخر، من قَبيل الحروبِ الغربيّة في العالمِ الإسلامي، تأثير الصّراع العربي - الإسرائيلي (صدَرَ الكتاب بعد سنةٍ من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول)، أو تأثير الإهاناتِ المختلفة، من قبيل الرّسوم الكاريكاتوريّة المُسيئةِ للمقامِ النّبوي، وهي أمثلةٌ تغذّي بشكلٍ أو بآخر، الحُجَجَ التي تتأسَّسُ عليها أدبيّات الغضبِ الجهادي وما يصدرُ عن أتباعِ الظّاهرة.
على سبيلِ المثالِ، الهجماتُ التي وقعَت في فرنسا منذ مقتلِ محمد مراح في عام 2012، كانت أسبابُها رمزيّة: في عام 2015، ادَّعى الأَخَوَان كواشي أنّهما انتقما للمقامِ النّبوي بعد تنفيذِ اعتداءاتِ "شارلي إبدو"، بينما أعلن أحمدي (أو أميدي) كوليبالي في الوقت عينه أنّه تصرّف دفاعًا عن فلسطين (ص 100). والمفارقةُ هنا كما تضيف المُؤَلِّفَةُ في مقامٍ آخر، أنَّه بينما كانت نسبة من الشبابِ الفرنسي في حقبةِ سبعينيّات القرن الماضي، اتّجهت نحو التطرّفِ اليساري، نعاينُ نسبةً أخرى من الشباب نفسِه اتّجهت إلى التطرّفِ الإسلامي الحرَكي اليوم (ص 143).
كانت المؤلِّفة استشرافيةً في قراءةِ صعودِ أسهُمِ الرّئيس دونالد ترامب، على الرَّغم من أنَّ الكتابَ صَدَرَ قُبَيْلَ الانتخاباتِ الرئاسيّةِ الأميركيّة، معتبرةً أنّ خطابَ ترامب تأسَّس على نبرةِ غضبٍ ضدّ صُنَّاعِ القرار في حقبة جو بايدن، وأنَّ هذه الأرضيّةَ تفاعلَ معها الرّأي العام الأميركي بشكلٍ إيجابي (تورد المؤلِّفة إحصاءات أميركيّة في هذا الصدَد)، والأمر عينه مع استثمارِ ترامب لمشاعر غضبِ نسبةٍ من الأميركيّين من تعامُل البيت الأبيض مع الخارج (ص 123).
لا يمكن تحليل الغضب باعتبارِه قوّةً تعمل ضدّ العوْلمة وحدها وإنّما يمكن أن يكون قوّةً بنّاءةً في العوْلمة
يُفسّرُ الغضب ويُفَكّكُ الاستياء والعداوات التي ظلّت كامنةً لفترةٍ طويلةٍ، وهو ما يُعتبرُ من وجهةِ نظرِ المؤلِّفة، أحدَ الأعراضِ المرَضية للأنظمةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسياسيّةِ المريضة، بما في ذلك أحد أعراض عوْلمةٍ قد تكونُ وصَلَت إلى حدودِها القُصوى، بخاصّة في عالمِ ما بعد الجائِحة، حيث لم يَعُدْ قادرًا على إعادةِ اختراعِ نفسِه، بعد أن أصبَحت تلكَ العوْلمةُ، ثقافًة مهيْمنة وموحّدة، لا يمكنُ أن تؤدّي إلّا إلى طريقٍ مسدود، من دونِ ضمانِ الخلاص عندما يكون تفريغها غير منضبطٍ ولا يمكن السّيطرة عليه (ص 162).
ترى مريم بن رعد أنَّ الغضبَ لا يمكن تحليلُه من خلالِ المنظورِ الوحيدِ لروابطِه السلبيّةِ مع العالمِ وحسب، أو باعتبارِه قوّةً تعملُ ضدّ العوْلمةِ وحدها، وإنّما يمكنُ أن يكونَ قوّةً بنّاءةً في العوْلمة، ومن هنا أهمّيةُ تحديدِ مَن هُم الأبطال، مَن الدول، الأطراف الفاعلة الرئيسيّة على المسرحِ العالمي، إلى الديبلوماسيّة والمجتمعِ المدني، قَصْدَ إعادةِ بناءِ الديناميكيّات، حتى نعرفَ كيفَ يمكنُ للغضبِ العالمي أن يكونَ قوّةً ضارَّةً للغايةِ وطاقةً إيجابيّةً في آن.
(خاص "عروبة 22")






