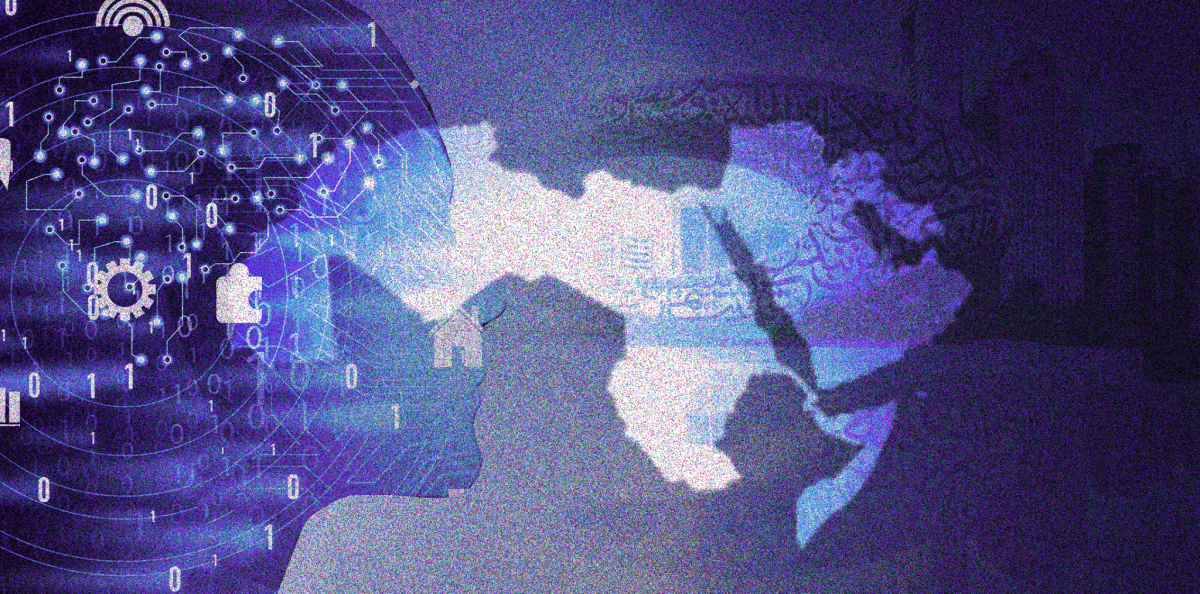إذا كان بعضهم يعتقد أنّ إعادة طرح سؤال المستقبل في هذا الظرف الذي يمرّ به العالم العربي يعدّ شكلًا من أشكال الترف الفكري أو الفضول الأكاديمي، فإنّ مختلف المستجدّات المتسارعة تثبت على النقيض من ذلك أهميّة التخطيط المستقبلي، لأنّ ما نعيشه حاليًا من أحداث وتطوّرات كان من الممكن رسم سيناريوات مواجهتها في ضوء الممكن البشري.
المستقبل في جوهره ليس غيبًا مطلقًا، وإنّما هو ما نصنعه بأنفسنا، وما نكسبه بأيدينا. ومن ثمة فلا يمكن كسب رهان المستقبل دون إسهام فاعل في الحاضر الذي يصبح بمرور الوقت جزءًا من الماضي والتاريخ. لذا فالعلاقة بين المستقبل والتاريخ علاقة جدلية خاضعة للتأثّر والتأثير والتغيّر والتطوّر المستمرّين.
يتعيّن أن تخضع عملية "طوفان الأقصى" للتدبّر لتكون منطلقًا للتأسيس المستقبلي بالنسبة إلى العالم العربي بأسره
يمكن أن نأخذ على سبيل المثال عملية "طوفان الأقصى" التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية بغزّة بداية من 7 أكتوبر 2023 ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني. فهي في حقيقتها ليست عملية مفاجئة أو مباغتة كما تصرّ بعض الأدبيات على وصفها، وإنّما هي من منظور التحوّلات الكبرى والمنعرجات التاريخية الحاسمة ليست إلّا مؤشّرًا من مؤشّرات استمرار المقاومة ضد الاحتلال والظلم والقهر والإذلال التي لم تخلُ منها مرحلة من المسيرة الإنسانية قاطبة في التاريخ. ولئن تتطلّب هذه النوعية من المعارك الكبرى ــ معارك الكرامة واسترداد الحقوق ــ نفسًا طويلاً قد يستهلك أعمار عدّة أجيال كاملة للنصر النهائي وكسبها، فإنّها من منظور علم التاريخ وعلم الاستشراف رهان قابل للتحقّق مهما طال الزمن وتغيّرت الآليات والوسائل شرط توفّر العوامل الموضوعية لحسمها.
بيد أنّه يتعيّن عدم ترك عملية "طوفان الأقصى" تمرّ دون أن تخضع للتدبّر والدرس لتكون منطلقًا للتأسيس المستقبلي، ليس فقط مستقبل المقاومة الفلسطينية وتحرير فلسطين، وإنّما كذلك بالنسبة إلى العالم العربي بأسره. وهذا لا يمكن أن يتمّ دون قطع مع التصوّرات التهليلية أو التبخيسية.
وبقدر ما كشفت عملية المقاومة الأخيرة تطوّرًا في آلياتها وقدراتها التكنولوجية والاتّصالية واللوجستية، فإنّها أثبتت مرّة أخرى عمق الوهن العربي وتوسّعه لدرجة العجز عن إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وماء ووقود إلى المدنيين العزّل المحاصرين. كما تعرّى تمامًا واقع التشرذم والتشظّي والانقسام حتّى بالداخل الفلسطيني بين قوى وتشكيلات فلسطينية، تربط بين أفرادها روابط العرق والدين والجنسية ومختلف الروابط العائلية والعشائرية.
تقتضي الوضعية المذكورة آنفًا، سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي، القطع نهائيًا مع الانطباعية والانفعالية في التعامل مع الواقع بمختلف مستجدّاته المتسارعة. وهذا لا يمكن حدوثه دون تكريس للعقلانية في معالجة الإشكاليات والقضايا الراهنة لا سيما أنّ العالم العربي يعجّ بعديد الخبرات والكفاءات القادرة على تشخيص الواقع وصياغة البدائل الممكنة لتغييره تغييرًا إيجابيًا. إذ لم تكن المشكلة أبدًا متّصلة بضعف القدرات أو غياب الإرادة، وإنّما في ترجمة تلك الإرادة وتحويل القدرات إلى فعل حضاري مؤثّر في واقع المجتمع العربي ومستقبله.
ولا شكّ أنّ تلك العقلانية المطلوبة لا تعني ضرورة انتهاج عقلانية أداتية وفق الأنموذج الأوروبي والغربي، وإنّما من الممكن الاستفادة من سلسلة المراجعات التي باشرها بعض أعلام الفكر الغربي في مقاومتهم للتنميط والتشيئة و"السيولة" بحثًا عن عقلانية موسّعة قادرة على استيعاب التنوّع والتعدّدية دون مفارقات أو إكراهات تُذكر.
حالة الأمّة العربية في هذا المنعطف التاريخي الحاسم ليست إلّا نتاجًا لوضع تاريخي يسوده التخلّف الشامل أو المركّب
لا يمكن تحقيق العقلانية المنشودة دون تكريس للوعي التاريخي سواء على مستوى الوعي الفردي أو الوعي الجمعي. وعندما نتحدّث عن الوعي التاريخي فهذا يعني اجتناب "الخطابات القصووية" التي لا تنظر إلى المسائل إلّا وفق تناظر ثنائي بين الأبيض والأسود أو "الطهورية المطلقة" و"المدنّس الأبدي".
يتيح ذلك القطع انتهاج رؤية موضوعية في تقييم الأوضاع وصياغة سياسات تطويرها إيجابيًا بناءً على المتاح الممكن النسبي. وهو ما يساعد في مرحلة آتية على حسم الخيارات والتوجّهات على مختلف الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية والحضارية بدل الاتّجاه السائد القائم على الترضيات والمخاتلات والمماثلات المستحيلة التي فضح الواقع التاريخي زيفها وعواقبها الكارثية.
بهذا المعنى، فإنّ علاقتنا بالحاضر ــ الراهن الذي كان في وقت ما يشكّل مستقبلًا لنا ــ مبنية على "الكسب" أو "الفعل الحضاري" المنجز، ومن ثمة فإنّ الحالة التي تبدو عليها الأمّة العربية في هذا المنعطف التاريخي الحاسم ليست إلّا نتاجًا لوضع تاريخي يسوده التخلّف الشامل أو المركّب الذي تعيشه المجتمعات العربية رغم ما أبداه بعض الأفراد العرب من تميّز في الدول الغربية التي هاجروا إليها، ونالوا فيها صفة المواطنة، وحازوا فيها مواقع مرموقة علميًا واجتماعيًا لدرجة الفوز بجوائز "نوبل" أمثال المصري أحمد زويل والتونسي منجي باوندي وغيرهما من الأسماء البارزة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية.
لا يمكن بناء مستقبل عربي واعد دون إعادة النظر جذريًا في مختلف السياسات التربوية والثقافية المعتمدة
لا جدال في أنّ اتّساع الهوّة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، أو بعبارة أدقّ بين الواجب والحاصل، يفرض إعادة النظر في حقيقة الخيارات التي انتهجتها البلدان العربية منذ بداية تصادمها مع الآخر الغربي منتصف القرن التاسع عشر، ولا سيما منذ منتصف القرن العشرين حين حصلت جلّ الدول العربية على استقلالها السياسي، وتخلّصت من الاستعمار المباشر. فمن الواضح أنّ تلك الخيارات لم ترتقِ إلى مستوى المشاريع الوطنية الجامعة التي تسعى فعلًا إلى بناء الإنسان المواطن بقدر ما كانت غالبًا مشاريع للاستمرار في السلطة والحكم أطول فترة ممكنة ولو كان ذلك على حساب الحاضر والمستقبل معًا، ممّا يُفسّر تحوّل بعض الأنظمة الجمهورية إلى أنظمة "جملوكية" على حدّ تعبير سعد الدين إبراهيم. والمقصود بذلك محاولة توريث الحكم للأبناء والمقرّبين حتّى في الأنظمة ذات الطابع الجمهوري التي لا تقوم على نظام التوريث وولاية العهد مثلما هو سائد في الأنظمة الملكية.
لا يمكن بناء مستقبل عربي واعد دون إنجاز عملية تقييم نقدي معمّقة للتجارب العربية المعاصرة والراهنة لاستخلاص الدروس منها وتجنّب اجترار أخطائها، ليتسنّى في ضوء ذلك اعتماد مشاريع وطنية حقيقية رهانها الأساسي بناء الإنسان المتصالح مع ذاته ومع غيره وليتيسّر له الولوج إلى عالم الحضارة الحديثة والمعاصرة دون عقد. ولا جدال في أنّ ذلك يعني ضمنيًا إعادة النظر جذريًا في مختلف السياسات التربوية والثقافية المعتمدة وعدم التردّد في انتهاج كلّ ما يساعد على تأسيس مجتمع الاقتدار القائم على مبادئ الكفاءة والشفافية والنزاهة.
(خاص "عروبة 22")