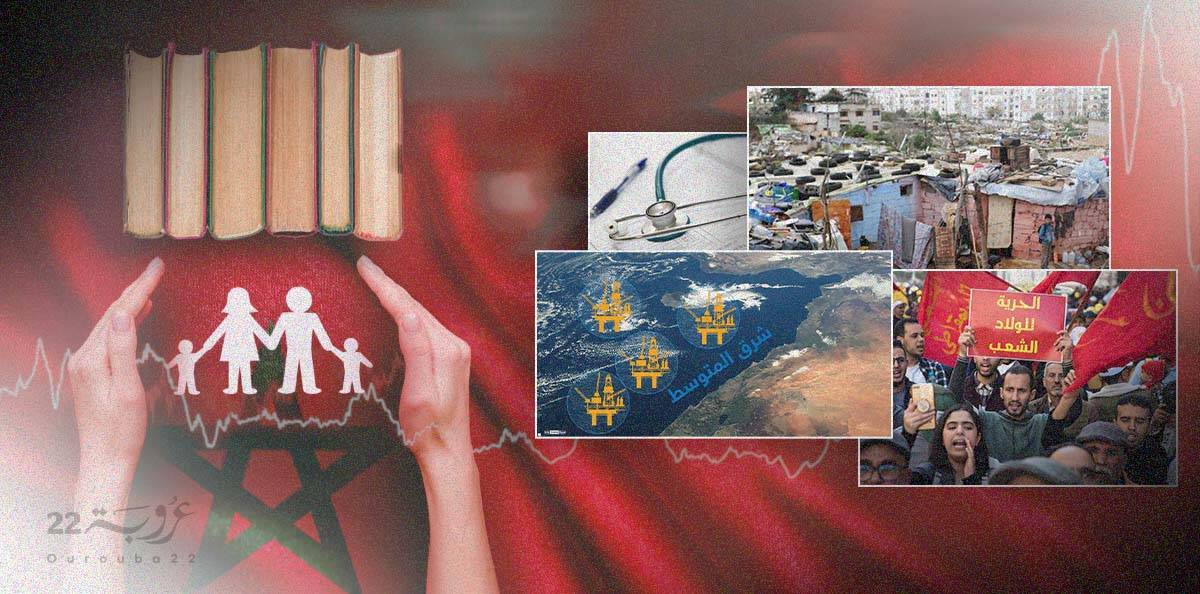الدروس المستقاة من الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العقد المنصرم، وكذلك من تعاقب الأزمات الاقتصادية التي فاقمت نسب الفقر والهشاشة بين الشعوب العربية، دفعت باتجاه البحث عن تبني مفهوم جديد للدولة يدرج البعد الاجتماعي ضمن أولوياته، بل يجعل شكل الدولة وأدوارها تدور في فلك البعد الاجتماعي الرامي إلى تمكين الشعوب من عيش كريم وعدالة اجتماعية وتوزيع منصف للثروات.
إنّه السبيل الذي حاولت بعض الدول العربية تلمسه عبر إدراج هذا البعد في الوثيقة الدستورية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تضمين الدستور المغربي لسنة 2011 أحكامًا ومقتضيات ذات صلة مباشرة بـ"الدولة الاجتماعية"، كتنصيصه في الفصل الأول على أنّ نظام الحكم في المغرب "نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وحديثه في الفصل الحادي والثلاثين على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "العلاج والرعاية الصحة، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والسكن اللائق، والشغل والدعم، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة".
الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام
هذه القاعدة الدستورية أكدتها توجهات الدولة بعد الجائحة وكذلك بعد الصدمة التضخمية الأخيرة وزلزال الحوز، وهي التوجهات التي همَّت إقرار عددٍ من الإصلاحات الجوهرية لقطاعات الصحة والشغل والتعليم والسكن، وِفق مفهوم شمولي جديد يتجاوز منطق التوزيع والتعويض والدعم نحو منطق الاستحقاق والمواكبة، وهي إصلاحات تم تنزيلها عبر عدد من الأوراش الكبرى حظيت بدعم مباشر ومواكبة حثيثة من الملك محمد السادس، في مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
هذه التوجهات عكست وعيًا من لدن السلطات المغربية بأنّ الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه، هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام، خاصّة أنّ مطالب الحركات الاحتجاجية خلال فترة الربيع العربي كانت في معظمها اجتماعية، إلى جانب عدد من المطالب السياسية التي لم تمس بجوهر النظام السياسي المغربي، وذلك خلافًا لعدد من الدول العربية التي طالب فيه المحتجون بتغيير الأنظمة وإحداث قطيعة مع التجارب السياسية والاقتصادية السابقة.
إلى حدود الساعة، يُسجل ارتياح حذر بخصوص سعي الحكومة المغربية لإقرار إصلاحات كبرى، والعبور نحو أنموذج الدولة الاجتماعية أي دولة الرفاه حسب المنطق الأنجلوسكسوني؛ هذا الارتياح الحذر يُعكر صفوه عدد من الأسئلة التي باتت تطرح حول الحصيلة الأولية لهذا العبور، بعد أن استنفدت الحكومة نصف ولايتها الأولى.
إنّ المُتتبّع للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية يُسجل بقلق بالغ ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وبطء وتيرة تنزيل الإصلاحات التي تمضي بسرعات متفاوتة قد تجعل من التقائيتها أمرًا صعبًا، إلى جانب الشكوك التي أضحت تحوم حول مسألة ضمان استدامة الموارد المالية في ظل استمرار العجز الموازانتي وتعثر الإصلاح الضريبي وتفاقم الدين الخارجي، الأمر الذي بات يلقي بظلال من الريبة والشك على مستقبل هذه الإصلاحات وعلى إمكانية تحقيق أهدافها وبالتالي تحقيق هذا العبور الموعود نحو دولة الرفاه.
عملية بناء الدولة الاجتماعية تظل مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين
لن يكتمل هذا العبور حسب اعتقادنا إلّا عبر إقرار إصلاحات موازية على المستويين الاقتصادي والسياسي، تقتضي البحث عن موارد جديدة وتفعيل مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخلي عن مظاهر الاقتصاد الريعي والاحتكاري، وتشجيع المنافسة وضمان ممارستها بشكل حر وشفاف، وهو الأمر الذي قد ينعكس على جاذبية الاقتصاد المغربي للتمويلات الخاصة الوطنية والخارجية، ويسهم في خلق مناصب شغل أكثر وتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الموارد المالية.
نزعم أنّه من شأن هذه الإصلاحات أن تجعل القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في عملية بناء الدولة الاجتماعية التي تظل مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين.
وإلى جانب البعد الاقتصادي، يجب إدراج مسألة إصلاح الحقل السياسي ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، فالركود الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي يُشكل عقبة حقيقية في وجه تحقيق أهداف وغايات الدولة الاجتماعية، فالتمثيلية السياسية الحقيقية والمشاركة الفعالة في عملية صياغة السياسيات العمومية ومراقبة تنزيلها وتقييمها وتفعيل آليات المحاسبة، هي الضمان الوحيد لإنجاح العبور نحو دولة الرفاه، وهي أمور لا تتوفر في المشهد السياسي المغربي الراهن للأسف، ولا في النخب السياسية التي أسندت إليها مهام التمثيل والنيابة، وهو ما تسبب في تراجع منسوب الثقة بين المواطن ومختلف المؤسّسات الحكومية، دفعته للبحث عن بدائل من أجل الترافع عن مطالبه السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
(خاص "عروبة 22")