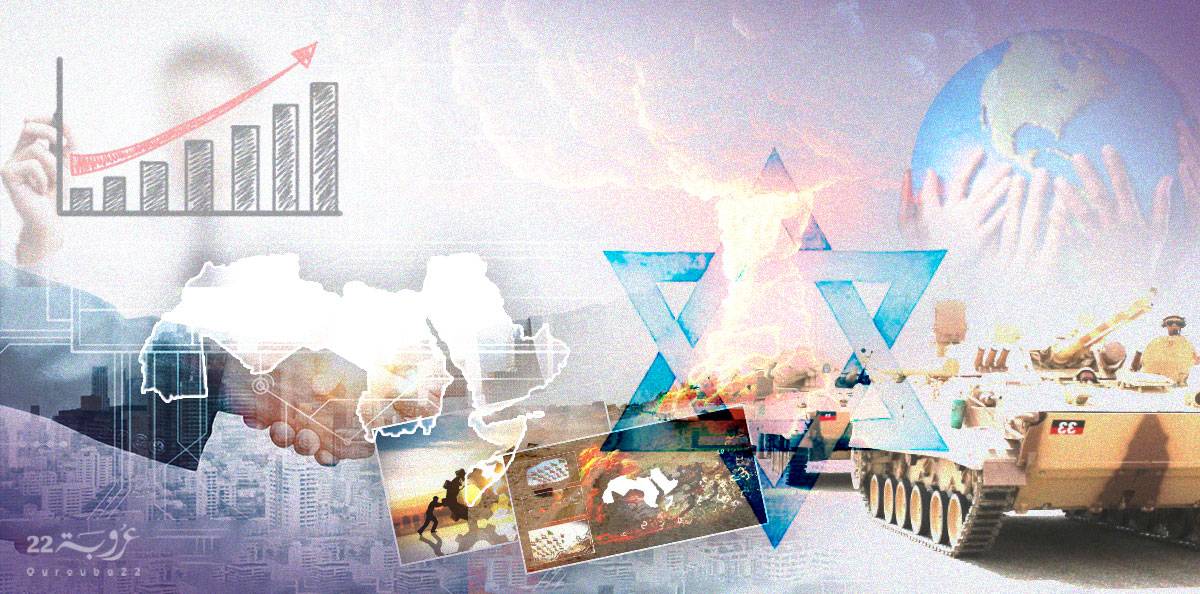تواجه منظومة الدّول العربيّة "أزمةً بنيويّةً ممتدّة"، هي حصيلةٌ لتراكُم عددٍ من المشكلات على مستويات ثلاثة:
الأوّل: أزمة الدّولة العربيّة من حيث استجابتها لمتطلّبات الدّولة الوطنيّة الحديثة، واعتمادها مبدأ المواطَنة، واستقرار مؤسساتها وسياساتها، وبخاصة مع تدنّي معدّلات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في عددٍ كبير منها، واستمرار "فجوة الغذاء".
الثّاني: العلاقات بين الدّول العربيّة في تفاعلاتها الثّنائيّة، أو في إطار الجامعة العربيّة. إذ يتّسم عديد من العلاقات الثّنائيّة بعدم الثّقة والتّنافس، وتصل أحيانًا إلى حدّ العداء المكشوف والتّدخّل العسكري، وأصبحت الجامعة العربيّة أسيرة هذه العلاقات، فانخفض سقف العمل العربي المشترك.
الثّالث: العلاقة مع الخارج الإقليمي والعالمي، والّتي تتّسم بالانكشاف الأمني والعسكري، وبالتّأرجح في المواقف السّياسيّة ما بين التحالف مع القوّة الكبرى في العالم وهي الولايات المتحدة، وإقامة علاقات متوازِنة مع القوى الدّولية الأخرى. ويرجع ذلك إلى عدم التّناسب بين قدرات الدّفاع الذاتيّة لكل دولة عربيّة على حِدَة، أو لها مجتمعة من ناحية، وحِدّة الصّراع الدّولي في المنطقة، وتأثيرات سياسات العربدة الإسرائيليّة من ناحية أُخرى.
وعلى كل المستويات، يغلُب الانقسام والتّنافُس على مواقف الدّول العربيّة، ويندُر التّوافق أو التّضامن بينها، إلّا على نحو شكلي ورمزي. يحدث ذلك في سياق تراجع مفاهيم العدالة الاجتماعيّة، والبوْن الشاسع بين الأغنياء والفقراء دولًا وأفرادًا، وفي ظل مناخٍ فكري تسوده "القُطرية"، والفكر الهُوياتي المرتبط بالدّين والمذهب والطّائفة والقبيلة.
يمثّل البحث في أزمة الدّولة العربيّة المقاربة الرئيسيّة لفهم أزمة الوطن العربي
سعت الجامعات ومراكز البحوث العربيّة منذ عدّة عقود إلى سبْر أغوار أزمات الدّولة والمجتمع في بلادنا، واقتراح السّياسات والبدائل لتجاوزها. ففي عام 1974، نظّمت جامعة الكويت ندوةً بعنوان "أزمة التّطور الحضاري في الوطن العربي"، شارك فيها عدد كبير من المفكّرين العرب. وفي الثمانينيّات، أشرف مركز دراسات الوحدة العربيّة في بيروت على مشروع بحثي ضخم عن "استشراف مستقبل الأمّة العربيّة"، وأشرف منتدى العالم الثّالث بالقاهرة على مشروعٍ مماثلٍ تحت اسم "المستقبلات العربيّة البديلة"، غير أنّ ما توصّلت إليه تلك الأعمال لم يكُن له صدًى ملموس في سياسات الدّول العربيّة.
وسعت الشّعوب وقوى التّغيير العربيّة إلى الخروج من هذه الأزمة، ولجأت في ذلك إلى كل الوسائل والأشكال التي يعرفها العالم، كالعمل السّياسي الحزبي، والمُظاهرات والمسيرات السّلميّة، والانقلابات العسكريّة، وانقلابات القصر، والانتفاضات والثّورات الشّعبيّة، ولكنّها جميعًا لم تنجح في كسر الحلقة المُفرغة المحيطة ببلادنا. وبشكلٍ أكثر تحديدًا تكون هناك بدايات إيجابيّة، ولكنّها لا تستمر أو تكتمل، إذ يتم إجهاضها ونبدأ الكَرّة من جديد.
فلماذا يحدث ذلك؟
تتعدّد التّفسيرات والتّأويلات فهناك من يُركّز على نقص الحُرّيات وغياب الديموقراطيّة وحكم القانون وعدم احترام حقوق الإنسان وما يصاحب ذلك من إقصاء سياسي وتهميش اجتماعي، أو على غياب روح العلم والاحتكام إلى العقل، إذ تُشيرُ تجارُب المُتقدّمين إلى أنّ سلطان العقل هو محكّ التقدّم والحضارة وذلك خلافًا للكثير من الجدالات العربيّة التي تحتكم إلى النّصوص وأحداث الماضي بدلًا من الأدلّة العقليّة وتجارب الواقع المُعاش، أو على حالة الانقساميّة الثقافيّة والطّابع العُصبوي للتّكوينات الاجتماعيّة وأسبقيّة الولاءات الفرعيّة على المُشتركات الوطنيّة والقوميّة الجامعة، أو على غلبة الطّابع الرّيعي في هيكل الاقتصاد والقيم الاجتماعيّة، أو على غياب ثقافة التّسامح والاعتدال وغلبة أفكار الغلوّ والتطرّف، أو على فشل المؤسّسات التّعليمية والتّربوية في غرس ثقافة المواطَنة، والدّافعيّة للتقدّم، وقيم المُشاركة الاجتماعيّة. وهناك أيضًا من ركّز على العوامل الخارجيّة والتدخّلات الأجنبيّة لإبقاء حالة الانقسام والتخلّف العربي.
أصحاب السُّلطة في دولنا يخشون من أن يؤدّي ازدياد دور المؤسّسات إلى تقييد سُلطاتهم
يحمل كُلٌّ من هذه التّفسيرات قدرًا من الصحة، ولكن الرأي عندي أنّ العامل الرئيسي يكمُن في طبيعة الدّولة العربيّة، ونُظم الحُكم السّائدة فيها، ومدى تمثيلها لقاعدةٍ عريضة من المُجتمع وقواعده الشّعبيّة، وكذلك السّياسات التي تتبنّاها ومدى تعبيرها عن تطلّعات ومصالح تلك القاعدة العريضة. فالدّولة العربيّة هي القوّة المُتغلّبة التي تحظى بسُلطات واسعة لا يحدّ منها دستور أو يوازِنها مُجتمع مدني وتنظيمات اجتماعيّة مستقلّة. يمثّل البحث في أزمة الدّولة العربيّة إذن المقاربة الرئيسيّة لفهم أزمة الوطن العربي. وبعبارة أُخرى، فالدّولة هي مكمن الدّاء وسبيل العلاج.
السّمة الرئيسيّة لهذه الدّول هي حُكم الأفراد وليس حُكم المؤسّسات، مما أدّى إلى الانفراد بالقرار وشخصنة السُّلطة. ولذلك، شهدت بعض الدّول العربيّة تغيّرات عميقة بانتقال الحُكم فيها من زعيم لآخر. فالمؤسّسات التّشريعيّة والتّنفيذيّة والحزبيّة والنّقابيّة هي التي تضمنُ استمرار تطبيق السّياسات، وهي مجال تدريب وفرز عناصر الطبقة السّياسيّة. ولا يحدث هذا في دولنا لأنّ أصحاب السُّلطة فيها يخشون من أن يؤدّي ازدياد دور المؤسّسات - بما فيها تلك الموالية للنّظام - إلى تقييد سُلطاتهم.
ومع أنّ أغلب الدّول العربيّة تبدو قويّة وصاحبة منعة بدعمٍ من أجهزتها الأمنيّة وإعلامها التّعبوي، فإنها تعجزُ في الواقع عن تغيير سلوك مواطنيها أو إقناعهم بتبنّي سياساتها، فتلجأ عادةً إلى الإرغام والإكراه، أو تتّبع ممارسات الزّبانيّة السّياسيّة والاجتماعيّة لشراء تأييد أفراد شعبها. وتُعاني لكل ذلك من نقصٍ فادح في المُشاركة السّياسية مما يعكس أزمة الشّرعيّة فيها.
حُكم الأفراد يُسهِّل الاختراق الخارجي والنّفوذ الأجنبي
أدّت ممارسات المرشّح الرئاسي الفائز مقدّمًا وهيمنة حزب الدّولة، وغلبة النّظرة الأمنيّة، والانتخابات غير النّزيهة، وإضعاف المعارضة وأصحاب الآراء المُخالفة، وضعف المؤسّسات الوسيطة التي تُيسّر الاتّصال بين الحُكّام والمحكومين، إلى استفحال هذه الأزمة، فتقلّ نسب المشاركين والمهتمّين، وتزداد نسب الاغتراب السّياسي، والمتابعين عن بعد، والسلبيّين، والرّافضين، والمتطرّفين. وما نراه في الكثير من الدّول العربيّة لا يتعدّى المشاركة الشّكليّة الموسميّة التي تأتي نتيجة سياسات التّعبئة والحشد. وتزداد خطورة هذه الأزمة في ضوء ارتفاع نسبة الشّباب في التّركيب السكّانيّ العربيّ، والتحدّيات الحياتيّة الصّعبة التي يواجهونها، وشعورهم بالحرمان النّسبي، وذلك في سياق انخراطهم في فضاء وسائل الاتّصال الاجتماعي والميديا الجديدة.
تبدو أغلب هذه الدّول "ظالمةً ومظلومة"... ظالمةً في علاقاتِها بمواطنيها وعدم الوفاء بحقوقهم العامّة، ومظلومة في قبولها ما يُفرض عليها من الخارج. فالقوى الخارجيّة تُدرك الطّبيعة الفرديّة لها، فتُمارسُ الضّغوط على قادتها لعلمها أنّه لا يوجد برلمان يُراقب أو صحافة تنتقد أو مُجتمع مدني ورأي عام يُمارس تأثيرًا. وهكذا، فإنّ حُكم الأفراد يُسهِّل الاختراق الخارجي والنّفوذ الأجنبي.
هناك شعور عربي عامّ بالإحباط وعدم القدرة على التّغيير، بسبب حدود قدرات الدّول العربيّة في مواجهة ما تقوم به إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو لعدم قدرة المواطنين على التّأثير في سياسات حكوماتهم، أو بسبب عدم القدرة على وقف الحروب الأهليّة المستمرّة بعد أكثر من عقد والتي يستفيد منها أمراء الحرب والقوى الخارجيّة. ويؤدي استمرار هذه المشاعر، إلى تعميق انفصال الدّولة عن المُجتمع، وإلى تآكل شرعيّتها، وازدياد اعتمادها على التّأييد الأجنبي.
الدّولة القويّة لا بُد وأن تستند إلى مجتمع قوي
طريق الحلّ يبدأ بإصلاح أزمة مؤسّسات الحكم في الدّول العربيّة، بتوسيع قاعدتها الشّعبيّة، وتعبيرها عن المصلحة العامة التي تتجاوز الانحيازات الإثنيّة والطائفيّة، ورفع كفاءة مؤسّساتها، وزيادة قدرتها على تبنّي سياسات عامّة رشيدة تستجيب لاحتياجات أغلبيّة المواطنين.
بهذا، تستطيع الدولة العربيّة أن تتصالح مع مُجتمعها، فتزداد قوّتها على مواجهة التّحديات المرتبطة بالتحوّلات العالميّة الكبرى، لأنّ الدّولة القويّة لا بُد وأن تستند إلى مجتمع قوي.
(خاص "عروبة 22")