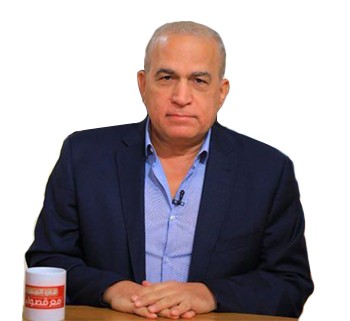بعد السقوط السريع لنظام بشار الأسد تنصبّ الأنظار على مستقبل سوريا والمسارات المتعددة التي أصبحت متاحة بفعل هذا الحدث الكبير. يتصدر المسار السياسي هذه المسارات باعتباره القاعدة التي ستنبني عليها المسارات الأخرى، كإستعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين وإعادة البناء وتشريع القوانين المناسبة وتهئية الظروف لجلب الاستثمارات وتدوير عجلة الاقتصاد بكل فروعه.
وإذ يقف السوريون الآن أمام مهمة عاجلة في هذا المسار تتمثل في تشكيل هيئة انتقالية تشترك فيها كل الأطياف السورية من أجل وضع الأسس اللازمة للعمل السياسي في المستقبل والحصول على اعتراف دولي وإقليمي بالنظام الجديد، فإن ظلال الشك تلقي بثقلها على إمكان مواصلة التحول السلمي والديموقراطي، وذلك لأسبابٍ عديدة أبرزها تصدُّر "هيئة تحرير الشام" للزحف العسكري الذي أدى إلى سقوط النظام، وتاريخ قائدها الذي تصدَّر المشهد السياسي والإعلامي، خصوصًا بعد دخوله إلى دمشق وخطابه في الجامع الأموي، ثمّ تكليفه الرئيس السابق لحكومة الانقاذ في إدلب، تشكيل حكومة انتقالية في دمشق.
لقد عرض الرجل خلال مقابلاته وتصريحاته طبيعة التحولات التي مرّ بها على الصعيد الشخصي، وهي تحولاتٌ طبيعية من الناحيتين النفسية والفكرية بالنسبة الى شاب انخرط مبكّرًا في العمل العسكري والسياسي في ظروف كان يرى فيها أن "أمته" تتعرض لغزوٍ استعماري جديد، لكن البعض يشكك في هذه التحولات ويعتبرها من فنون "سياسة التمكين" التي تتبناها التنظيمات الإسلامية لتحقيق أهدافها؛ وهو شكٌّ يبدو محقًّا، حيث لم تترك لنا الحركات الإسلامية، خصوصًا المتطرفة، إنطباعًا سواه.
لا شك في أن الحركات الأصولية الإسلامية لا تلتقي مع مفهموم الدولة الوطنية ولا تعترف بها، وإن جادلَ في هذه الحقيقة بعض الإسلاميين مِمَّن يرَوْن أنهم في مرحلة التمكين ويقع على عاتقهم واجبُ التستر بالديموقراطية التي هي أحدى ركائز الدولة المدنية الحديثة التي لا يؤمنون بها، بل يستهدفونها ويستهدفون معها الهُويّات الوطنية باعتبارها، حسب وجهة نظرهم، نوعًا من العصبيّة التي تتنافى مع مبادئ الإسلام، وتشكل بالتالي عائقًا أمام إقامة الإمامة أو الخلافة.
غير أن حديث الجولاني عن "الحالة الواقعية" التي "لا يستطيع فيها أحد أن يلغي الآخر"، وإقراره بالتنوع الديني والطائفي من خلال الإقرار بوجود "الطوائف التي عاشت منذ آلاف أو مئات السنين في هذه البلدان"، وإنه "لا يحق لأحد أن يلغيها"، والتشديد على أهمية وجود "قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم"؛ يجعل من المضي في البحث عن الخلفيات "السايكولوجية" للتحولات التي طرأت على مسيرته الشخصيّة، أمرًا لا فائدة منه، والأصوب أن ننتقل مع الجولاني إلى الواقعية في النظر إلى الأمور، خصوصًا أنه قال: "أقول للناس أن ينظروا إلى الأفعال، لا أن ينظروا إلى الأقوال".
في النظر إلى السنوات العشرين الماضية التي تفاقم فيها الصراع الطائفي بعد سقوط نظام صدّام حسين وظهور التنظيمات "الجهادية" التكفيرية وانتقال خبراتها والكثير من كوادرها وقياداتها من أفغانستان إلى المنطقة، وبلوغ مشروعها القمة في السيطرة على موارد كبيرة ومساحاتٍ واسعة من الأراضي السورية والعراقية، وإعلانها "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" التي عُرفت باسم "داعش"، وما لاقته من رفض واستنكار ومقاومة محلية وتعاون إقليمي ودولي على استئصالها؛ يتبين للناظر أن مشروع الدولة الدينية وإقامة الخلافة، على الأقل بشكلها التكفيري الذي يستخدم الجريمة والإرهاب لاستئصال الآخر المختلف، هو مشروعٌ لا يتسق مع الدورة الحضارية التي يمر بها العالم، التي من أبرز سماتها السعي إلى حقوق الإنسان؛ وعلى الأخص حرية العبادة.
من ناحية، لم تعد "الأقليات" المعنية بذلك كياناتٍ معزولة تعيش في الظلام، كما في القرون الغابرة، فالعالم، بتطوره التقني على صعيد التواصل، بإمكانه أن يسلط الضوء على أيّ سلوكياتٍ منافية لروح العصر ويتخذ الإجراءات المناسبة في حق مرتكبيها، وهي إجراءاتٌ تشمل الملاحقات الجنائية والعقوبات الاقتصادية، وقد تصل إلى حد التدخل العسكري؛ وذلك برغم المحاباة الدولية التي يعرفها الجميع في هذا المجال. ومن ناحيةٍ ثانية، فإن ما من "أقليّة" إلّا ولها اليوم امتداداتها في العالم الغربي، وتستطيع، بشكلٍ ما، التأثير في مشهده السياسي والإعلامي.
إذًا، يمكننا الافتراض أن تجربة دولة الخلافة التي أعلنها أبوبكر البغدادي صيف عام 2014 من على منبر جامع النوري في الموصل، والهزيمة التي لحقت بها قبل أن تتم عامها الرابع، ماثلةٌ أمام أنظار الفصائل الإسلامية المسلحة؛ وذلك إلى جانب ضمور واضمحلال تنظيم "القاعدة" الأم، كما يمكننا الافتراض أن تجربة "تصدير الثورة"، وما آلت إليه أوضاع إيران التي قادتها على مدى العقود الماضية، لم تغب عن طاولة بحث قادة الفصائل عن أفضل السبل الواقعية للانتقال إلى الحكم وإدارة سوريا بعد سقوط النظام، دون التعرّض لعقوبات اقتصادية، فضلًا عن اكتساب الشرعية الدولية والإقليمية لذلك؛ ويلعب إدراج الولايات المتحدة الأميركية "هيئة تحرير الشام"، والجولاني شخصيًّا، على "قوائم الإرهاب"، دورًا كبيرًا في التحول نحو هذه الواقعية.
إن حجم الدمار والمشاكل التي ورثتها سوريا ونزوح وتشرد نصف سكانها، ومستوى التأثيرات الاقليمية والدولية في بيئتها، تجعل من غير الممكن، أو المعقول، التفكير في دعوة هذه البيئة للاستمرار على نهج التطرّف وخلق الأزمات أو تعميقها في المنطقة، حيث سيعني ذلك امتناع المجتمع الدولي عن تقديم أي مساعدة لإعادة البناء، كما سيعني حربًا أهلية مستمرّة وترسيخًا لتقسيم، يؤديان إلى مزيد من النزوح الذي تعاني منه دول الجوار، خصوصًا تركيا، الداعم الأساسي للفصائل. ولا ينبغي هنا تجاهل تأثير "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي وتجربته في إدارة النظام العلماني التركي، على "فصائل إدلب" القريبة من تركيا.
وفي الانتقال إلى المسار الواقعي لما جرى منذ الانطلاق من إدلب في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى دخول دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، نرى أن الفصائل السورية المسلحة قد أظهرت أداءً مختلفًا عن البدايات عبّر عن نضجٍ وطني وعكس فهمًا صحيحًا لنسيج المجتمع السوري وتركيبته وجذوره الحضارية؛ وإنَّ من شأن ترسيخ هذا الأداء واستمراره على قاعدة مبدئية وليست مصلحية ترتبط بتكتيك المعركة، أن يخلق حولها التفافًا شعبيًّا داخليًّا ودعمًا عربيًّا على المستويين الرسمي والشعبي يعيد الى سوريا دورها الذي يتلهف له الأحرار من شعوبنا في أن يكون خارج القيد الطائفي الذي أغرقتنا حروبه بالدماء ولم يخلّف لنا سوى الحطام والتشرد والخراب.
على الرغم من ذلك كله، فإن السؤال عمّا إذا كان الجولاني و"هيئة تحرير الشام"، قد أسقطا هدف إقامة الخلافة أو "تطبيق الشريعة" على المجتمع السوري، من حساباتهما لصالح الدولة الوطنية بالفعل؛ يبقى سؤالًا مفتوحًا على المستقبل، وتشكل الإجابة عنه هاجسًا عند الآخرين.
في 04.11.2014، وفي ذروة صعود "داعش" كتبت في "النهار الثقافي":
"منذ إقامتها بعد وفاة النبي حتى الآن لم تواجه فكرة "الخلافة الإسلامية" وإطارها السياسي "الدولة الإسلامية"، واستطرادا "تطبيق الشريعة"، رفضاً تحوّل إلى معارضة عنيفة وصلت حد المقاومة المسلحة، مثلما تواجهه الآن لصالح التعددية والدولة الوطنية المدنية، وهو رفض له جذوره في أفكار النهضة وفي التطورات التي حصلت في "بلد الخلافة" بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
فباستثناء جزءٍ من حركة الإرتداد التي حصلت في عهد الخليفة الأول لم يشهد التاريخ الإسلامي قط حركات معارضة خارج مظلة الإيمان بالإسلام والخلافة-الإمامة كمبدأ، وذلك على رغم خروج تلك الحركات على شخص الخليفة وآليات اختياره، وكذلك على رغم "الشواذ" الذي ذكره ابن خلدون والمتمثل بقول حاتم الأصم (معتزلي) وبعض الخوارج (النَّجَدات) بعدم وجوب نصب الإمام "إذا تواطأت الأمة على العدل"، حيث لم يمنع هذا الشواذ صاحب المقدمة من التأكيد أن الخلافة مما انعقد عليه الإجماع. وفي هذا الإطار لم تكن التيارات الفكرية المعارضة التي اتُّهمت بالكفر والمروق والزندقة إلا جزءاً من تجليات متنوعة للعقيدة الإسلامية قد ألقى عليها خصومها تهمة الخروج عن الدين وعن ولي الأمر ليسهل أمر القضاء عليها.
تجليات الماضي تلك توضح أن الاختلاف والتنوع هما سمة الحياة، بينما يكشف الرفض المعاصر أن التعددية بكل أشكالها السياسية والدينية والثقافية ستكون سمة الحاضر والمستقبل".
في الختام، يمكن القول إن أي حكم الآن على مستقبل التغيير في سوريا يبدو متعجلًا وسابقًا لأوانه، فالمجتمع المقموع على مدى عقود والممزق على مدى أكثر من عشر سنوات والمغيبة كوادره السياسية والثقافية في السجون و"المسالخ" والمنافي، يحتاج إلى بعض الوقت ليتنفس هواء الحرية وينظّم صفوفه ليكشف لنا عن تياراته السياسية بشكلٍ أوضح من خلال تنظيم أطرهِ الحزبية التي نأمل أن تكون كلها على أسس وطنية وليست طائفية أو عرقية.
(النهار اللبنانية)