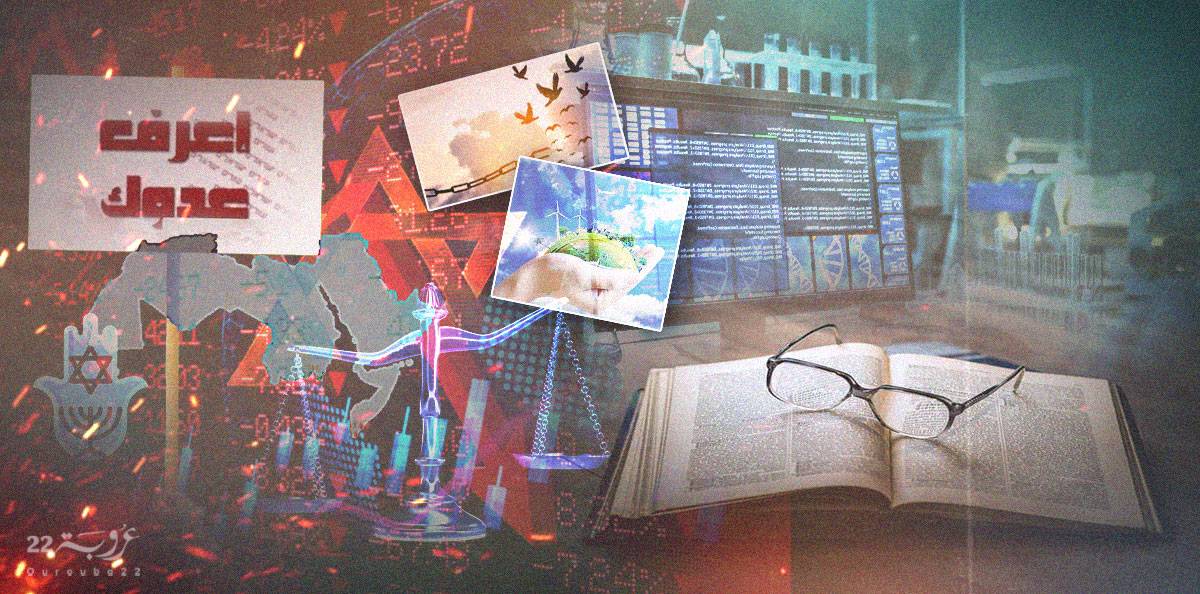من بين القضايا التي تَرَكّزَ الاهتمامُ بها، محاولةُ معرفةِ العدوّ وتحديدُ مظاهرِ القوّة لديه والعوامل التي تسندُه، وأصبح شعار "إعرف عدوَّك" من القضايا الأكثر تداوُلًا بين تلك الفئات، بعد أن كان الاقترابُ من ذلك يُعتبرُ من المُحرَّمَات التي قد يُتّهم "المولعُ" بها بالخيانةِ الوطنيةِ والقومية.
إسرائيل تفطّنت لخطورة مراكز البحث والدراسات في العالم العربي فحاولت اغتيال العاملين فيها
تغيَّر الحال وأنشَأَت بعضُ الجهاتِ العربيّة والفلسطينيّة تحديدًا منذ أواخِر السبعينيّات بعْضَ مراكزِ البحثِ والدراساتِ في العالمِ العربي وفي خارجه تخصَّصَت واهتمَّت برصدِ وتحليلِ مختلفِ مظاهرِ تطوُّرِ أوضاعِ الدولة الصّهيونية، ممّا أتاح للكثير من السياسيّين والباحثين والمهتمّين بالشّأن الإسرائيلي من العرب خاصّة، الاطّلاع على كمٍّ هائلٍ من المعطيَات والمَعارِف حوْل العدوّ.
يَظْهَرُ أنّ إسرائيل قد تفطّنت في وقتٍ مبكر لخطورةِ تِلك المراكز وما تنتجُه من معرفةٍ حولها، فحاولت اغتيالَ بعض المثقَّفين والأكاديميّين العامِلين فيها، بل سارعت عند احتلالِ قوّاتها للعاصمةِ اللّبنانية بيروت إلى الاستيلاءِ على محتوياتِ مركز الأبحاثِ الفلسطيني الذي تأسَّس منذ بداية السبعينيّات من القرن الماضي. ولم يمنع كلّ ذلك من مواصلةِ العربِ اهتمامَهم بعدوِّهم، حتّى أنّ الأمرَ ازدادَ وتوسّعَ وتشعّبَ وتفرّعَ، بخاصّة مع ثورةِ الاتّصال وفورةِ التّواصل التي اتّسعت على نطاقٍ واسع.
لكن وعلى الرَّغمِ ممّا وفَّرتهُ وتُوفِّره مراكزُ البحثِ وغيرها من المؤسّسات ذات الاهتمام المشترك أو المشابِه من معلوماتٍ ومعطياتٍ وتحليلاتٍ علميةٍ متوازنةٍ في الغالِب، فإنّ الكثير من الكتاباتِ والتعليقاتِ والتحليلاتِ الصّحافيةِ والسياسيةِ العربيةِ لا تركّز في الغالِب إلّا على الجوانبِ السلبيَّة للمجتمع والدّولة الصّهيونية العدوَّة، كما تقومُ بتَضخيمِ الأزماتِ وإبرازِ العوْراتِ التي يعاني منها المجتمعُ والنّظامُ السياسي الإسرائيلي كالفسادِ السياسي والأخلاقي والمالي وتراجُعِ نَسَقِ الهجرةِ اليهوديةِ إلى "إسرائيل"، وانتشارِ ثقافةِ اللّامبالاة وتفاقمِ حالات الهروب من الجيش وتراجعِ مستوى الإرادة في القتال والرّغبة في ذلك، بل إنّ البعضَ لا يتردَّدُ في إبرازِ ما أصابَ المجتمعَ الإسرائيلي من أمراضٍ اجتماعيةٍ مختلفةٍ كانتشارِ ثقافةِ الجنْس الرّخيص والمُتعة واللّواط وتعاطي المخدّرات والجريمة المنظَّمة والتفكُّك الأُسَرِي وغيرها من الأمراض الاجتماعيّة التي تعرفها المجتمعاتُ المتقدّمة عادةً أكثر من غيرها.
من الممكن استخدام منهجية المقارنة عندما نرغب في الحديث عن الأزمات التي يعاني منها العدوّ
لا شكّ أنَّ إبرازَ مثل هذه الظواهرِ السلبيّة والتأكيد عليها يُعتبرُ ممارسةً إيجابيةً ونقديةً مفيدةً باعتبارِ أنّها تساعد على تعْريةِ مجتمعِ العدوّ وبعْث الأملِ في نفوس العرَب لتعزيزِ روحِ الانتصارِ على عدوِّهم، والحالُ أنّ الاكتفاءَ بتقديمِ جزءٍ من الصّورة من دونِ الحديثِ عن الجزءِ الآخر منها قد يؤدّي إلى نتيجةٍ عكسيةٍ على المدى الطويل أو المتوسّط، لذلك قد يكون مفيدًا ومنهجيًّا وناجعًا سياسيًّا أن يتعاملَ المهتمّون من العربِ بالشّأن الإسرائيلي مع الأمر بمنهجيةٍ نقديةٍ، فمع إبرازِ تلك الظّواهر السلبيّة من الضّروري أيضًا الإشارة في الوقت عينه إلى أنّها ظواهِر كامنة في كلّ المجتمعاتِ الإنسانيةِ وإن بتفاوتٍ بين مجتمعٍ وآخر.
من الممكنِ أيضًا استخدامُ منهجية المقارنة عندما نرغب في الحديث عن الأزمات التي يعاني منها العدوّ، من ذلك إبرازُ إنجازاتِه العلميةِ والعسكريةِ وإن كانت على حسابِنا نحن العرب، والطّرق التي توخَّاها لتحقيقِ كل ذلك، بما قد يفيدُ أو يساعدُ على تدارُكِ الواقع وتحقيق المبتغى والأهداف. ليْس من المعقول مثلًا، وفي إطار إبرازِ عوْرات النّظام السياسي في إسرائيل التّركيز على فسادِ المجتمعِ السياسي الإسرائيلي في الوقت الذي لا نتحدَّث فيه "بإعجابٍ" عن استقالةِ المسؤولين الإسرائيليين المتورِّطين في فضائحِ الفسادِ مع معايشةِ الفرْدِ العربي فسادَ الأنظمةِ والمسؤولين في مجتمعهِ من دونِ أن يسمعَ باستقالةِ هذا المسؤول من تلقاءِ نفسِه أو إقالتِه أو محاسبتِه على خلفيّةِ ما ارتكبَه من حماقاتٍ تجاه الدولة والمجتمع.
العديد من البلدان العربية تُحَمِّلُ مسؤولية "عجزها" للآخَر من دون الالتفات للعوامل الذّاتية والداخليّة
من الغَبَاءِ أيضًا في عصرِنا هذا، أن نتحدّثَ عن الأزماتِ السياسيةِ للدولة الصّهيونية أو عن فسادِ النّظام الديموقراطي الإسرائيلي (الأغرب والأعجب في العالم) في الوقت الذي لا نذكر فيه قدرةَ رجالِ السياسةِ الصّهاينة على ممارسةِ النّقدِ الذّاتي والقبولِ بمحاسبةِ تصرفاتهم وسلوكهمِ السياسي من دون تردُّد، أو أن يتمَّ تجاهُل الحديث عن وجود 12 حزبًا سياسيًّا في إسرائيل يستقطب كلّ واحد منها الأعضاء والمُريدين بكل حرّية، في حين لا تسمحُ أغلبُ الدّولِ العربية بحُرِّيةِ المشاركةِ السياسيةِ الفعَّالة للأحزاب، هذا إن وُجِدَتْ أصلًا.
ومع التّأكيد على طبيعة هذا النّظام الاستعماري الإحلالي العُنصري، إلّا أنّنا في المقابِل لا يمكن أن نتجاهلَ قدرتَه على الحفاظِ على مكتسباتِه وتطويرِها بالاعتمادِ على قواه الذّاتية وإن بدعمٍ خارجيٍ مؤكَّدٍ، بينما العديد من البلدانِ العربيةِ تملك الكثيرَ من الإمكاناتِ والقدراتِ الماليةِ والمواردِ الطبيعيةِ، لكنها لم تتمكّن من النُّهوض الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في الوقت الذي تُحَمِّلُ مسؤوليةَ "عجزِها" للآخَر من دون الالتفاتِ للعواملِ الذّاتيةِ والداخليّة!.
(خاص "عروبة 22")