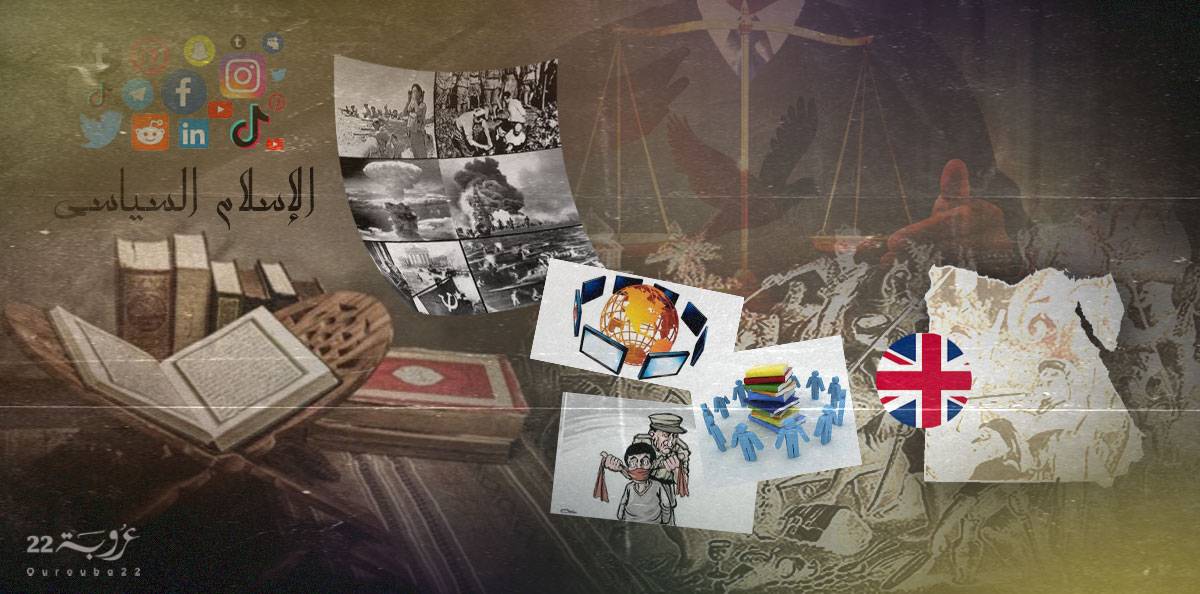ثمَّة أسئلة عديدة تطرحُها مشكلاتُ تَسْييسِ الدّين عربيًّا، نطرحُ بعضَها تمثيلًا لا حصرًا فيما يلي:
- ما هي السّياساتُ الدّينيةُ التي سادت ما بعد الاستقلال؟
- ما أثرُ السّياساتِ الدينيةِ في موتِ السّياسةِ في الدّولِ العربيةِ بعد الاستعمار؟
- هل يشكِّلُ التّراثُ الدّيني النَّقلي عائقًا أمام تحريرِ الإيمانِ الفردي من براثنِ معتقَلاتِ العقلِ والضّمير وسياجاتِها السُّلطوية؟
- هل يمكنُ التحوُّلُ من إيمانِ الجموعِ الفعليةِ والرّقميةِ الغفيرةِ إلى الإيمانِ الفرديّ الحرّ، والخروجُ من حالةِ تأميمِ الإيمانِ والعقائدِ والحرّياتِ الدينية من قِبَلِ السّلطاتِ الاستبداديّةِ والتسلّطيةِ ومؤسَّساتِها الدينيةِ التَّابعةِ، ومعها الجماعاتُ الإسلاميةُ السياسيةُ والسلفيّة؟
السلطة الدينية التابعة سعت إلى أن تُضْفي على سرديَّاتها النقليّة مسحةً من القَداسة مرتكزةً إلى سيف السّلطان
السّياساتُ الدينيّةُ – مصطلحٌ طرحناه في التسعينيّات والألفيّة الجديدةِ في بعض مؤلفاتِنا - تختلفُ وتتمايزُ نسبيًّا ما بين النُّظُمِ العائليةِ التّقليدية، والنُّظُمِ الجمهوريّةِ العسكريتاريّة، وبيْن المَثَالِ المصري ودولةِ المخزن المغربيّة، وتونس نسبيًّا، وذلك فيما يلي:
الأنظمةُ العائليةُ ونموذجُ الخلافةِ السّياسيَّة الوراثي ما بعد الاستعمار أو بموافقتِه أثناءَ احتلالِه، ومعها النُّظُمُ الانقلابيةُ، استخدمَت الإسلامَ كمصدرٍ للشّرعيةِ السّياسية، ونظامٍ للرّقاباتِ على السّلوكِ الاجتماعي للأشخاصِ والشّعب، وتعتمدُ على سلطةٍ دينيّةٍ تابعةٍ تضعُ "سياجاتٍ دينيّةً" على العقلِ والضّميرِ الفردي، وتُخْضِعُ مفهومَ الحريةِ في إطارِ معتقلاتِها من التأويلاتِ الوضعيّةِ وسرديَّاتها حول النّصِ المقدّسِ - تعالى وتنزّه - وللسنّةِ النبويّةِ المشرّفة.
سَعَت هذه السلطةُ الدينيةُ التابعةُ إلى أن تُضْفيَ على سرديَّاتِها النقليّةِ مسحةً من القَداسة، أو مقدَّسٍ حولَ المقدَّسِ - والعياذ بالله - مرتكزةً إلى سيفِ السّلطان المتغلّب الذي يُقَدَّمُ على أنّه مرفوعٌ على الرؤوس دفاعًا عن المقدَّس. من ثمَّ شهدَت هذه الدولُ والمجتمعاتُ حالةً من الرّكودِ العقلي، ودارَت ثقافتُها السياسيّة بين حدَّي الطُّغيانِ والعبوديّةِ الطوعيّة - بتعبير إيتيان دي لا بويسيه - وركّزَت على الطابعِ الجمْعي للإيمانِ العقدِي أي على التديُّن الجمْعي، كأداةٍ للسيطرةِ على المُجتمع. في الوقت عينِه، منحَت مؤسساتها الدينية الرسمية سلطةَ تحديدِ الهندسةِ الدينيةِ والاجتماعيةِ للخضوعِ والامتثالِ للحاكم/العائلة، ولرجالِ الدّينِ الموالين، وجَعَلَت المجتمعَ يدورُ حول الثنائيّاتِ المُتضادّةِ التي تتناسلُ من بين أصلابِ الحلالِ والحرام... إلخ.
بدأت سياسة إصلاحيَّة جزئية لكن خارج السياسة مع تمدُّد الحرية الاستهلاكية المفرطة وتأثيراتها المُتعدِّدة
أدّى ذلك إلى أشكالٍ من الازدواجيةِ الشخصيّةِ والجَماعيّةِ بين الامتثالِ الظّاهري/الخارجِي في السُّلوكِ وممارسةِ الطّقوسِ الدينيّةِ والاجتماعيّةِ واللّغةِ اليوميّةِ الشائِعة، وبين نقائضِ ذلك المستورة في الأماكنِ المغلقةِ والآمنة، وهو أمرٌ كاشفٌ عن التناقضِ بين حدَّي القمْعِ والخضوعِ، وبين حدِّ التّحَرُّرِ المستورِ خلفَ الأبوابِ المغلقة!
حَدَثَ بعضُ التَّغيُّراتِ الإصلاحيّة الجزئيّة بعد ثورةِ عوائدِ النَّفطِ وتنامي القوّةِ الماليّة، وضغوطِ العالمِ الخارجِي حولَ انتهاكاتِ الحرّياتِ وحقوقِ الإنسان، وهيمنةِ الإعلامِ التلفازِي للفضائيّات، وتنامي الطبقةِ الوسطى، والتعليم، والسّفرِ للسياحة، والبعثات إلى الجامعاتِ الغربيّة، وتمدُّدِ ثورةِ وسائلِ التّواصلِ الاجتماعي الرَّقميةِ على وجهِ الخصوص، وبدأ بعض هذه السِّياحات يتداعى، وينكسرُ بعض قوادِمِها في بعضِ الوعيِ الفردِي وشبه الجمْعي، وقد بدأت سياسة إصلاحيَّة جزئية لكن خارج السياسة، مع تمدُّدِ الحريةِ الاستهلاكيةِ المفرطةِ وتأثيراتِها المُتعدِّدة.
لقراءة الجزء الأول
(خاص "عروبة 22")