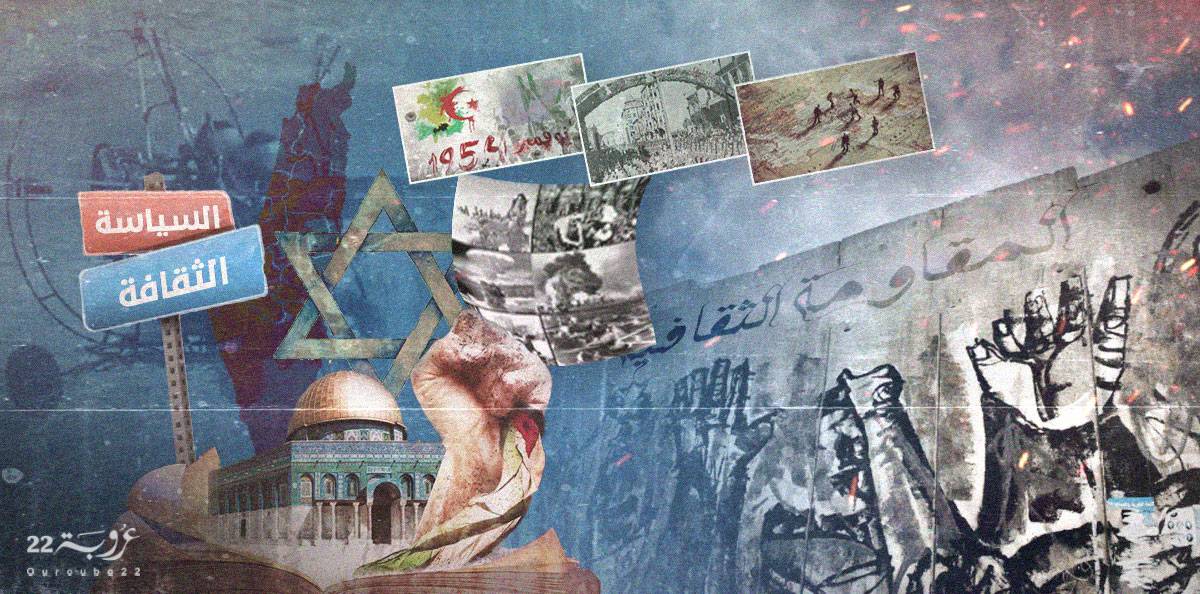نحن إزّاء ظاهرة اتّسعت إلى درجة أن أصبح لكلّ سلطة أو معارضة مثقّفوها للدّعاية الإيديولوجيّة والسياسيّة من دون التخلّي عن الإنتاج الثقافي بمفهومه الواسع والنضال السياسي في الوقت ذاته.
بالنّسبة للعالم العربي، فقد كان ارتباط المثقّف بالسياسة ظاهرة متواترة، بل كان من الصعب أن تجد مثقّفًا لا صلة له بالسياسة، مع تفاوت وتنوّع في أشكال الارتباط ودرجته ونوعيته: شعراء، أدباء، نقّاد، باحثون في العلوم الإنسانية والقانونية والاقتصادية، فنّانون.
شارك العديد من المثقّفين في الحروب الأهليّة أو الصراع ضدّ الفاشية والنازية
لقد ساهم بروز الثّورة الفلسطينية ومختلف تنظيماتها في تأطير فئاتٍ، من المثقّفين الفلسطينيّين والعرب وغيرهم، تفاعلَت مع طبيعة هذه القضية بأشكال متنوّعة ومضامين مختلفة، وإن كان هذا الانخراط الطّبيعي يتماشى وطبيعة المثقّف، المفترضة، وأحد هواجسه المتفاعلة مع إبداعه، إلّا أنّ انخراط المثقّف في المقاومة المسلّحة يبدو محدودًا، بل نادرًا في عصرنا.
وفي العالم بأسره، شارك العديد من المثقّفين في الحروب الأهليّة أو الصراع ضدّ الفاشية والنازية، من ذلك المارتينيكي فرانز فانون الذي خدم خلال الحرب العالمية الثانية في جيش فرنسا الحرّة وحارب النازيّين. وبعد تحوّله للجزائر كطبيب، انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني الجزائريّة، وتولّى مهمات تنظيمية مباشِرة، وأخرى ديبلوماسية وعسكرية مُهمّة.
كما نستحضر ما قام به الأديب البريطاني جورج أورويل الذي شارك في الحرب الأهليّة الإسبانية (1936)، متطوّعًا في صفوف الثوار ضد قوّات الدّيكتاتور فرانكو، وقاوم الفرنسي أندري مالرو في صفوف الجمهوريّين خلال الحرب الأهليّة الإسبانيّة، بل انضمّ إلى حركة المقاومة الفرنسية ضدّ الاحتلال النازي، أو التحاق ريجيس دوبري بتشي غيفارا في بوليفيا سنة 1968 وإلقاء القبض عليه ليُحاكَم بالسجن المؤبّد بتهمة مساندة الثوار والمشاركة في حرب العصابات، ضمن أمثلة أخرى.
تراجع دور المثقّف العربي في الالتزام الحزبي والمشاركة في الشأن العام لأسباب ذاتية وذات علاقة بالتحوّلات السياسية
أمّا في العالم العربي، فتبدو ظاهرة انخراط المثقّف الفعلي في المقاومة المسلحة في مرحلة التحرّر الوطني ضدّ الاستعمار محدودة وربما نادرة، مقابل ذلك تمكّنت المقاومة الفلسطينيّة من استقطاب عدد هامّ من المثقّفين الفلسطينيّين والعرب الذي انخرطوا في التنظيمات الفلسطينيّة المختلفة، ولم يكتفوا بالكتابة، بل حملوا السلاح وكان ذلك حتى قبل قرار التقسيم وإقامة دولة "إسرائيل". من ذلك الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود الذي كان ضمن جيش الإنقاذ وشارك في عدّة معارك أدّت إحداها إلى استشهاده (يوليو/ تموز 1948).
كما نذكر المسرحي الجزائري محمد بودية الذي مارس الكفاح المسلّح في صلب جبهة التحرير الجزائريّة، في الجزائر ثم في فرنسا، حيث أوكلت إليه قيادة الفرقة الخاصّة التي نفّذت تفجير خزّانات للنّفط بالقرب من مرسيليا. كما كان بودية أحد مناضلي الجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين وعلى علاقة متينة بوديع حداد، وكان أيضًا المدبّر الرئيسي لجميع عمليات الجبهة الشّعبية في أوروبا في مطلع السبعينيّات، حسب سجلات المخابرات الغربية والصّهيونية، ونتيجة لذلك تم اغتياله عن طريق الموساد بتفخيخ سيارته وتفجيرها في باريس، صباح يوم 28 يونيو/ حزيران 1973.
في المقابل، وخلال الزّمن الرّاهن نلاحظ تراجع دور المثقّف العربي في الالتزام الحزبي وحتّى المشاركة في الشأن العام لأسباب عديدة، منها الذّاتية التي تتعلّق بأوضاعه المادية والسعي لتأمين حاجاته المعيشية الأساسية، تماشيًا مع التحوّلات الاقتصادية العامة، ما دفعه للبحث عن موارد إضافية تضمن له حياة كريمة، بخاصّة مع تعدُّد العروض وكثرتها، ولأسباب أخرى ذات علاقة بالتحوّلات السياسية التي عرفها العالم منذ أواخر القرن الماضي، ممّا أصاب المثقّف بنوعٍ من الإحباط تجاه سلوك الأحزاب وبالنهاية العزوف عن المشاركة السياسية.
يبدو أنّ نموذج المثقّف المقاوِم من المرجعية الإسلامية حلّ محلّ المثقّف اليساري
في خضمّ هذا الواقع، كشفت لنا أحداث "طوفان الأقصى" نوعيّة جديدة من حاملي السلاح الميدانيّين، وهُم في الوقت نفسه مثقفون ومبدعون، ومنهم القياديّان البارزان في حركة "حماس" ذات المرجعيّة الإسلامية، وفي كتائب القسّام تحديدًا:
- أوّلهما يحيى السِّنوار الذي أصدر رواية "الشوك والقرنفل" التي تناول من خلالها تجربة النضال الفلسطيني بعد عام 1967 حتّى الانتفاضة الأولى، بالإضافة إلى ترجمة بعض الكُتُب العبرية إلى العربية.
- ثانيهما محمد الضّيف، وهو من أبرز العقول التي ساهمت في تطوير الصِّناعات العسكرية المحليّة لكتائب القسّام، بما في ذلك الصّواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة. في موازاة ذلك، ساهم محمد الضّيف في إنشاء أول فرقة فنيّة إسلامية تُدعى "العائدون"، وهو الذي استقى، أيضًا، لقبه "أبو خالد" من إحدى المسرحيّات التي شارك في تمثيلها وكانت بعنوان "المهرّج"، حيث تقمّص فيها دور شخصيّة تاريخيّة عاشت خلال الفترة ما بين العصرَيْن الأموي والعبّاسي.
نموذجان من المثقّفين المقاومين من المرجعية الإسلامية، التي توصف عادةً بممارسة الإرهاب، في زمن افتقدنا فيه لهذا النّموذج الذي يبدو أنّه حلّ محلّ المثقّف اليساري الذي لم يكتفِ سابقًا بالتّنظير، بل في امتشاق السلاح من أجل الدّفاع عن قضايا وطنية أو قومية أو إنسانية أو جميعها. فهل نحن بصدد ولادة مثقّف مقاوِم في عالمنا مختلف عن ذاك الذي عرفناه خلال القرن الماضي؟.
(خاص "عروبة 22")