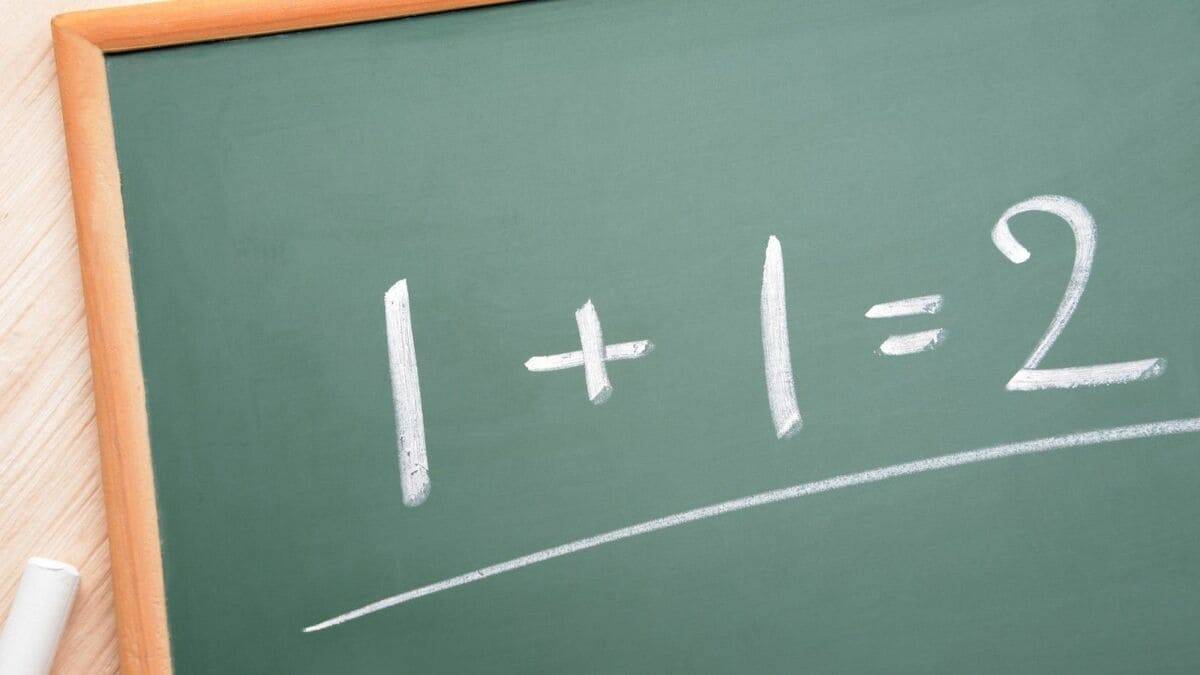على أرض الواقع، يبدو جليًا أنّ الديمقراطية ليست أولوية في بلداننا العربية، وممارستها أقرب إلى تمجيد فئة النخبة الحاكمة التي عادةً ما تُختزل بشخص أو أسرة أو حزب أو تيار سياسي شمولي، وهذه الفئة تعتقد أنها، أيّ الديمقراطية، نقيض للأمن والاستقرار في البلدان التي يحكمونها، فتبسط وصايتها الكاملة على المجتمعات، وغالبًا لا تعترف بحق الشعب في المشاركة، فرديًا أو جماعيًا، في تقرير مصيره، وبذلك تمنع عنه الحق بأيّ ممارسة ديمقراطية حقيقية، مع التنويه طبعًا بوجود استثناءات، ولو بدرجات متفاوتة، بين بلدان الوطن العربي نفسه.
على هذا النحو، تُمارَس الديمقراطية لدينا، بشكل نظام سياسي مجتزأ ومشوّه. في حين أنّ الديمقراطية نظام متكامل، سياسي، إقتصادي، إجتماعي، تنموي وثقافي، معالمه كثيرة، تشمل حكومة مسؤولة وبرلمانًا متمرّسًا وقضاءً مستقلًا، ومؤسسات مهنية، ومجتمعًا مشاركًا وفاعلًا، وعدالة إجتماعية، ومساواة بلا تمييزات طبقية أو دينية أو مناطقية أو اقتصادية.. لتصبح بالتالي ممارسة الديمقراطية فعل سلوك اجتماعي.
لا ديمقراطية من دون تعليم يستنهض المجتمعات العربية على أسس تربوية تنطلق من "4 مسلّمات"
لكن حتى وقتنا الراهن، لا يزال أغلب عالمنا العربي يفتقر إلى نموذج الحكم السياسي الرشيد والواعي والمتعايش مع أسس الديمقراطية ومفاهيمها. رغم ذلك، ثمّة آمال معلقة، ومحاولات فردية نخبوية ثقافية، تطمح لأن تتغلغل الديمقراطية في كل تفصيل من تفاصيل حيواتنا العربية، كي يصبح لدينا حوكمة رشيدة وتنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية وقطاع تربوي وتعليمي سليم.
وهنا "بيت القصيد"، إذ لا مناص من مقاربة النظم الديمقراطية من دون الإرتكاز على أهمية دور التعليم ومحوريته في استنهاض المجتمعات العربية على أسس تربوية راسخة، تنطلق من "4 مسلّمات" بديهية، باعتباره: أولًا "حقًا مقدّسًا" للشعوب، وثانيًا "المدماك الأساس" في بناء التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وثالثًا "حجر الزاوية" في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي المتصل بالممارسة الديمقراطية، توصّلًا إلى تكريس مفهوم "إدخال العلم إلى الثقافة" في عالمنا العربي.
فإذا كانت ثقافة الديمقراطية تلعب دورًا مركزيًا في تطوير القطاعات التربوية والتعليمية والثقافية، غير أنّ العكس أيضًا صحيح، بحيث يُشكّل التعليم ممرًّا إلزاميًا للعبور بالمجتمعات نحو الديمقراطيات من خلال تثقيف الأجيال الناشئة وتشكيل وعيهم الثقافي بمعايير علمية وعملية ترتقي بمفاهيمهم الثقافية وتندمج في تكوينهم التربوي والمجتمعي، لتخطّ تاليًا مسارًا واضح المعالم والغايات، يربط بين "نقطة البداية" في المناهج التعليمية العلمية، وبين ما سيؤدي إليه ذلك عند "نقطة النهاية" من نتائج تلقائية في تعزيز أواصر الحكم الديمقراطي الرشيد والنظم المعرفية المتطورة.
التعليم يجسّد اللبنة الأولى في تكوين مجتمعات معتنقة للفكر الديمقراطي الحداثي المتطوّر
إذًا المعادلة بسيطة، وهي تقوم أساسًا على أنّ أي نظام حكم ديمقراطي سيؤدي حتمًا إلى خلق مناهج تعليمية متطورة ومفيدة وقطاع تعليمي يبني الوعي والثقافة والمعرفة لدى الشباب عبر رصد ميزانيات كافية لتطوير المنظومة التعليمية ومراكز البحث والابتكار. وكذلك في المقلب الآخر، تبرز استحالة الولوج إلى عالم الديمقراطيات إلا من خلال مبدأ "علمنة التثقيف"، بمعنى إضفاء الطابع العلمي على الحيّز الثقافي التعليمي، فكما أنّ حقوق الإنسان تشكّل النواة الأولى لأي ممارسة ديمقراطية، كذلك فإنّ التعليم يجسّد اللبنة الأولى في تكوين مجتمعات معتنقة للفكر الديمقراطي الحداثي المتطوّر، خصوصًا في حال تشكّل الوعي بمفهوم الديمقراطية على مقاعد الدراسة، لتتبلور بديهيًا من بعدها المؤسسات الديمقراطية على أيدي جيل مؤهل علميًا، يؤمن بأنّ ممارسة الديمقراطية الحقيقية لا بدّ وأن تتظهر بدايةً في مستوى وعي الأفراد وثقافتهم، بينما الإفتقار إلى هذه الممارسة سيؤدي حكمًا بالمجتمعات والدول إلى حوكمة مفقودة وإقتصاد متهالك.
فيستحيل على الإنسان أن يكون "ديمقراطيًا" إذا لم ينتهج تعليمًا حداثيًا يُدخل العلم في قاموس تربيته وثقافته، لا سيما وأنّ حصاد الوعي في العقول لا بد وأن يبدأ من زراعة العلم في الحقول التربوية لتثمر مجتمعات ديمقراطية واعية وواعدة تواكب متطلبات الابتكار والتطور وبناء المعرفة على قواعد علمية تعليمية سليمة. فالتربية العلمية تبني شخصية الإنسان، حامل الثقافة الديمقراطية، وتخوّله ممارستها على صعيد المؤسسات، أما إذا مورست عليه سلطة مستبدة في الدولة والمجتمع والأسرة، فسيعيد ذلك إنتاج إستبداد مماثل في دورة الحياة المحتمعية، والأمثلة تطول في هذا السياق، منها، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة كتب التاريخ المدرسية في المناهج التعليمية العربية، والتي يتمّ من خلالها التلاعب بالذاكرة الجماعية، من خلال تحريف الحقائق وتزويرها أو صياغة المعلومات بأسلوب يُخفي السلبيات ويُظهر الإيجابيات من وجهة نظر السلطة المهيمنة، حتى أنّ بعضها يشكل حالة من الإجتزاء الفكري، ما يجعلها ذات مضامين سياسية أكثر منها حقائق علمية تاريخية.
"تشكيل الوعي" بالممارسة الديمقراطية يبدأ من تطوير النظُم التعليمية، ولا ينتهي عند تحقيق التكامل وتضافر المصالح
أما التربية العقلانية المؤدية إلى إدخال العلم على الثقافة المجتمعية، فتعزّز القدرة على التفكير بشكل مستنير وتنموي، واسع الهوامش والأفق، وهذا بالتحديد ما تحتاج إليه مجتمعاتنا العربية التي انعكس افتقارها للتعليم العلمي السليم افتقارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، وتغييبًا متمدّدًا للحوكمة الرشيدة والممارسة الديمقراطية الفاعلة.
وعليه، يبقى من المهم النظر إلى مبدأ الديمقراطية بوصفه وسيلة لا غنى عنها من أجل بلوغ الغاية في تحقيق عدالة اجتماعية، وتنمية اقتصادية، ومشاركة فاعلة في الحياة السياسية، وثقافة مجتمعية تشمل الحالة التعليمية العلمية العصرية... ولعلّ "تشكيل الوعي" إزاء أهمية الممارسة الديمقراطية يبدأ من تطوير النظُم التعليمية، ولا ينتهي عند تحقيق التكامل في الأهداف والمرامي بين دول ديمقراطية تصنع شعوبًا واعية متعلّمة تؤمن بتضافر المصالح وتقاطعها.
(خاص "عروبة22" - إعداد حنان حمدان)