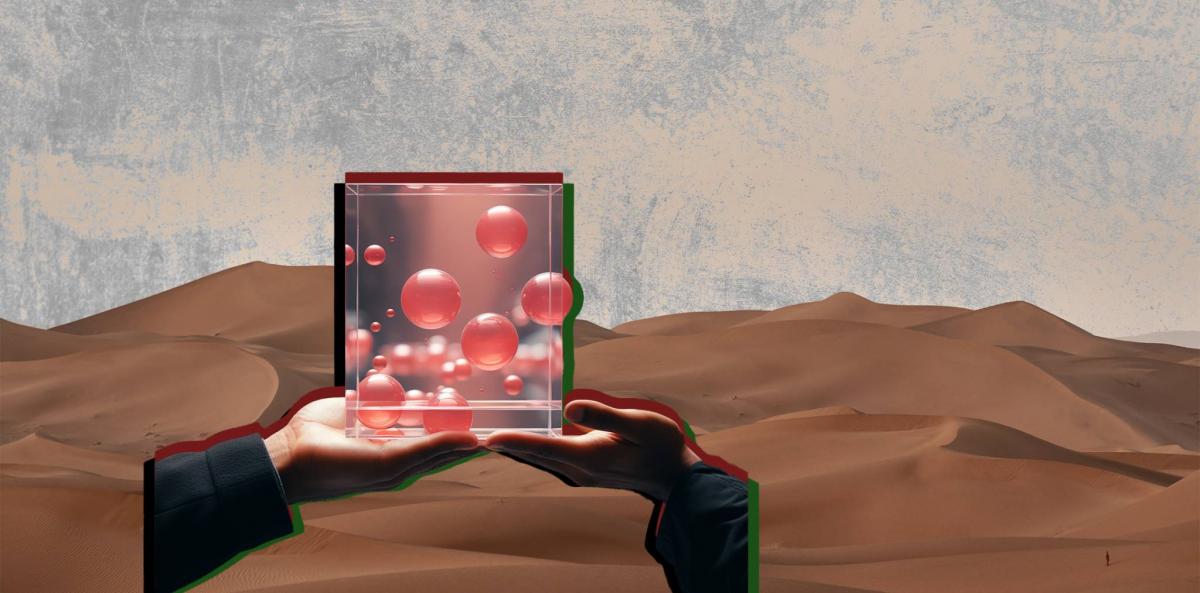هل يمكن تجديد المشروع العربي؟ وما هي أسباب الارتقاء لحفظ إنسانية العربي في وطنه ومجتمعه وأمّته؟ وكيف السبيل لتبديد صورة التخلّف الملازمة لصورة العربي في مقابل تخيّله لبربرية الآخرين وقطيعته معهم؟ هل يمكن لأمة تجمعها اللغة وروابط الأديان ووحدة الجغرافيا أن توحّد نفسها على مستوى الفعل السياسي، سواءً من خلال "الدولة العربية الواحدة" المتماهية على مساحة الأمة ديموغرافيًا وجغرافيًا أو من خلال التكتلات السياسيّة أو الاقتصادية، وما هي شروط ذلك؟ ثم هل وجود هذا الكيان الواحد ضروري أصلًا من أجل فعل سياسي موحّد في ظل التطوّر الكبير لمفهوم الدولة الوطنية الحافظة للحقوق والكرامة والضامنة للحريات، أم أنه يمكن الاكتفاء بتضامن عربي في إطار منظومة إقليمية وتكامل اقتصادي، وتنسيق أمني واستراتيجي فاعل؟
قد تبدو هذه الأسئلة/الإشكاليات شيئًا مكررًا، وهي كذلك، لكنها ما تزال ضرورية إزاء الارتكاس العربي الكبير وعلى كلّ المستويات، وهو ما سمّاه يومًا وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير الراحل سعود الفيصل بـ"الخواء الاستراتيجي" (2010)، واصفًا الوضع العربي المضطرب والعاجز والمرتبك.. ففي عالم اليوم ما عادت التنمية والتأثير والشراكة ألغازًا يستحيل حلّها، بل هي فعلٌ بشري قائم على التخطيط والشفافيّة واحترام القانون والاختصاص والعلم والحرية، ونبذ الخرافة، والتصالح مع الذات والعام.
ثمّة من يجلس على رأس سلطةِ الهزيمة عقودًا ثمّ يحاضرُ في الإصلاح وضرورته
الأمّة، كما الدولة، وجودٌ يصنعه المجتمع بأفراده وجماعاته وإثنياته، يقول الفضل شلق، وكلٌّ من هؤلاء لا يشكّل كتلة متجانسة، إذ التعدديّة موجودة في كل جماعة كما في كل فرد. وبذلك يعتمد وجود الدولة والأمّة (أو الدولة/الأمّة) على العلاقات بين الأفراد والجماعات التي يتشكّل منها المجتمع، والمجتمع بدوره مجالٌ متشابك يستوجب وجود إدارة للسياسة والاقتصاد وتقبّلًا للآخر واحترامًا حقيقيًا للحريات.. وإذا ما سُلخت هذه المفاهيم عن معانيها وأُلحقت بشعارات متسامية متضخّمة سهُلت مصادرتها وانقلبت إلى ضدّها، وتحوّلت إلى مفاهيم مفرّغة من مضامينها، وستارًا للقمع والاستبداد. في الحالة الأولى، ثمّة حاجة للرؤيوية والحوار والإرادة والجرأة والقدرة وللتنازلات أيضًا، وكلّ ذلك يتطلّب جهدًا على الصعيدين الفكري والسياسي، أما في الثانية، فلا شيء غير "التمثيل" على الشعب، لا تمثيله، من خلال تعليب المفاهيم والمقولات باسم الدين والقومية والثورة والحداثة، وإعطاء كل ذلك أبعادًا إلهية أو شموليّة منحرفة.
لم تجد الهزائم في المجال العربي من يتبنّاها أو يتحمّل تبعاتها، بالرغم من أنها كانت كالأقدار. سارعَ الجميعُ إلى التبرؤ منها. لا بل خلقت الأنظمةُ وعيًا سياسيًا يضعُ اللوم على المجتمع لا السياسات والنخب والقادة!! فوق ذلك، ثمّة من يجلس على رأس سلطةِ الهزيمة عقودًا ثمّ يحاضرُ في الإصلاح وضرورته، وربما يطمحُ إلى تغيير الشعب والإتيان بآخر يوافق تطلّعاته الملهَمة! هؤلاء كانوا تجسيدًا صريحًا لأيقونة دينيس فيلنوف (Prisoners, 2013) عن أنّ "الوحوش حقيقية والأشباح حقيقية أيضًا، إنهم يعيشون بداخلنا وأحيانًا يفوزون".
في سبعينيات القرن الماضي اعتُبر التخلّفُ مسألةً اجتماعيّة تتعلّق بالبُنى والهياكل الاجتماعيّة لا بالسياسات وحدها، ولا بالقيادات السياسية وحدها، وكان أن أوصلت هذه المقولات (التخلّف = التنمية) إلى ظهور ما سمّي النقد الثقافي للمجتمع؛ فالمجتمع العربي تقليدي، يعتمد في وعيه ولاوعيه على الموروث الثقافي، و"المطلوب" أن يخرج من حال إلى أخرى، ومن التقليد إلى الحداثة، إذ الحداثة هي النموذج الذي يجب أن يحتذى.. وظهرت عنصريّة ثقافيّة تقول إنّ هناك ثقافات أفضل من أخرى، وترتب على هذا التشتت (التخلّف والنقد الثقافي وثنائية التقليد والحداثة) مقولة خطيرة تدّعي أنّ التفوّق الثقافي يستدعي تفوّقًا أخلاقيًا وحضاريًا، وهذا كافٍ لتبرير احتلال دول واقتلاع شعوب تحت ذرائع التفوّق أو الديموقراطية.. ناهيك عن أنّ هذه الجدالات عكست انفصال النخب عن الواقع وعن تطلّعات الشعوب وهمومها.
معنيّون بإدارة الحاضر وصناعة المستقبل.. ومطالَبون بإنزال مفاهيم كثيرة من فضاء التنظير إلى مستوى عملي
لم يكن القرن الحادي والعشرين أكثر إيجابيةً وتفاؤلًا، إذ انتقلنا من إدانة المجتمع وتقاليده إلى الدعوة لتغييره، وهذا فتح الباب أمام "ثورات" دون تخطيط، وإلى انتخابات دون ثقافة ديموقراطية تضمن ممارسة صحيحة لها، وإلى استعجال التغيير ولو على حساب التدخّل الخارجي.. وكان أن رميت مجتمعات عربية بالفوضى والتفسّخ والتفكّك، وبات مفهوم العروبة وما يتعلّق به من مفاهيم وتطلعات محلّ جدل ونزاع وخصومة.
إزاء تكاثر المشاريع والأصوليات والنماذج؛ نحتاجُ إلى التفكير في قضايا الدولة والمجتمع، والحرية والشرعيّة، والانتماء والوعي، والتأثير والعلاقة بالعالم من خلال تطوير الأطروحة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية عن العروبة.. ومن خلالها. العالمُ تغيّر كثيرًا، وثمة آفاق واسعة للإفادة من تجارب ناجحة في التنمية والتكامل والإدارة... علّها تكون خطوة على طريق التحرّر والحرية. مجددًا، لسنا مسؤولين عن محاكمة الماضي، لكننا معنيون بإدارة الحاضر وصناعة المستقبل.. ومطالبون بإنزال مفاهيم كثيرة من فضاء التنظير إلى مستوى عملي بهدف إعادة تحريك الكتلة التاريخيّة التي يعوّل عليها في عمليّة التغيير.
إنّ نقاش المسألة الثقافية والتاريخيّة في الوعي والمجتمع والدولة، والتدقيق فيها ومن ثمّ تطويرها بما يلائم متغيّرات الأزمنة وتحديات العصر، كفيلٌ بإطلاق حوارية جدليّة بين الحدث التاريخي، الفكرة، الطموح، الخطاب والعلائق.. وهذا الأمر جدير – أيضًا وأيضًا – بالسعي.
أما وعيُ العالم – الذي باتَ يتغيّرُ بسرعة - فله حديثٌ آخر.
لقراءة الجزء الأول: العرب وتجديد التفكير في الانتماء والتكامل والتأثير (2/1)
(خاص "عروبة 22")