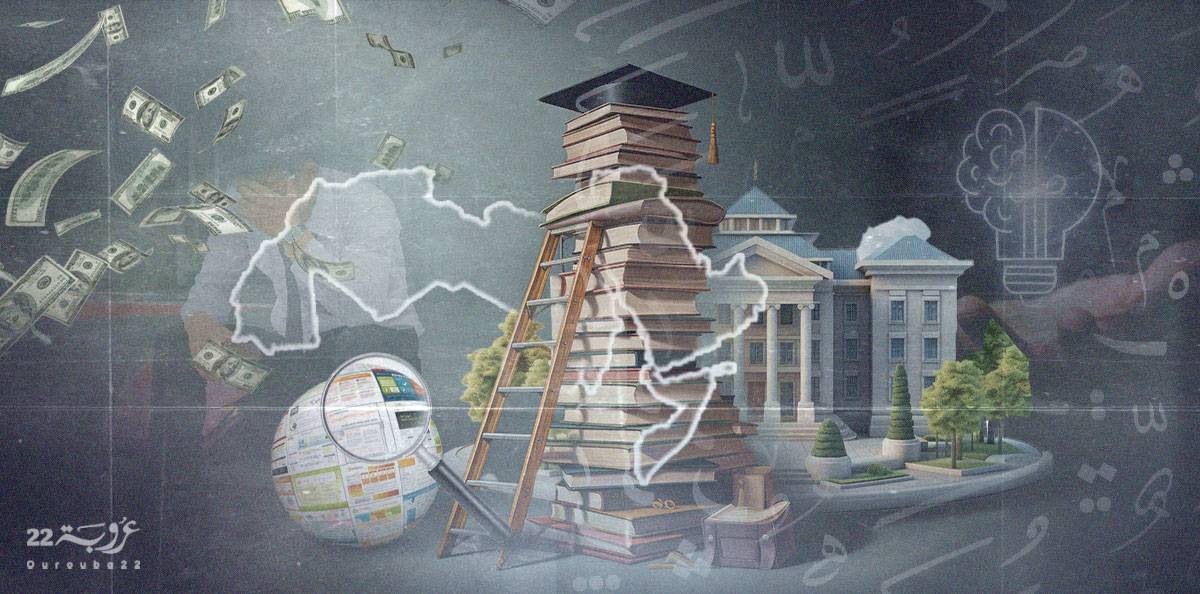على الرَّغم من وجود مؤسّسات تعليمٍ عالٍ في الوطن العربي منذ أبعد من عشرة قرون، قام أكثرها على تمويلٍ أهليّ من الهِبات والأوقاف، من الأزهر في مصر، والقيرون في المغرب، والزيتونة في تونس، إلّا أنّ المؤسسة الجامعيّة بالمعنى الحديث، ليست قديمة العهد، فثلاثة أرباع الجامعات العربية أُنشئت في الربع الأخير من القرن العشرين، كما ورد في تقرير "التنمية الإنسانية العربية التابع لبرامج الأمم المتحدة"، وبذلك لا يتعدّى عمر 57% منها أكثر من ثلاثين سنة، وهذه الإشارة على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، لناحية التأخّر في بناء القطاع التربوي الجامعي.
عمل روّاد النهضة الأولى على ترسيخ أسُس البحث العلمي في الجامعات لكنه مسارٌ لم يُكتب له الاستمرار
استغرق الكثير من مؤسّسات التعليم العالي، والجامعات بشكلٍ خاصٍّ، وقتًا لكي تُرسّخ بنيتها المؤسّساتية، ولكي تُقدّم جودةً معرفيةً في شتّى التخصّصات، لأنّها كانت تُدار بعقليةٍ تقليدية، طغى عليها الفساد والرّشوة والمحسوبيّة، وأيضًا تأثّرت نوعية التعليم في مؤسّسات التعليم العالي في البلدان العربية، بعوامل شتّى منها: عدم وضوح الرؤية وغياب استراتيجيّات وسياسات واضحة للعملية التعليمية، واكتفت فقط بتخريج الطلاب وإعطائهم الشهادات، بالإضافة إلى أنّ هذه المؤسّسات واجهت مقاوماتٍ من أكثر من جهة.
فلقد نشأت الجامعات الحديثة أوّلًا بمجهوداتٍ أهليةٍ انطلاقًا من الحاجة لمواكبة العصر والتحديث، خصوصًا في لحظة الحدث الأبرز عندما دخل نابوليون إلى مصر، واصطدم العقل العربي مع نفسِه، بمواجهة الضعف والتفكّك، لهذا لاحقًا عملت القوى الوطنية التي كانت مشغولةً بِهَمّ النهضة والتقدّم، لكنّها واجهت مطرقتيْن، الداخل ومشاكله، والخارج الذي أتى مستعمِرًا للمنطقة بشكلٍ مهمينٍ على معظم المنطقة العربية، والذي فرض التقسيم الذي ولّد العالم الجديد للمنطقة، خصوصًا بعد تفكّك الامبراطورية العثمانية.
من هنا تعدّدت المصالح الفئوية والتقسيمات الطائفية مع تفكّك مركزيّات الدول، ممّا أدّى منذ البداية إلى أزماتٍ ما زلنا نعاني منها إلى الآن. وفي المسار عمل روّاد النهضة الأولى على ترسيخ أسُس البحث العلمي في الجامعات من خلال بلْورة إشكالياتٍ نجحت في الإضاءة على الكثير من المواضيع، إزاء المقارنات بين البنى العربية، وبنى العالم الغربي، لكنه مسارٌ لم يُكتب له الاستمرار، وهنا لبّ الموضوع، أي غياب المشاريع المعرفية عند النّخب الحاكمة، وإن وُجدت فإنّها تأخذ طابع الاستبداد والغلبة، للتفجّر لاحقًا على صورة حروبٍ واقتتالٍ أهليّ، بمضمون هوياتٍ متعدّدةٍ: الطائفي، والمذهبي، والقومي، والحزبي.
الجامعة وزبائنية النّخبة
إنّ المعضلة الأبرز لعددٍ كبيرٍ من الجامعات العربية، عدم استقلالها سواء كانت حكومية أو خاصة، تحت رقابة وسيطرة الأنظمة السياسية الحاكمة، ما جعلها تقع تحت نير الصّراعات السياسية والإيديولوجية، وأدّى ذلك إلى ابتعادها عن مؤسسةٍ تُعلّم التخصّصات، وتحوّلها إلى ساحةٍ للولاء والتدجين، وتعليب العلم بما يخدم وجهة السلطان، من هنا وبسبب تشجيع السلطة لتياراتٍ محدّدةٍ لخدمة أغراضها، أثّر ذلك سلبًا على قدر الحرية والتفكير، خوفًا من المعاقبة، لأنّ الرقابة بالمرصاد.
الإنفاق على التعليم العالي يؤثّر على نوعية وجودة التعليم وعلى الموارد المُتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس
في هذا السّياق، أصبحت تُدار المؤسّسات الجامعية بمنطق التبعية للأنظمة الحاكمة، وأصبحت الجامعات تُدار بعقلية الولاء وفقًا لمُقتضيات الحكم، وليس وفقًا لخططٍ وبرامج تنموية، لذلك نرى تكدّسًا مُخيفًا بسبب تزايد أعداد الطلاب في الجامعات، إلكن في المقابل نرى تزايد أعداد البطالة، في صفوف الطلاب المتخرّجين، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى موضوع الإنفاق على التعليم العالي الذي يؤثّر على نوعية وجودة التعليم، وعلى الموارد المُتاحة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، لا سيما وأنّ التوسّع الكمّي أتى على حساب نوعية التعليم وجودته، وأيضًا على حساب التّقنيات الحديثة، وبرامج التعليم والمناهج الجديدة، فمثلًا نجد أنّ المكتبات الجامعية أصبحت دون المستوى، لناحية البحث العلمي، لأنّها في الكثير من الأحيان تنتهج منطقًا اتّباعيًا تقليديًا يقوم على حفظ النصوص، وليس على الابتكار.
أولويات لبنية تعليمية جديدة
هذا المنطق تحدّث عنه المفكّر إيفان إيليتش (1926-2002)، لناحية المنهج الدراسي الخبيء، الذي يصادر مهارات الطلاب، وبالتالي يجعلهم عالة، لأنه يشكّك بسلامة التعليم، من خلال الرعاية التأديبية، وتوزيع الناس وِفق أدوارٍ محدّدة، وتعليم القيم المُهيمنة، واكتساب المهارات المحدّدة سلفًا.
من هنا هذا المنطق التلقيني نراه يسري بشكلٍ كبير على التعليم في مؤسّساتنا العربية، ومن دون القطيعة مع هذه الأنماط، لن نرى تعليمًا يعطي قيمةً للفرد بوصفه إنسانًا يعمل على الابتكار.
(خاص "عروبة 22")