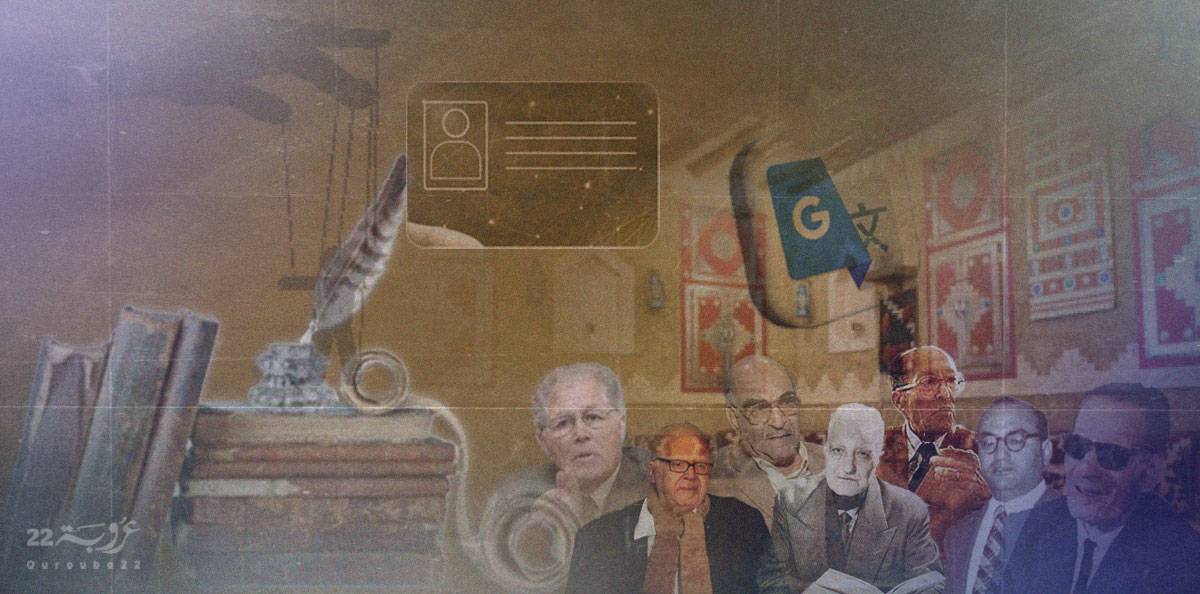في الفكر العربي المعاصِر، ربّما كان أهم الإنتاج الفلسفي من إبداع كتّابٍ لا ينتمون إلى العائلة الأكاديمية الفلسفية، في مقدّمتهم عميد الأدب العربي طه حسين الذي كان واسع الاطلاع على الكتابات الفلسفيّة قديمًا وحديثًا، وقد عَدَّهُ الفيلسوف المعروف عبد الرحمن بدوي من بين مؤسّسي المباحث الفلسفية العربية، على الرَّغم من كوْن بدوي لا يكاد يعترف لأحدٍ من معاصِريه بمزيةٍ أو فضل.
ولا شكّ أنّ الكاتب والأديب العصامي عبّاس محمود العقاد من أهمّ الوجوه الفلسفية العربية، وقد كتب حول الفلاسفة المُسلمين والأوروبيين، وصاغ مقاربةً فلسفيةً خاصةً به، لعلّ أهم عمل يعبّر عنها هو كتابه "التفكير فريضة إسلامية".
مدرسة النّقد الحديث التي سيطرت بقوّة على الساحة العربية شكّلت رافدًا أساسيًا من روافد التفلسف
في المغرب العربي، دخلت الفلسفة بقوّة من بَابَيْ الأدب والتاريخ، ولا أحد يُنكر أنّ الرّوائي التونسي محمود المسعدي قدّم للجمهور العربي أهمّ نصوص الإبداع الفلسفي الأدبي من خلال كتابَيْه" السد" و"حدث أبو هريرة قال". أمّا المؤرّخان عبد الله العروي وهشام جعيط فيجمعهما شغف بالفلسفة واطّلاع كامل على نصوصها الأساسية وتاريخها. في مفاهيم العروي (وخصوصًا مفهوم العقل ومفهوم التاريخ)، نلمس هذا النّجاح الباهر في ضبط الإشكالات الفلسفيّة المعقّدة وتطبيقها في الكتابة التاريخية الدقيقة. ولقد أسّس العروي في الحقل الفلسفي العربي المعاصِر نهج التاريخانية الإيديولوجية الذي يُشكّل تحوّلًا نظريًا هامًّا ترك أثره المكين في مختلف الدراسات الإنسانية.
أمّا جعيط فقد اهتمّ بقوةٍ بفلسفة جورج هيغل وبتطوّرات المدرسة النقدية الألمانية، ومن خلال هذه الزاوية عالجَ في نصوصٍ هامةٍ، إشكالية النهضة والتنوير والحداثة في السياق العربي المعاصر، كما طبّق هذه المقولات المنهجية في أعماله حول الإسلام المبكر والوسيط.
لا شكّ أنّ مدرسة النّقد الحديث التي سيطرت بقوّةٍ على الساحة العربية منذ ثمانينيّات القرن الماضي، شكّلت رافدًا أساسيًا من روافد التفلسف، خصوصًا بعد المُنعرج البنيوي والتفكيكي وشيوع نظريّات التحليل المنطقي اللّغوي والمناهج التداولية والبراغماتية اللّسانية. من الأسماء البارزة في هذا السّياق، جابر عصفور وصلاح فضل من مِصر، وعبد السلام المسدّي من تونس، ومحمد مفتاح من المغرب، وعبد الله الغذامي من السعودية.
الثغرة الكبرى في الإنتاج الفلسفي العربي هي العجز عن الإسهام الفاعل في السرديّة الفلسفية الكوْنية
لقد تزامن هذا التوجه اللّساني النّقدي مع طغيان إشكالات القراءة والتأويل في الأدبيّات الفلسفية العربية التي اتّجهت منذ منتصف الثمانينيّات إلى المسألة التراثية بحثًا عن آفاقٍ جديدةٍ للإبداع الفلسفي. وهكذا في الوقت الذي اعتمد طيب تيزيني مسلكًا إيديولوجيًا ماركسيًا تقليديًا في أعماله التأويلية للتراث، اختار محمد عابد الجابري النهج البنيوي التكويني في تاريخيّته النقدية للعقل العربي في جوانبه النظرية والسياسية والأخلاقية، وحاول نصر حامد أبو زيد وضع مقاربةٍ هرمنوطيقيةٍ جديدةٍ للمدوّنة التراثية على أساس تحليلية الشعور والوعي التي كرّس الفيلسوف المصري حسن حنفي محدّداتها النظرية. أمّا محمد أركون فقد أراد بناء "إسلاميّاتٍ مطبّقة" على غرار ابستمولوجيا غاستون باشلار، لكنه ركّز على الأدوات اللّسانية اللّغوية وخصّص مكانةً هامةً لعلم الدّلالة (السميولوجيا) في قراءته للتقليد المعرفي الإسلامي الوسيط.
ما نخلُص إليه هو أنّ البناء الفلسفي العربي المعاصِر كان أساسًا من نتاج الأدباء والمؤرّخين وعلماء الاجتماع وكتاب الإسلاميّات، أمّا الفلاسفة الأكاديميون فمالوا إجمالًا إلى تاريخ الفلسفة ترجمةً وتقديمًا وتلخيصًا من دون إبداعٍ حقيقيّ في الغالب. ولا شكّ أنّ الثغرة الكبرى في الإنتاج الفلسفي العربي في جوانبه المُختلفة هي العجز عن الإسهام الفاعل في السرديّة الفلسفية الكوْنية والاحتماء بإشكالات وهموم الذّاتية الخصوصيّة والهوية الحضارية والقومية.
(خاص "عروبة 22")