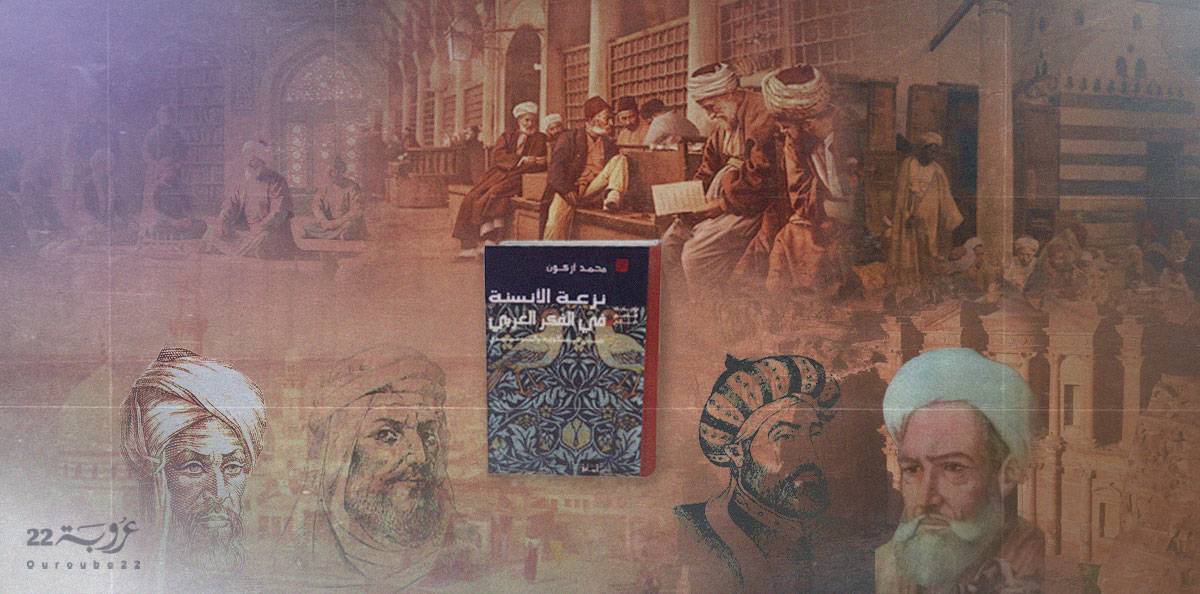تميّز ذلك العصر البعيد بقيمٍ إنسانيةٍ رفيعةٍ في التعايش والنّهم المعرفي، الأمر الذي جعل محمد أركون يصف هذه الحالة بـ"نزعة الْأَنْسَنْة في الفكر العربي"، مع تركيزه في هذه الدراسة التأسيسية على "ابن مسكويه" و"أبو حيان التوحيدي" وأترابهما، فمَن يُلاحظ هذه الفترة سيجد أنّ الوحدة السياسية أصبحت أثرًا بعيدًا. وعلى الرَّغم من ذلك، تحوّلت المدن الحضرية الكبرى إلى مراكز حضارية لا تعرف الحدود، ولا تردّ قادمًا يبحث في مكتباتها، ويُنتج ويُبدع بين معاهدها. كانت حرّية البحث والتفكير والرّغبة في الفهم لا الحكم هي الحاكمة، لذا نرى مجالس العِلم في بغداد والبصرة والري ونيسابور وأصفهان والقاهرة وقرطبة، عامرة بعلماء من مختلف المشارب يتجادلون ويتناقشون في روحٍ علميةٍ رائعةٍ وبوسيطٍ عربيّ، إذ كانت العربية هي لغة العِلم وقتَذاك.
العصر السعيد ثقافيًا شهد مناظرة شهيرة في تاريخ الفكر العربي كاشفة عن المناخ العلمي في بغداد العباسية
المُناخ الحضاري والثقافي في عالم الحضارة العربية الإسلامية، كان من الانفتاح وقبول الآخر، والحرص على سماع الأفكار ومناقشتها لا محاكمة أصحابها، لدرجةٍ تجعلنا نسأل الآن: كيف أصبح مُناخ العرب المُعاصرين قائمًا على قيم الانغلاق والكراهية والتقليد الأعمى والرغبة في الحكم على الأشخاص لا مناقشة الأفكار في جوٍّ من اتساع الأفق؟ فهل نتخيّل مثلًا أنّ الكثير من المُفكّرين ناقشوا شخصيةً بحجم أبي بكر الرازي، أكبر طبيب في العصور ما قبل الحديثة على الإطلاق، في بعض آرائه الخاصة بإنكار النبوّات، ولم يجرؤ أحد على التعدّي عليه، بل إنّ رافضي مقولاته اعترفوا له بالتقدّم في الطب الجسماني، قبل أن يردّوا على آرائه في الطب الروحاني، ويفنّدوها بالدليل والحجّة في إطارٍ من الاحترام والتقدير.
إذا نظرنا إلى بلاط الأمير سيف الدولة الحمداني (حكم 333- 356هـ/ 944- 967م)، سنجد لوحةً من اللوحات البديعة لذلك العصر، ففي البلاط تواجد "أبو الطيب المتنبي" شاعر العربية الأكبر، والشاعر "أبو العباس النامي"، و"ابن خالويه" و"ابن جنّي" وكلاهما من كبار علماء النحو، و"الفارابي" الفيلسوف الكبير مؤسس الفلسفة العربية، و"أبو الفرج الأصفهاني" (صاحب كتاب الأغاني) الغني عن التعريف، وغيرهم من العلماء وكبار المثقّفين في مختلف مناحي المعرفة حينذاك. وهو مُناخٌ نجده في بلاط مختلف أمراء العواصم الحضارية التي وصلت إلى ذروتِها في ذلك العصر السعيد ثقافيًا، والذي شهد مناظرةً شهيرةً في تاريخ الفكر العربي بين "أبي سعيد السيرافي" و"متى بن يونس" حول المنطق والنحو، والتي حفظها لنا التوحيدي في كتابه (الإمتاع والمُؤانسة)، وهي مناظرة كاشفة عن المُناخ العلمي في بغداد العباسية.
اللغة العربية تتجاوز كونها لغة دينية أو أدبية شعرية إلى وعاء لاستقبال المُصطلحات في مختلف العلوم
جانبٌ آخرٌ يُعلّمنا إيّاه ذلك العصر بكلّ نهضته العلمية والفكرية، أنّ اللغة العربية نجحت في أن تتجاوزَ كونها لغة دينية أو أدبية شعرية، إلى أن تتحوّل لوعاءٍ ناجحٍ لاستقبال المُصطلحات في مختلف العلوم، وقد نلقي نظرةً هنا على كتاب "مفاتيح العلوم" لمحمد بن موسى الخوارزمي (توفي سنة 387هـ/997م)، لنرى كيف تحوّلت العربية لوعاءٍ معرفيّ. إنّ هذا المُناخ هو الذي دفع بعالمٍ موسوعيّ كبيرٍ مثل أبي الريحان البيروني (توفي سنة 440هـ/ 1048م)، إلى التصريح بتفضيل العربية على الفارسية، فكتب بالأولى أعظم مؤلفاته التي جعلت جميع دارسيه في العصر الحديث، يعتبرونه أحد أكبر العقول التي مرّت بالحضارة العربية، الأمر الذي نراه يتكرّر مع عالمٍ بحجم جار الله الزمخشري (538هـ/1143م)، وهو عالم اللغة والتفسير والكلام في عصره غير مدافع.
نحن بحاجة إلى خطاب حضاريّ يُعيد للإنسان العربي كرامته ويُركّز عليه باعتباره الرّافعة لأي مشروع تنويري
ربّما نكون في حاجةٍ في وقتنا هذا إلى أن نستعيد هذه الروح التي سادت يومًا في بلاد العرب، فالنّاظر إليها الآن سيرى أنّها تحتاج أكثر ما تحتاج إلى خطابٍ حضاريّ في المقام الأول، يُعيد للإنسان العربي كرامته، ويُركّز عليه باعتباره الرّافعة لأي مشروع تنويري، وهو ما لن يتحقّق إلّا بالحديث عن مُناخ إبداعيّ منطلقٍ لا تحدّه القيود التي تُجهض العقل وتقتل الفكر. هذا المُناخ الذي يجعل من الإنسان قضيّته المِحورية، ويسعى لتحقيق سعادته على الأرض، روحٌ يجب أن تُستعاد في مدن العرب ومعاهدها العلمية، لا خدمة السلطان، هذا إذا كنا نريد أن نلحقَ بالعصر الذي نعيش فيه، وهي روحٌ تتطابق مع ما عرفته بلادنا ذات يوم.
(خاص "عروبة 22")