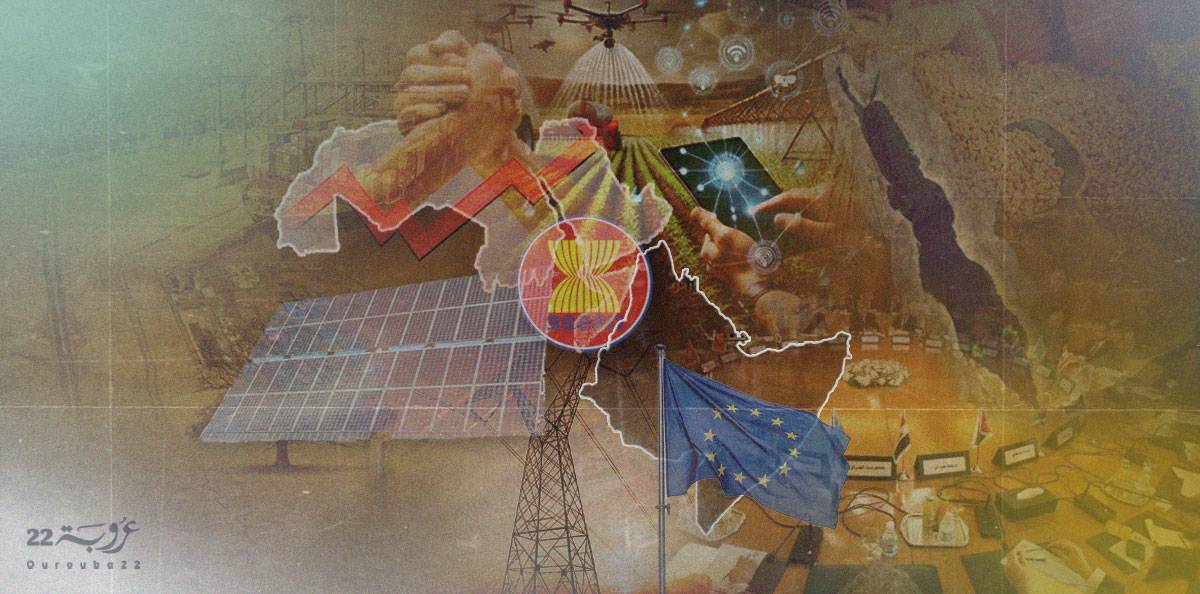الخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن (Nicholas Stern)، الذي ترأس مراجعة الاقتصاد المناخي الشهيرة لحكومة المملكة المتحدة، أكّد أنّ "الاستثمار في العمل المناخي الآن أقلّ كلفةً من دفع ثمن التقاعس لاحقًا، سواء من حيث الخسائر الاقتصادية أو المخاطر الجيوسياسية". هذا المبدأ يصلحُ كإطارٍ مرجعيّ للعالم العربي، حيث لا تحتمل البنية الاقتصادية دفع أثمان التأخير والتجزئة.
وإذ تتسارع وتيرة الجفاف في المغرب، وتتناقص الموارد المائية في المشرق، وتتراجع القدرة الزراعية في واحات الخليج، فإنّ الفرصة سانحة لإعادة تشكيل نموذج التعاون العربي استنادًا إلى التكامل في مصادر الطبيعة المتجدّدة: الرياح في شمال أفريقيا، والشمس في شبه الجزيرة، والمياه في أعالي النيل وبلاد الرافدين. وبدلًا من الاستجابات القُطرية المتفرّقة، يمكن بناء شبكاتٍ عربيةٍ للطاقة المتجدّدة تتيح تبادل الفائض والطلب، وتحقيق أمن غذائي وطاقوي ومائي مشترك.
مواجهة التحديات تحتاج إلى مقاربة جماعية تُعيد تعريف العلاقة بين الجغرافيا والمصير المشترك
ولا يقتصر الأمر على وفورات الموارِد، بل يمتدّ إلى خلق بنية اقتصادية أكثر مرونةً واستقلالًا. إذ يمكن أن تتحوّل تجربة "الربط الكهربائي العربي" من سلسلة اتفاقاتٍ ثنائيةٍ متفرّقةٍ إلى مشروع إقليميّ متكامل، تتكامل فيه القدرات الإنتاجية، وترتفع فيه كفاءة الاستهلاك، ويُعاد فيه توزيع الفائض من الطاقة المتجدّدة بطريقةٍ تُراعي العدالة والجدوى الاقتصادية في آن.
وفي هذا السياق، يُذكر أنّ الاقتصادي الأميركي بول كروغمان (Paul Krugman) قد شدّد على أنّ "الأسواق الإقليمية المتكاملة ليست فقط أكثر مرونةً، بل أقلّ عرضةً للاهتزاز في أوقات الأزمات العالمية"، وهو درس بالغ الأهمية في لحظةٍ تتقاطع فيها الهشاشة البيئيّة مع تقلّبات الإمداد.
إنّ التحدّيات المُناخية التي تواجه الدول العربية لا تعرف حدودًا جغرافيةً، وبالتالي لا يمكن مواجهتها بأدواتٍ سياديةٍ تقليديّة. بل تحتاج إلى مقاربةٍ جماعيةٍ تُعيد تعريف العلاقة بين الجغرافيا والمصير المشترك، وتُعيد إحياء المبدأ الذي أرساه الاقتصادي الفرنسي الشهير توماس بيكيتي (Thomas Piketty) أنّ "المشكلات العالمية لا تحلّها الحلول الوطنية".
الأمن الاقتصادي لا يتحقّق بالاكتفاء الذاتي الأحادي بل ببناء شبكات تكامل قوية ومرنة ومرتبطة مؤسّسيًا
من جهةٍ أخرى، كشفت الأزمات المتوالية، من الجائحة إلى حروب أوكرانيا وغزّة وإيران، مرورًا بالتوتّرات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحروب التجارة، عن هشاشةٍ مقلقةٍ في سلاسل الإمداد العالمية. والدول العربية، التي راهنت طويلًا على العَوْلمة والأسواق المفتوحة، وجدت نفسَها أكثر انكشافًا من أي وقتٍ مضى، مجرّدةً من أدواتٍ فعّالةٍ للحماية أو التكيّف. هنا يعود التكامل إلى الواجهة، لا كشعارٍ، بل كضرورةٍ استراتيجيةٍ تُمليها التحدّيات. لماذا لا تُنشأ مناطق لوجيستية عربية مشتركة على امتداد موانئ البحر الأحمر والمتوسط والخليج؟ ولماذا لا يُعاد النظر في خريطة الإنتاج العربي، بحيث تتوزّع القدرات الصناعية والزراعية والخدمية وفق المزايا النسبيّة لكلّ دولة، بدلًا من ازدواج الجهد والتكلفة وتكرار الهياكل الإنتاجية؟!.
لقد أثبتت التجارب الدولية أنّ الأمن الاقتصادي لا يتحقّق بالاكتفاء الذاتي الأحادي، بل ببناء شبكات تكامل قوية، مرنة، ومرتبطة مؤسّسيًا. وعلى الرَّغم من امتلاك العرب بنى تحتية متقدّمة وموانئ ومناطق حرّة ذات قدرةٍ تنافسية، إلّا أنّ غياب الربط المؤسّسي والبنية التشريعية الموحّدة يحول دون تشكيل كتلةٍ لوجيستيةٍ عربيةٍ فاعلة.
التكامل يُفضي إلى توسيع السوق وتعزيز انتقال التكنولوجيا ورفع إنتاجيّة عوامل الإنتاج الكليّة
وفي هذا السياق، تقرّ الأدبيات الاقتصادية الكلاسيكية والمعاصِرة بأنّ التكامل ليس ترفًا، بل ضرورةً لتحقيق النموّ المُستدام. فقد أرسى ديفيد ريكاردو (David Ricardo) في نظريّته حول الميزة النسبيّة، مفهوم المكاسب المتبادلة الناتجة عن التخصّص والتبادل، وهي فكرة تتجلّى بوضوحٍ في البيئة العربية المُتباينة من حيث الموارد الطبيعية، ورأس المال، واليد العاملة. ولاحقًا، جاء نموذج "هكشر - أولين" ليُعمّق هذه الرؤية، موضحًا أنّ التجارة تنشأ نتيجة اختلاف وفرة عوامل الإنتاج، ما يجعل من تكامل دولةٍ كثيفة العمالة مثل مصر مع دولٍ غنيةٍ برأس المال كالإمارات والسعودية حالةً مثاليةً لتفعيل هذه النظرية.
أمّا في أدبيات النموّ الحديث، فقد أكدت نماذج النموّ القائم على التكامل الإقليمي أنّ التكامل يُفضي إلى توسيع السوق، وتعزيز انتقال التكنولوجيا، ورفع إنتاجيّة عوامل الإنتاج الكليّة. وهو ما يُفسّر نجاح تكتّلاتٍ مثل "الاتحاد الأوروبي" و"آسيان" في تحويل التعاون الاقتصادي إلى آليةٍ لتحقيق استقرارٍ ونموٍّ طويل الأجل. وعند إسقاط هذا النموذج على العالم العربي، يتّضح أنّ سدّ الفجوة الإنتاجية لا يمكن أن يتمّ عبر أدوات طلب محليّة، بل يتطلّب تكامُلًا إنتاجيًا واستثماريًا يُعيد هيكلة النشاط الاقتصادي إقليميًا وفق أسس الكفاءة والمردوديّة.
الاستثمار المشترك في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على مستوى إقليمي، وتطوير سلاسل القيمة داخل العالم العربي، يمكن أن يُحْدِثا تحوّلًا في بِنْيَة العرض، مع الدفع بالناتج نحو مستوياته الكامنة. وهذا النوع من النموّ لا يتوقّف على الظروف الدولية ولا الفوائض العابرة، بل يؤسَّس على بناءٍ اقتصاديّ صلبٍ متعدّد المحرّكات.
التكامل العربي أصبح خيارًا وجوديًا لا مجرّد مشروع اقتصاديّ مؤجَّل
لقد أثبتت التجربة الأوروبية، خصوصًا في إدارة أزمة الطاقة والغذاء بعد نشوب حرب أوكرانيا، أنّ التنسيق الإقليمي لا يزيد من القدرة التفاوضية فحسب، بل يُفضي إلى استقرارٍ أكبر في الأسواق المحلية. وما زال العالم العربي، بثرواته وموقعه وشبكاته البشرية المُنتشرة عالميًا، يملك من المقوّمات ما يُتيح له تحقيق تكاملٍ حقيقيّ، إذا ما توافرت الإرادة السياسية المؤمنة بأنّ زمن الانكفاء قد ولّى، وأنّ أمن الدولة يبدأ اليوم من التعاون الإقليمي عبر الحدود.
كذلك، أظهرت التهدئة الأخيرة في الحرب بين إيران وإسرائيل - أيًّا كانت دوافعها أو أمدها - هشاشة التوازنات الإقليمية الرّاهنة، وأكدت أنّ لحظات خفض التصعيد لا تعني زوال الخطر، بل تُشكّل نافذةً محدودةً لإعادة ترتيب الأوراق قبل جولةٍ أخرى من الاضطراب. وقد بدت بعض الدول العربية وكأنّها "تنتظر" ما ستؤول إليه المعادلة الإقليمية، لتُحدّد تموضعها الاقتصادي والأمني، متناسيةً أنّ الفراغ لا ينتظر أحدًا، وأنّ كلفة الجمود في لحظات التحوّل قد تكون أعلى من كلفة الفعل.
في هذا السياق، يُصبح التكامل العربي خيارًا وجوديًا، لا مجرّد مشروعٍ اقتصاديّ مؤجَّل. فالعالم يُعيد بناء دوائره الإقليمية، ويُعيد تعريف مفاهيم الأمن القومي على أسسٍ من الاعتماد المتبادل والتنسيق المؤسّسي. وإذا لم تبادر الدول العربية إلى تعزيز تنسيقها في الغذاء والطاقة والدواء، فسيفرض الخارج شروطه، وستبقى المنطقة عرضةً لأزماتٍ متكرّرةٍ يتحدّد شكلها وعمقها خارج إرادتها.
(خاص "عروبة 22")