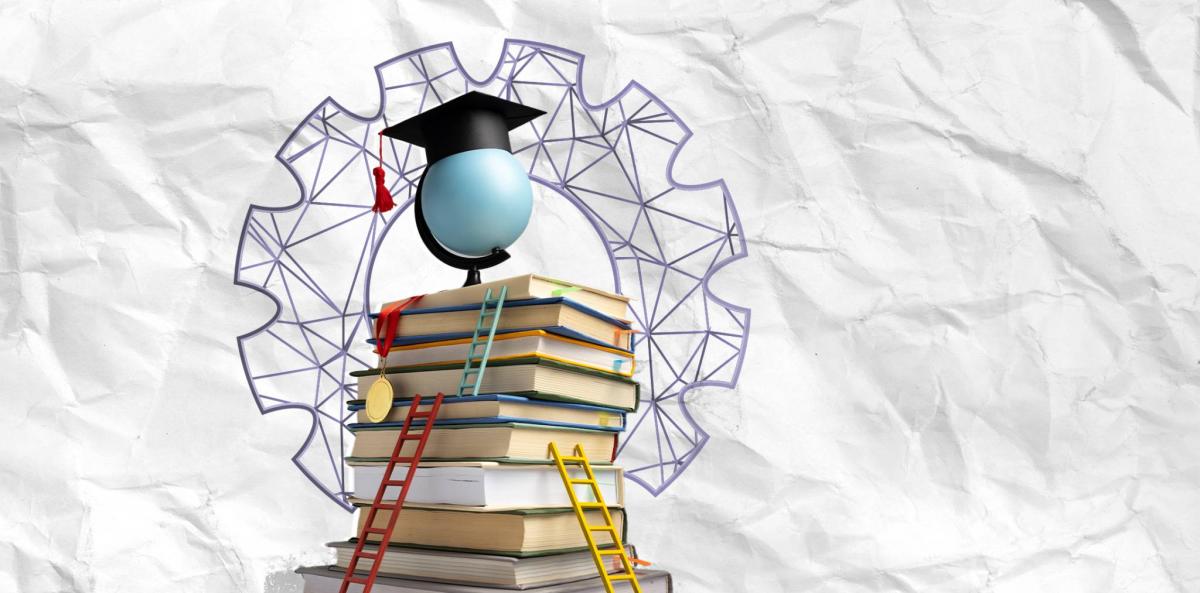أمَّا ما يسود عن مفهوم التَّعليم حاليًا، خاصَّة في واقع المجتمعات الاقتصادية التي تسيّد فيها الإنسان الاستهلاكي، فهو مفهوم مبتور عن التّعليم بالمعنى الذي نرتضيه. لأنَّ المعرفة في محتواها السياقي؛ إنّما يجري ابتكارها تلبيةً لدوافع القوة والهيمنة، ولا تلتفت إلى المعنى البنائي والتَّكويني التَّرابطي.
وإذ تعيّن هذا، فإنّنا نصرف القول إلى أننا لمَّا ننتقد هذا المنحى في التَّعليم الذي يختزل دور المعرفة في الكفاءة والفعالية والربح، فليس المقابل هو الدفاع الطائفي عن منظور اختزالي تقابلي، يستغرق الفعل التَّعليمي في تنمية الجوانب الروحية والوجدانية؛ بل إنّ المرَام المنهجي الأسنى؛ إنّما هو إعادة بناء فلسفة التعليم رأسًا؛ بتحريرها من النَّسق الإدراكي العولمي الاستهلاكي الذي تحرّكه دوافع القوة والهيمنة، وإعادة إسكانها ضمن النسق الإدراكي التوازني؛ الذي يعيد للمفاهيم المادية مكانها الطبيعي ودورها الحضاري. لأنَّ هذا النسق الإدراكي المتوازن في بنيته المعرفية والقيمية؛ لا يتتبّع دروب أولئك الذين صيّروا المؤسَّسات التّعليمية إلى مراكز استشارات ترسم المخطّطات نحو الربح والتجارة وتسليع كل شيء، لأننا نحن العرب لسنا كالغرب في سيرورتنا التَّاريخية، فنحن لم نعش تجربة التَّحديث المبنية على النطاق المركزي الاقتصادي؛ كي نستحوذ على مكاسبها الأخيرة ونسلك مسالكها، فالتاريخ والأثر في العالم، لا يكون بتقليد خطى الآخرين التي سلكوها وإنما بفتح دروب جديدة.
العقول التي تبتغي أن تتعلَّم، إذا لم تكن متشرّبة للقيم الأخلاقية فستتعثّر وتتوقّف
لنقل إذن، بأننا في امتساس الحاجة إلى تجديد أنظمتنا التَّعليمية تجديدًا يستطيع أن يتحقَّق بالتَّكوين التَّرابطي للمتعلّم، ويستطيع أن يخدم المجتمع ويرسم له معالم كي يبني عليها حركته في الواقع؛ لأنَّ للمؤسَّسات التَّعليمية، خاصة الجامعات ومراكز الأبحاث، أدوارًا ثلاثة: التَّعليم في حدّ ذاته، إنتاج البُحوث النَّوعية التي تستجيب للتحديات الواقعية، وخدمة المجتمع تكوينًا وتوجيهًا. وإنَّ شرط فعَّالية هذه الأدوار وحضورها وامتدادها، هو أن تتحقّقَ بجملة من المبادئ أو المواصفات المعرفية والأخلاقية، القادرة على إحياء ملكات التَّعليم وليس فقط حشو الأذهان بالمعلومات؛ وهي تواليا:
أولًا - التَّوجيه القيمي للتَّعليم: وهذا المبدأ يُعدّ هو الأسبق زمنيًا ومنطقيًا، لأنّ العقول التي تبتغي أن تتعلَّم، إذا لم تكن متشرّبة للقيم الأخلاقية، فإنها ستتعثّر وتتوقّف، ولن تجد الذَّات المتعلّمة في قَصَبتها المفكّرة تلك الحماسة للمعرفة، وتلك الرغبة في بناء الذّات، فالتَّعليم من غير قيم يتأسَّس عليها هو كـ"لاتعليم"؛ ولذلك بات اليوم في مناهج التعليم بما فيها المجتمعات الغربية، التركيز على ما يُعرف بالتّعليم الموجّه بالقيم، خاصة وأنّ زمننا زمن حافل بأشكال من العنف واللاتسامح والصّدام الثقافي وكسر المعايير الخلقية التي بذلت الإنسانية جهودًا كبيرة من أجل جمعها والحفاظ عليها. فزمننا هو زمن الانفكاك بين المتعلّم وبين التربية الاجتماعية؛ وزمن هذه الثورة في الإعلام والاتصال، التي أصبحت تنقل القيم السلبية وتنشر ثقافة الانحطاط بلغة فريدريش نيتشه.
تعليم التَّكامل بدل التَّجزئة والاختزال، نقتدر به على فهم المشكلات فهمًا سليمًا
جلي إذن، أنّ ذكاء العقل، إنّما يأتي دومًا من صفاء النّفس، والتلازم بينهما كالتلازم بين السمكة وماء البحر. إنّ الإقرار بقيمة التعليم الموجّه بالقيم، هو كالإقرار بأهمية تنظيف المكان قبل الجلوس فيه، أو صرف العوائق التي تحول دون تفجّر المكنونات العقلية والسلوكية، فتغييب القيم من مناهج التعليم كمن يزرع في الأشواك، فلا مغروسه نمى بطريقة سليمة، ولا حصل منه على ما يريد من ثمار، وهو الأمر في مجال التّعليم، إنّ التربية على القيم هي المرحلة التي يمكن تسميتها بــــ: ما قبل التعليم، وأثناء التعليم، وما بعد التعليم، إنها تبقى، بينما المعلومات قد تفنى أو تبلى.
ثانيًا - التَّكامل المعرفي وتعليم الثقافة: من واجبات التعليم أن يحرّك في الذات المتعلّمة جُلَّ جوانبها، كي يقتدر المتعلّم على تكوين نظرة متكاملة، والتكامل ليس مجرّد شعار إحراجي من ضيق التخصصية، بل هو بنية في العلم ذاته، ونسق للمعرفة في صورتها الكلية والنّهائية. إنّ تعليم التَّكامل بدل التَّجزئة والاختزال، نقتدر به على فهم المشكلات فهمًا سليمًا، لذا، فإنّ مسألة المفهوم الواحد والعلم الأوحد هي عوائق أكثر منها حلولًا أو آفاقًا؛ وبرامجنا التعليمية عليها أن تَبُثَّ في قلب المتلقي البنية التكاملية للعلوم، ومن أن ذواتنا مركّبة، وبالتالي فمعارفنا من اللّازم أن تكون مركّبة أيضًا، ومن العناصر التي يمكن أن تكون مرتكزًا للتكامل: تعليم الثقافة، فالثقافة ليست هي العلم، وإنما هي ذلك الإطار الذي يشترك فيه العالم، والبنّاء في نسق حياتهم وأسلوب سلوكهم، فإذا كنا نتفاضل بيننا علميًا، فإننا ننسجم ثقافيًا، ومأتى الثقافة المنسجمة، آتٍ من وحدة الرؤية إلى العالم التي تخلق الانسجام والتماثل بين الأشخاص، بوصفهما من شروط العمل الجماعي المشترك. أما ترك موضوع الرؤية إلى العالم إلى الذات الفردية وتغييبه من مناهج التعليم، باعتباره أمرًا خاصًا، فإنَّ نتيجة هذا الإقرار، أن تصبح الرؤى إلى العالم تابعة للأذواق وليس للأفكار، وهنا، نكون أمام استحالة الفعل الاجتماعي ومتانة العلاقات الاجتماعية التي هي شرط الدخول إلى التاريخ. إنّ تعليم الرؤية إلى العالم، هي المقدّمة الأولى لوحدة الثقافة وتماثل السلوك، وتعليم الثقافة بدوره يُنتج قوة في شبكة العلاقات الاجتماعية، وكلَّما كانت شبكة العلاقات الاجتماعية أقوى كلَّما كان التعليم أقوى والحركة العمرانية أظهر.
ثالثًا - من العقل المكتظ إلى العقل الإبداعي: لقد كانت الإبداعات العلمية في تاريخ المعرفة من ثمرة الاقتدار على الخيال، الذي هو طور فوق طور الواقع؛ لأنه يأتي بالجديد وبغير المعهود في المعارف والوقائع؛ وقد سمّى ابن خلدون هذا الأمر بــ: الفكر الطبيعي، الذي قابله بالفكر الصّناعي، فالتَّعليم حسبه، وإن اعتمد على الفكر الصناعي، أي مكاسب المنطق والعلوم، فإنها ستصبح هي نفسها، أي "مكاسب العلوم و المنطق"، معيقات عن إيجاد حلول لمشكلات جديدة، وهنا يرى ابن خلدون أنّ انعقاد المشكلات عائد إلى تشويش الصناعات وحُجب الألفاظ، وعليه، فإنّ جهة الحقّ إنما تستبين إذا كانت بالطبع، أي بالقدرة الفطرية، على التفكُّر والإبداع.
نرجو من المتعلّم أن يُعمل فكره وأن يجتهد بعقله
ومستلزم هذا، أنَّ الطبع أو القوى الروحية والعقلية الأصلية في الإنسان هي منطلق التفكير الإبداعي، وليست الصّناعات العلمية، وبالتالي، فإنّ تعليمنا المنشود لا يفهم فقط، أنّ المعرفة هي حشو للأذهان كما هو الحال في برامجنا، وإنّما تنميطة الملكات، لأنَّ المعارف ما هي إلا حصيلة إثارة الطبع أو الملكات الفطرية، ويمكن القول إنّ الإجراء التَّطبيقي لأجل تحقيق هذا، أن لا نكتفي بمراكمة المعارف، لأننا بهذا سَنُنْتِجُ العقل المكتظ كما يسمّيه إدغار موران؛ أو بلغة ابن خلدون حشو الأذهان؛ في حين نحن نرجو من المتعلّم أن يُعمل فكره وأن يجتهد بعقله، لا يهمّ إن كانت آراؤه صحيحة أم خاطئة، وإنّما تعويده على التفكير بذاته وتسريح فكره وأن يكون جريئًا على استخدام فكره الخاص؛ وكأن الغرض البعيد للتَّعليم إنما هو كينونة أن يصير الإنسان راشدًا. وفي هذا السياق ترى فيلسوفة المشاعر الأخلاقية الأمريكية مارثا نوسباوم في كتابها "ليس للربح"، أنّ تعليم الإنسانيات وتنمية الخيال والتفكير الإبداعي مقدّمات صلبة لأجل خلق ثقافة ناجحة.
إنّ التعليم والتربية مهمات مقدَّسة في ظلّ التحديات العالمية؛ وليس الأمر لأجل جودة التعليم، أي أن نتحقّق بالشُّروط الكمية، كعدد المؤسسات وهيئات التّدريس، وإنما الشَّرط القمين بالنهوض التعليمي، أن نُولي الأهمية لفلسفة التَّعليم عينها، في صلتها بالرؤية إلى العالم والثقافة ومنهج التّعليم، فهذه المقدِّمات هي الأكثر أهمية، لأنها موصولة بالكيف وليس الكمّ، ببناء العقل الإبداعي وليس العقل المكتظّ.
(خاص "عروبة 22")