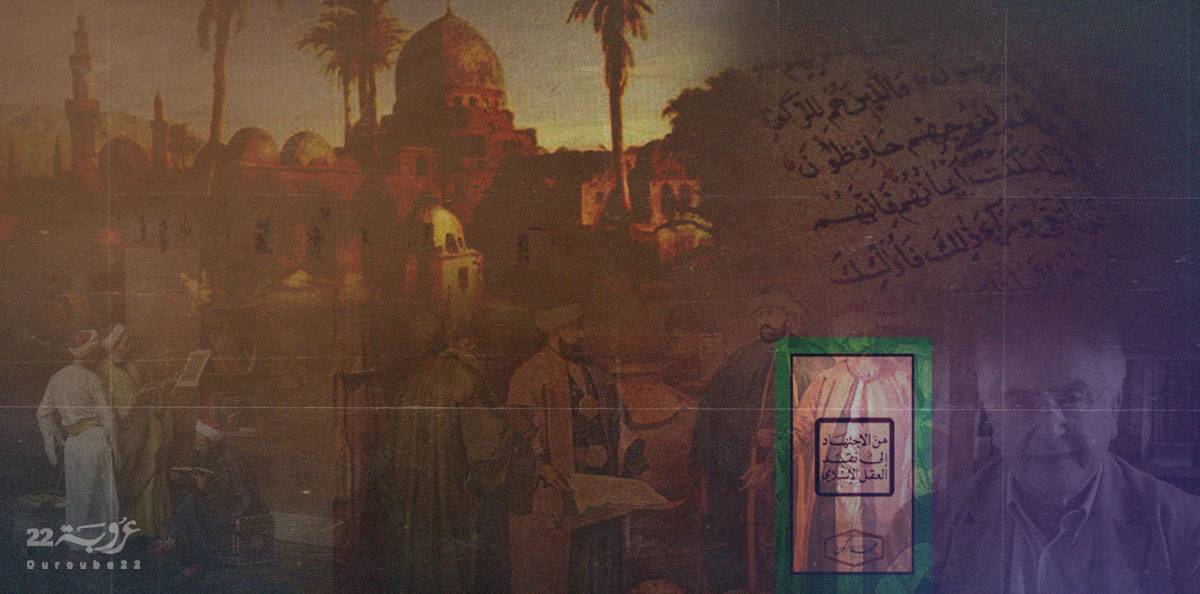كنتُ قد اكتشفتُ أعماله مبكرًا في نهاية سبعينيّات القرن الماضي، قبل أن تُترجم للعربية، وكتبت حولها بعض القراءات لاحقا. وقد بهرتني وقتها العدّة المنهجيّة والمصطلحيّة التي يستخدمها، في مرحلةٍ كانت لا تزال المقاييس اليسارية الراديكالية مسيطرةً على الفكر العربي.
كان أركون قد بدأ أوانها الاهتمام بالمسألة التراثية التي شغلت المفكّرين العرب، بيد أنّه اختار مدخلَيْن خاصَّيْن به هما؛ من جهة الدراسات القرآنية التي خصّص لها حيّزًا هامًّا من بحوثه (نُشرت في كتاب جامع بالفرنسية سنة 1982)، ومن جهةٍ أخرى النزعة الانسانية العربية الكلاسيكية كما برزت في كتابات الأدباء والمؤرّخين والكتّاب في العصر العباسي من قبيل الجاحظ وابن مسكويه وأبي حيّان التوحيدي (موضوع أطروحته المنشورة سنة 1970). كما نشر أركون في الفترة نفسها كتابًا مختصرًا عن "الفكر العربي" لا يزال، على الرَّغم من قِدَمِهِ، يُشكّل مرجعًا أساسيًا في الدراسات الإسلامية في الأوساط الأكاديمية الغربية.
اقترح خطة واسعة لإنجاز مشروعه في نقد العقل الإسلامي إلا أنه لم يُنجز إلا القليل من بنود هذه الخطة
في الثمانينيّات، بلور أركون مشروعه الفكري تحت شعار "نقد العقل الإسلامي"، وهي مقولة قريبة من عبارة "نقد العقل العربي" التي اختارها محمد عابد الجابري في الفترة نفسها إطارًا منهجيًا لأبحاثه في التراث العربي الإسلامي.
وعلى الرَّغم من أن أركون اقترح خطةً واسعةً لإنجاز مشروعه في نقد العقل الإسلامي الذي أطلق عليه أيضًا مصطلح "الإسلاميات المطبّقة" (على غرار العقلانية المطبقة لدى غاستون باشلار)، إلّا أنّه لم يُنجز إلّا القليل من بنود هذه الخطة، واقتصرت جهوده على دراساتٍ متناثرةٍ في موضوعات شتّى من الدراسات الإسلامية.
ما تميّز به منهج أركون في المباحث التراثية هو النّأي عن المُقاربات الإيديولوجية التي سمّاها "مواقف نضالية" لا قيمة علميّة لها، واستبدالها بمنهجٍ مركّبٍ يجمع بين مسالك تحليل الخطاب من المنطلقات الإبستمولوجية والدلالية والأنثربولوجية والنقد التاريخي والتأويلي على غرار ما حدث في حقل الدراسات اليهودية - المسيحية.
إلّا أنّه وإنْ كتب بعض الأبحاث حول مناهج النظر في القرآن الكريم والتقاليد المعرفية والعقدية والتشريعية الوسيطة، لم يتخلّص كليًّا من الآراء والمواقف الاستشراقية، على الرَّغم من نقده الجذري للاستشراق الغربي الذي اعتبره قاصرًا عن استخدام وتوظيف العلوم الإنسانية الراهنة.
ظلّ أركون يشكو ممّا سمّاه انغلاق السياج الدوغمائي الإسلامي وهو يعني هنا تكريس فكرة الحقيقة الأحاديّة المُطلقة ونهاية الاجتهاد العقلي وغياب النظرة التاريخية النقدية، بما يترجم موقفًا تأويليًا اختزاليًا لم يستطع اكتشاف ثراء وتنوّع التقليد التأويلي في الإسلام الوسيط (أشار إلى هذا الأمر الباحث الألماني توماس باور - Thomas Bauer في كتابه الهامّ ثقافة الالتباس).
نلمس لديه انجرافًا قويًا لأفكار التنوير والتحديث المعاصرة
كما أنّه وإنْ انطلق من الفلسفات التفكيكيّة والتاريخية المعاصِرة، إلّا أنّه ظلّ محكومًا بالقراءات الانتقائية للتراث الإسلامي، بما ينعكس في احتفائه بالنزعة الإنسانية لدى أدباء العصر العبّاسي، والمذهب الاعتزالي في خلق القرآن (الذي حمّله دلالات ونتائج لا علاقة له بها)، كما نلمس لديه انجرافًا قويًا لأفكار التنوير والتحديث المعاصرة كما برزت لدى الليبيرالية الإصلاحية العربية في بدايات القرن العشرين.
كنتُ كغيري قد استفدتُ كثيرًا من الإحالات المرجعيّة في أعمال أركون الذي كان واسع الاطلاع في الدراسات الفلسفية واللغوية والتاريخية، لكنّ أبحاثه التأويلية في القرآن الكريم والتراث العقدي والفقهي بدت لي قليلة الجدوى على الرَّغم من الهالة الكبرى التي يقدمها فيها.
منذ التسعينيّات دخل أركون بالفعل في الحقل الفكري العربي، بعد صدور ترجمات كتبه (غالبًا على يد المفكّر السوري هاشم صالح)، لكنه ظلّ محدود التأثير فيه، ربّما لإخفاقه في إنجاز المشروع الطموح الذي وعد بتحقيقه.
(خاص "عروبة 22")