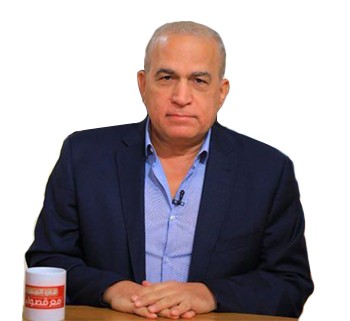لقد تحوّل الولاء إلى مبدأ ناظم للحياة العامة، حتى صار يُمارَسُ كما لو أنّه شرط وجودي للتنفّس الاجتماعي: قبسٌ للاستضاءة ونارٌ للاستجارة. بهذا المعنى، لم يعد الولاء مجرّد علاقة سياسية أو اجتماعية، بل غدا رأس مالٍ رمزيّ بالمعنى التحليلي لعالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو (Pierre Bourdieu)، يُستثمر في إنتاج المكانة والاعتراف، ويُكرَّس في إعادة توزيع القوة داخل الحقل الاجتماعي.
مأزق مرضي يتحوّل فيه الولاء إلى نوع من "العبادة" ويُنتج نمطًا من الخضوع الطوعي يُعيد تكريس السلطة
تؤدّي هذه البنية إلى تكثيف الفعل السياسي والاجتماعي في المجال العام، حيث يُصبح الولاء والطاعة آليةً أساسيةً لإعادة إنتاج الهيمنة. وهنا يلتقي منظور بورديو حول العنف الرمزي مع مفهوم الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي (Antonio Gramsci) للهيمنة الثقافية: فالولاء لا يُفرض بالقوة المباشرة، بل يُعاد إنتاجُه كوعي بديهي، وكقيمة طبيعية لا تحتاج إلى تبرير. وهكذا تتحوّل الممارسات اليومية، بما تحمله من رموز وإشارات وتعبيرات، إلى أدواتٍ لتثبيت علاقات القوة وتوسيع حضورها في المجال العام.
غير أن هذه الديناميّة تنطوي على مأزقٍ مرضي من حيث آثارها البنيوية، إذ يتحوّل الولاء إلى نوعٍ من "عبادة القوى"، ويُنتج نمطًا من الخضوع الطوعي يُعيد تكريس السلطة، ويحوّل المجال العام إلى فضاءٍ مُحتكرٍ تُعاد فيه الشرعنة على نحوٍ مستمر. وتنعكس هذه الهيمنة في مظاهرَ ملموسةٍ: فالفقر، وغياب النموّ الاقتصادي، وديمومة العنف، وتآكل الأمن الاجتماعي، كلّها تُقدَّم كأقدار محتومة أو نتائج طبيعية، لا كحصيلة بنى اجتماعية وسياسية قابلة للتفكيك والنقد.
يكشف الفيلسوف اللبناني مهدي عامل في "نقد الفكر اليومي"، أنّ ما نعيشه ونظنّه "طبيعيًّا" أو "بديهيًّا" في تفكيرنا اليومي ليس سوى فكر إيديولوجي، وأنّ مهمة المثقّف الثوري هي نقد هذه البديهيات لفتح أفق وعيٍ جديدٍ يقود إلى التغيير الاجتماعي. ويشير أيضًا إلى ما يبدو للناس "واضحًا بذاته" أو "حقيقة طبيعية"، لكنه يكشف أنّ هذا "البديهي" ليس طبيعيًا، بل هو إنتاج إيديولوجي يخدم إعادة إنتاج علاقات الهيمنة.
مثال: الاعتقاد أنّ الفقر "قَدَر" أو أنّ "الأغنياء أذكى بالفطرة". مثال الأقوال الشعبية: "اللي إله ظهر ما بينضرب عَ بطنه"، أو "المال بيجرّ المال". الفكر اليومي بالنسبة لمهدي عامل يُغذّي هذا الوعي عبر الصور والأمثال والعادات الاجتماعية بحيث إنّ الناس يَقبلون بواقعهم الاجتماعي كما هو، بدلًا من السعي إلى تغييره. ويصفه مهدي عامل بأنّه "فكر إيديولوجي عفوي" يعكس سطح الواقع، لكنّه يخفي القوانين البنيوية الأعمق. من هنا نبّه إلى ضرورة القطيعة مع الفكر اليومي وإنتاج معرفة علمية حقيقية بالواقع تقتضي تجاوز الفكر اليومي، ونقده، وفكّ ارتباطنا بـ"البديهيات" المُهيمنة، "لا يتغيّر شيء باستبدال المُطلق بالمُطلق، فمن موقعه ينظر الفكر في التاريخ، ويختلط الأبيض بالأسود، سواء بسواء، تُلغى الأضدّاد ويبقى القدسيّ، العدم، المُطلق".
الولاء في السياق العربي
في الكثير من المُجتمعات العربية، يُلاحظ أن الولاء الحزبي أو الطائفي يُشكّل شرطًا أساسيًا للاندماج الاجتماعي والسياسي. فالمواطن يُقاس حضوره وفاعليته في المجال العام بمقدار ما يعلن من ولاءاتٍ ويُظهر من تبعيةٍ لمرجعيّات دينية أو حزبية أو زعاماتٍ محلية. في لبنان مثلًا، يُترجَم ذلك في العلاقة بين الولاء الطائفي والحصول على الخدمات الأساسية، حيث تصبح الرعاية الصحية والتعليم والعمل مرتبطةً بشبكات زبائنيّة - طائفية تفرض الولاء مدخلًا ضروريًا للعيش. وفي العراق، يظهر الولاء الحزبي - الميليشياوي كشرطٍ للأمن الشخصي وللوصول إلى الفرص الاقتصادية، ما يجعل الولاء أكثر من مجرّد خيار سياسي، بل ضرورة حياتية.
من منظور سوسيولوجي، يمكن القول إنّ هذه الحالات تمثّل تطبيقًا عمليًا للعنف الرمزي البورديوني، إذ يتحوّل الولاء إلى شرطٍ موضوعيّ لإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية، بينما يُقدَّم للناس كخيارٍ طبيعيّ أو كقدرٍ محتوم. كما أنّها تُجسّد الهيمنة الثقافية بالمعنى الغرامشي، حيث تُعيد القوى السياسية صياغة البديهيات اليومية بما يخدم استمرار سلطتها، وتُحوّل علاقات القوة إلى علاقات رضوخ طوعي.
دراسة الولاء مدخل أساسي لفهم العلاقة بين الاجتماع والسياسة وبين المجال العام والهيمنة
إنّ تحليل الولاء كآليةٍ للهيمنة يكشف عن البنية العميقة للعلاقات الاجتماعية في العالم العربي. فالمسألة لا تقتصر على الانقسامات السياسية أو الطائفية، بل تتعلّق بكيفية تحويل الولاء إلى رأس مالٍ رمزيّ يُستثمر لإعادة إنتاج السلطة وتثبيت حضورها في الحياة اليومية. وهذا ما يجعل من دراسة الولاء مدخلًا أساسيًا لفهم العلاقة بين الاجتماع والسياسة، وبين المجال العام والهيمنة، وبين البديهيات اليومية وآليات السيطرة البنيوية.
وهنا لا بدّ من الرجوع إلى ابن خلدون الأعرَف بعقلية الفعل السياسي العربي: "اعلم أنّ كلّ رياسة لا تكون بالعصبية فسرعان ما تنقطع وتزول، لأنّ الغلب إنّما يكون بالعصبية، والعصبية إنّما تكون من النسب، أو ما في معناه من الولاء. فإذا تلاشت العصبية، انقطع الغلب، وزالت الدولة".
هذا الاقتباس يكشف أنّ العصبية عند ابن خلدون ليست مجرّد رابطة دم أو نسب، بل يمكن أن تتشكّل أيضًا عبر الولاء (كما في الولاء السياسي أو الطائفي أو القبلي). السؤال الأهم: متى تتحرّر شعوبنا من عقلية الولاء والطاعة؟.
(خاص "عروبة 22")