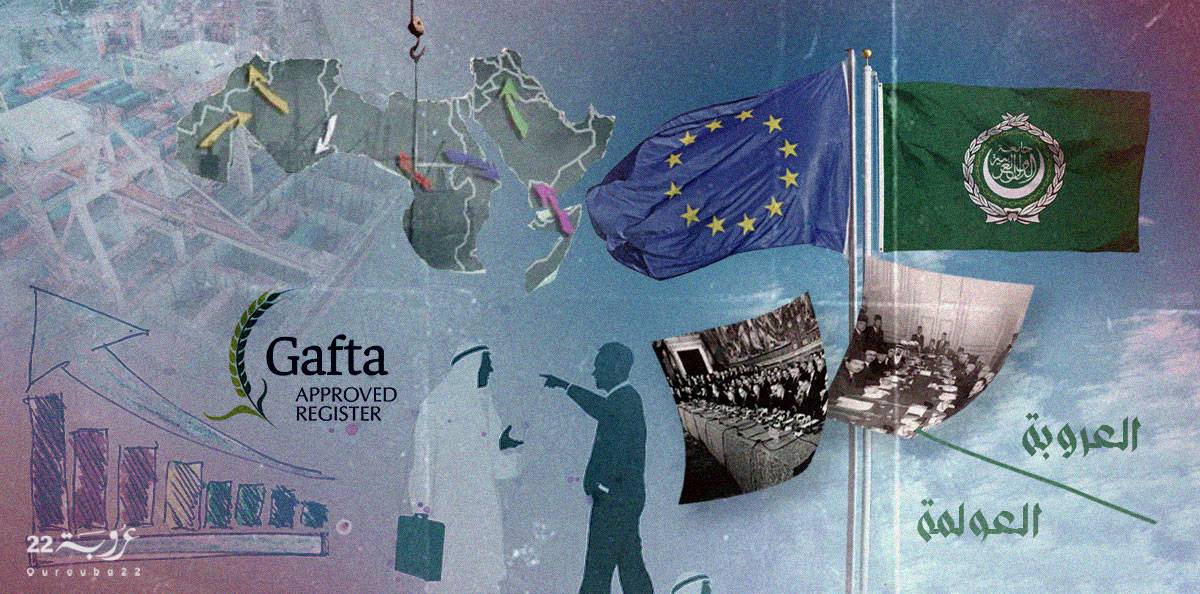هناك مفارقة كبرى في الموضوع، وهي أنّ البلدان العربية انطلقت في إنشاء العديد من الهياكل والتنظيمات في سبيل الاندماج الاقتصادي (إدارات، وكالات، مؤسسات، برامج، اتفاقيّات تجارية، شراكات وتعاون)، لكن من جهة أخرى لم يتحقّق إلّا القليل من الاندماج بين البلدان العربية والدليل هو حجم التبادل التجاري بينها، تصديرًا واستيرادًا، الذي لم يتجاوز 14 بالمئة ما بين 1990 و2018.
البلدان العربية لا تستفيد من مزايا التقارب الجغرافي والثّقافي التي تجمعها
لا يتجاوز حجم التبادل التجاري داخل المنطقة العربية 10 بالمئة من النّاتج المحلّي. هذه النسبة ترتفع إلى 15 بالمئة في حالة سوريا والأردن كدولتَيْ عبور إلى العراق، ولبنان للمرور إلى سوريا والأردن. بينما في حالة المنطقة المغاربية تنخفض النّسبة الى 5 بالمئة من التجارة المغاربية.
معلوم أنّ إقامة المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرّ (GAFTA) التي تضم 19 دولة عربية من 22 دولة، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 2005، رفعت نسبة التجارة البَيْنِيّة إلى 147 بالمئة بالنّظر إلى التقارب الجغرافي واللّغوي والثّقافي والتاريخي والاقتصادي بين اقتصاديّات المنطقة. لكنها عرفت تراجعات من عدّة أطراف مشارِكة تمثّلت في سحب منتجات وشكاوى من عدم الاستفادة الضريبيّة من منطقة التبادل الحرّ، بل منذ 2011 انعكست النّزاعات في المنطقة سلبًا على تنفيذ الاتفاقية.
ليس هذا وحسب، وعلى الرَّغم من أنّ الجغرافيا تُشكّل العامل الأساسي في الاندماج الاقتصادي حسب الأدبيّات البحثية المتخصّصة في الاندماج الاقتصادي الرّاسخة، إلاّ أنّ البلدان العربية لا تستفيد من مزايا التقارب الجغرافي والثّقافي التي تجمعها، حيث إنّ ثلثَيْ الصادرات المغاربية نحو بلد عربي تذهب لبلد مغاربي آخر، وثلاثة أرباع الصّادرات الخليجية تتمّ داخل منطقة الخليج العربي، بينما ثلث الصادرات المشْرقية تتّجه نحو بلد مشرقي عربي، مع الإشارة إلى أنّ كلّ هذه التبادلات حجمها ضعيف. ولهذا، لا تستفيد بلدان المنطقة العربية من التقاربات الجغرافية واللّغوية والثقافية والدينية والاقتصادية التي تجمعها.
تكاليف التّجارة عوائق الاندماج
خلُصت أدبيّات البحث حول الاندماج الإقليمي في المنطقة إلى أنّ تكاليف التجارة البينية تبقى مرتفعةً وتُشكّل عائقًا أمام ازدهار التجارة العربية البنيية وهي تكاليف جمركية وبيروقراطية مُرهقة وغير مُحفِّزة للتبادل.
كما تمتاز المنطقة بِثِقَلِ الإجراءات البيروقراطية، وغياب الشفافية في العمليات الجمركية ونقل السلع، وتعقُّد إجراءات النقل، وعدم احترام الآجال وتدنّي جودة الخِدمات اللوجستيّة، إضافةً إلى أنّ التكاليف الجمركية تبقى مرتفعةً، على الرَّغم من أنّ الحقوق الجمركية للتبادلات البينية العربية تمّ خفضها ما بين 2000 و2020 بحيث بلغت 6.7 بالمئة، في حين تبقى الحماية الجمركية من السّلع الآتية من خارج العالم العربي مرتفعة.
من جهتها، تبقى القيود غير الجمركية عاملًا أساسيًّا مُعيقًا للتجارة البينية وهي تتشكّل من التراخيص، الممنوعات التجارية، الكوطات، العوائق التقنية للتجارة، المعايير المختلفة (صحية وتقنية وتفتيشية، مراقبة الجودة والسعر)، مستوى الأمان في العقود، والتدخّلات الحكومية التميُّزية، ونضيف فوق هذه المؤشرات السلبيّة أن المنطقة العربية تمتاز بأنّها المنطقة الأعلى في العالم من حيث القيود غير التعريفية الجمركية (البنك الدولي 2017، منظمة التعاون والتنمية 2018). كما أنّ غلْق الحدود البريّة يُخفِّض بقوة إمكانات التبادل التجاري بين دول المنطقة (المغرب والجزائر مثلًا).
العروبة تقتضي التخلي عن بعض من مقتضيات العولمة
يعيش العالم العربي في مرحلة محدّدة من العوْلمة الاقتصادية وهي مرحلة تعدّد الاتفاقيات الإقليمية مع مناطق مختلفة من العالم منذ 1995 مع ميلاد الشراكة الأورو - متوسطيّة وباقي الشراكات مع الولايات المتحدة والصين وسنغافورة، في مقابل ضعف الاندماج الإقليمي العربي ممّا يشكل مسارات متناقضة؛ من جهة مسار الاندماج مع العوْلمة وما يترتّب عليه من التزامات، ومن جهة أخرى مسار الاندماج الإقليمي العربي (العروبة الاقتصادية) الذي له متطلباته والتزامات مختلفة. وهذه مفارقة أخرى يمكن الاصطلاح عليها بمفارقة الجمْع بين العروبة والعوْلمة، حيث إنّ العروبة تقتضي التخلّي عن بعضٍ من مقتضيات العوْلمة، والحال أنّه لا يمكن الجمع بينهما من دون تكلفة ومن دون التضحية بمنافع العروبة أو منافع العوْلمة في آن.
معضلة التنازل عن السيادة المحلية في مقابل الاندماج الإقليمي
إذا أردنا أن نرى الصّورة كاملةً حول الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي نتحدّث عنه، علينا الرجوع إلى أهم نظرية للاندماج الاقتصادي (الاقتصادي المجري بيلا بالاسا، نظرية الاندماج الاقتصادي 1961)، والتي تشرح لنا كلّ المراحل التي تمرّ الوحدات الجغرافية الاقتصادية المنفصلة حتى تصلَ إلى وحدة اقتصادية نقدية، حيث تمر البلدان التي تسعى إلى الاندماج بخمس مراحل، تبدأ بإقامة منطقة للتبادل الحرّ، ثمّ الاتحاد الجمركي، وبعد ذلك السوق المشتركة، ثم الانتقال إلى الاتحاد الاقتصادي، وأخيرًا الاتحاد الاقتصادي والنّقدي.
يتطلّب الانتقال عبر هذه المراحل الخمس من الحكومات التنازل عن السيادة الاقتصادية المحلّية وتفويضها إلى هيئات إقليمية مثل المفوّضية الأوروبية في حالة الاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى آخر مرحلة من الاندماج الاقتصادي في 1989 بقيام الاتحاد النّقدي عبر خلق عملة اليورو المشتركة (أنظر أبحاث روبرت فرانك، 2004).
الخوف على السيادة الوطنية هو الذي كان وراء نهاية مشروع الجمهورية العربية المتحدة
هذه هي المعضلة الكبيرة أمام البلدان العربية التي لم تستطع تجاوزها حيث تتمسّك كل دولة بسيادتها ومصالحها الوطنية وتخشى عليها في حالة الاندماج العربي وهي مُحقّة. وهذا الخوف على السيادة الوطنية هو الذي كان وراء نهاية مشروع الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) ما بين مصر وسوريا. وهذا التمسّك بالسيادة المحلية هو الذي يفسّر أنّ الاندماج الإقليمي العربي توقَّف عند مبادرات التبادل الحرّ البيني العربي. وهناك استثناء عربي واحد هو قيام الامارات العربية المتحدة، بعد تخلّي الإمارات المختلفة عن سياداتها المحلّية لصالح سيادة واحدة للإمارات المتّحدة من خلال مجالس وهيئات مقرّها أبو ظبي.
(خاص "عروبة 22")