ينكأ الجدل الدائر في مصر حول تلك القضية جراحًا عميقة، بقدر ما يثير تساؤلات موجِعة، سبق أن طرحها المفكّر الكبير الرّاحل الدكتور فؤاد زكريا، في كتابه الأشهر "خطاب إلى العقل العربي" الصادر في نهايات عام 1987، وما سجّله فيه من تحفّظات تجاه تلك المسألة، إلى جانب ما طرحه من أسئلة مُلِحّة في حينها، حول مدى قدرة المؤسسات البحثيّة العربية، على تعريب ذلك الفيْض الهائل من الأبحاث التي تنتجها الدول المتقدّمة علميًّا وبمعدلات متزايدة.
إذ كان زكريا يرى بوضوح أنّ حركة التعريب القديمة، التي بلغت ذروتها في العصر العبّاسي، تمّت في إطار تفوّق عربي كاسح، في وقت كانت تعاني فيه الشعوب التي قمنا بنقل ثقافتها من تدهور شامل، بلغ حدّ أنّ واحدًا منها لم يكن باستطاعته أن يكون ندًّا للأمة العربية، التي كانت صاحبة الكلمة العليا في تلك المرحلة من تاريخها، ذلك أنّ حركة التعريب التي تتمّ في ظلّ السيادة والتفوّق ـ حسبما يرى زكريا ـ تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تتمّ في ظروف التراجع والانهزام، وهي الظروف عينها التي تُميّز الموقف العربي الرّاهن إزاء الحضارة الغربية، وتشكِّل في حقيقتها فوارق بالغة الأهمية ينبغي الانتباه لها، عند عقد أيّ مقاربات بين حركة التعريب الحالية، ونظيرتها في عهد الخليفة المأمون.

تُضفي حقائق الواقع العربي المرير، في نظر الكثير من المعارضين لهذا التحوّل، سمات لا ينبغي تجاهلها، إذا ما تعلّق الأمر بعودة الحديث عن حركة التعريب في عصرنا الراهن، بل إنّها تفرض عليها حدودًا ربما لا يمكن تجاوزها، سواء فيما يتعلق بمستوى التعليم العام أو التعليم الجامعي، ومن بعدهما المستويات العليا من البحث العلمي المتخصّص، الذي يُعدّ حسبما ترى الدكتورة منى عبد الوارث، أستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب - جامعة المنوفية، أحد أبرز التحديات التي تواجه العرب في القرن الحادي والعشرين، إذ لا سبيل أمام المنطقة العربية، إذا ما أرادت التواصل مع العالم المتقدّم، سوى الارتقاء بالمستوى البحثي والعلمي، وإتقان لغة الحوار مع الآخر، لمواكبة الثورة العلمية والبحثية، إلى جانب ثورة المعلومات التي تتميّز بالتّنامي المتسارع والمتلاحق.
وتُدلِّل عبد الوارث على ذلك باليابان التي بدأت نهضتها العلمية والتكنولوجية، بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، فشرعت في تغيير نُظُمِهَا التعليمية حتّى تتجاوب مع سوق العمل، وتمكنت في غضون نحو عقديْن من تحقيق نجاح ساحق، وإحداث طفرة نوعية علمية وتكنولوجية واقتصادية، لم تدفعها فحسب إلى طليعة الدول المتقدّمة، بل وجعلتها أيضًا قادرة على منافسة البضائع الأميركية في مختلف الأسواق العالمية. ومن بعدِها الصّين التي لجأت إلى المسار عينه مع بداية الثمانينيّات، وهي الفترة التي أطلق خلالها الرئيس الأميركي رونالد ريغان تقريره الصادِم "أمّة في خطر" (A nation at risk)، الذي يُصنَّف باعتباره أخطر وأهمّ وثيقة عن التعليم صدرت في أميركا خلال القرن الفائت.
لعبت لجنة الثمانية عشر، التي أصدرت التقرير الأميركي الصادِم، دورًا رئيسًا في الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس بوش مطلع التسعينيّات والتي حملت عنوان "أميركا عام 2000"، وخُصِّصت للنهوض بالعملية التعليمية، عبر تحقيق نظام تعليم يجعل الطالب الأميركي في المرتبة الأولى عالميًّا في العلوم والرياضيّات، والمفارقة أنّ هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها على النحو المطلوب، إذ لا تزال الصّين تُحقق تفوّقًا لافتًا على الولايات المتحدة في إنتاج البحوث العلمية وما يُسمى بـ"الدراسات عالية التأثير"، فالأبحاث الصينيّة لا تزال تُشكِّل نحو 27.2% بين أفضل 1% من الأوراق البحثية الأكثر استشهادًا في العديد من دول العالم، مقابل 24.9% من الدراسات البحثية الأميركية التي يتم الاستشهاد بها، من الناتج البحثي العالمي!.
المعضلة إذن، حسبما يرى الكثير من الخبراء، ليست في حركة التعريب، وانّما في التحديات التي يمكن أن تواجهها تلك الدعوات التي تنطلق بين حين وآخر، في العديد من البلدان العربية، ثم سرعان ما يخفت صوتها، والسبب في ذلك يرجع، حسبما ترى الدكتورة إسراء علي الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى اللغة العربية في حدّ ذاتها، والتي تُمثّل تحدّيًا لتوظيفها في تعريب التعليم، حيث يتمثّل هذا التحدّي في إدراك الفهم الشفهي للغة، إلى جانب ما يمكن وصفه بـ"ثنائية اللغة العربية"، الذي يقوم على الاختلاف في النُّطق باختلاف الدول العربية، وربّما داخل الدولة الواحدة، كما أنه يمتد أيضًا إلى آليات حركة الترجمة، فبينما تنطوي الترجمة على جميع المُمارسات والإجراءات من لغة إلى أخرى، بما في ذلك ترجمة العلوم ومصطلحاتها، يقتصر التعريب على توظيف اللّغة في فهم العلوم، وهو ما يعني وفق هذا المفهوم أنّ التعريب هو في حقيقته جزء من الترجمة كمجال للمعرفة، فهل تحلّ الترجمة المعضلة؟.
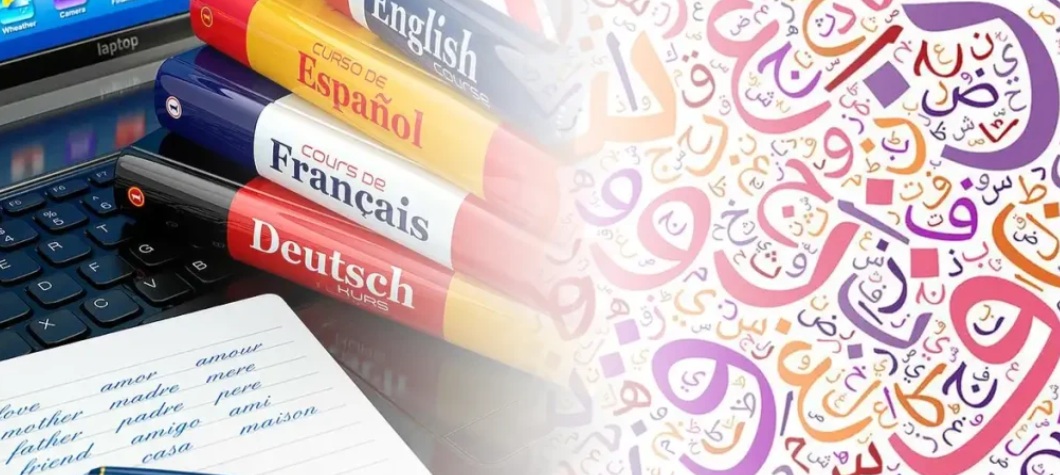
المؤكّد أنّ الإجابة لن تكون سهلة، فبحسب الكثير من الخبراء فإنَّ الكثير من نطاقات التعريب في الألفيّة الثالثة، باتت في حاجة ماسّة إلى مراجعة، وربّما إلى إعادة النظر في تطويرها، فالكثير من أنواع المصطلحات المعرّبة، انصبَّ بشكل كبير على المصطلحات العلمية إلى جانب العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية، والعلوم الدقيقة والاقتصاد والزراعة، بينما جرى إغفال الاهتمام بتعريب غيرها من المصطلحات الأدبيّة والسياسية، وهو ما يجعل من البُعد الدّلالي للمصطلحات المُعَرّبة، أحد أبرز الإشكاليّات التي تواجه حركة التعريب الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بتعريب معنى المصطلح الأجنبي، بغضّ النظر عن دلالاته، فهناك بعض المصطلحات الأجنبيّة التي تم نقلها بشكل لا يقبل الجدل كأسماء الأدوية والعقاقير، والمُرَكّبات والعناصر الكيميائية، وجميعها تُستخدم للتعبير الدلالي، وهو ما يعني بوضوح أنّ أساس عملية التعريب، ينحصِر دائمًا في النطاق الدلالي للمصطلح الأجنبي، من دون رصْد دقيق للمعنى.
(خاص "عروبة 22")






