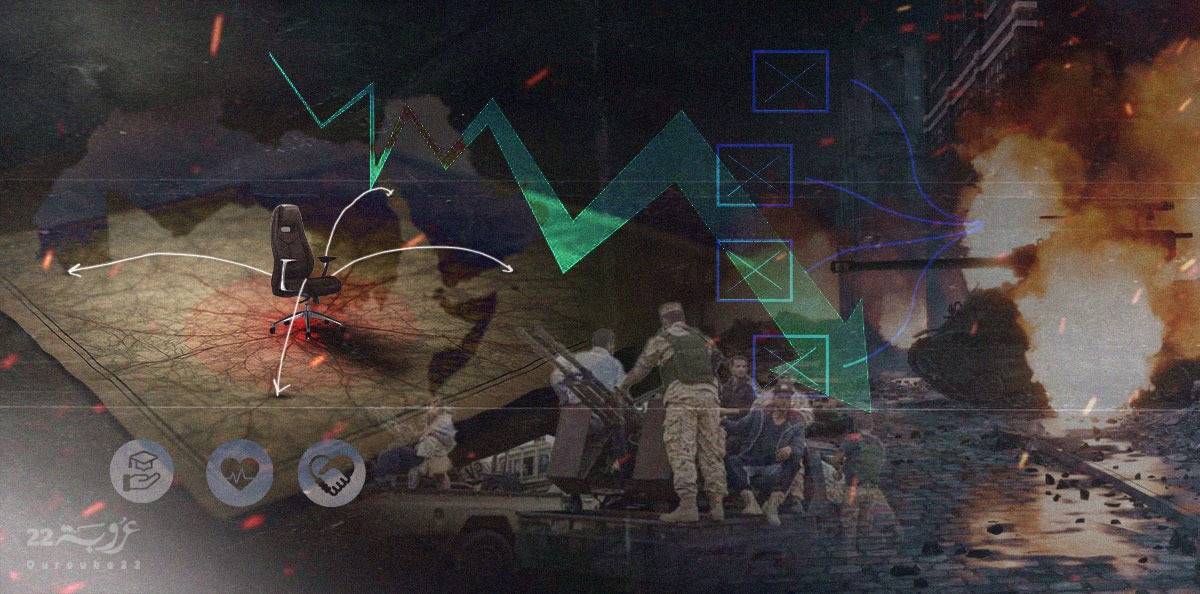انتقل هذا الاهتمام بالدولة وأزمتها إلى الدراسات العربيّة، وصدر عديد من الكتب والبحوث في هذا الشأن. ولكن شتّان بين "أزمة الدولة" في البلاد الصناعية المتقدّمة، وأزمة الدولة العربية.
ففي الحالة الأولى، تحدث الأزمة في سياق نضج مؤسسات الدولة وانخراطها في أطرٍ إقليمية وفوق وطنية، وهي أزمة تكيّف مع بيئةٍ عالميةٍ جديدة.
أزمة الدولة العربية تشير إلى مجموعة من الاختلالات البنيوية والعجز الوظيفي الذي يمسّ كيان الدولة وأساسها
أمّا في حالة الدول العربية، فتعود الأزمة إلى عدم اكتمال مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة، وعدم رسوخ الأُسُس والأركان التي تقوم عليها الدولة من شعبٍ وإقليمٍ ومؤسّسات سُلطة، بمعنى أنّ أزمة الدولة العربية تتجاوز موضوع العوْلمة لتشير إلى مجموعة من الاختلالات البنيوية والعجز الوظيفي الذي يمسّ كيان الدولة وأساسها. وهي أزمةٌ لا تقتصر على شرعية النُّظُم السياسية الحاكمة أي مدى قبول المواطنين بحقّ الحُكّام في ممارسة سلطاتهم، وإنّما تطال شرعية الدولة ذاتها أي عدم قبول الأفراد والجماعات المكوّنة لها بالاستمرار في الانتماء إليها، وسقوط التوافق الوطني بينهم، ونزوعهم إلى الانفصال عنها، أو الحصول على شكلٍ من أشكال الحُكم الذّاتي الذي يمكّن هذه الجماعات من إدارة شؤون حياتها من دون تدخّل من السلطة المركزية.
هذا الوضع شهدته عديد من الدول النّامية، وظهرت مفاهيم نظرية لدراستها مثل التحلّل السياسي، والدولة الضعيفة، والدولة الفاشلة أو الهشّة التي تشير إلى الدول التي لا تستطيع حكوماتها السيطرة على كامل إقليمها، وتفشل في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وتسودها مؤسّسات ضعيفة تُسيطر عليها أقلّيات سياسية أو إثنية، وهو ما شهدناه أو نشهده في عددٍ من الدول العربية.
في بعض الدول العربيّة سعت النُّظُم الحاكمة إلى إنكار وجود الولاءات الفرعيّة وعملت على إخمادها
الحقيقة، أنّه عندما تسود تلك السّمات - أو أغلبها - في دولةٍ ما، فإنّها تخرج عن مفهوم الدولة الوطنية الحديثة الذي يؤكّد على قيام الدولة بوظيفتين أساسيتين، هما وظيفة الاحتواء وأن تكون بمثابة الوعاء أو الإطار الجامع للمكوّنات والتنظيمات الاجتماعية، ووظيفة حلقة الوصل والرابطة بين المجتمع وقوى العالم الخارجي من دولٍ وتنظيماتٍ ومؤسّساتٍ دولية. وعندما تعجز الدولة عن القيام بهاتين الوظيفتين، فإنّها تصبح ساحةً للصراع والفوضى، ومصدرًا لتهديد شعبها والدول الأخرى، لأنّها تغدو قاعدةً للجريمة المُنظّمة والتنظيمات والميليشيات المسلّحة، وتهريب السلاح والمسلّحين إلى دولٍ أخرى.
يمكن النّظر إلى أزمة الدولة العربية من زوايا مختلفة، مثل مظاهر هذه الأزمة وتجلّياتها في الواقع العملي، والبحث في أسبابها ومصادرها التي قد ترجع إلى التكوين الاجتماعي والإثني، ودرجة الانقسامات القائمة بين المكوّنات الاجتماعية في الدولة، أو شكل نظام الحُكم ومدى مشاركة هذه المكوّنات الاجتماعية في النّخبة السياسية والاقتصادية، أو طبيعة السياسات العامّة المُتّبعة وخصوصًا تلك المتّصلة بالخدمات المباشرة للمواطنين كالتعليم والصحّة والتوظيف والرعاية الاجتماعية ومدى شمولها لمختلف المناطق والمكوّنات الاجتماعية.
تطوّرت أزمة الدولة العربية وتنوّعت مظاهرها وصبّت جميعها في تآكلٍ واستنزافٍ تدريجي لشرعيّتها
أشير بهذه الأمثلة إلى مفهومٍ جوهريّ وهو العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى نجاح الأولى في بلْورة هويةٍ وطنيةٍ جامعة، وغرْس الشعور بالانتماء إليها، متجاوزةً بذلك الولاءات والانتماءات المذهبية والدينية والطائفية للجماعات المكوّنة للدولة. وهذا هو بيت القصيد، ففي بعض الدول العربيّة سعت النُّظُم الحاكمة إلى إنكار وجود الولاءات الفرعيّة، وعملت على إخمادها والتنكيل بها بالقوّة. وفي دولٍ أخرى، تمّ "مأسَسة" هذه الانقسامات في الأطر القانونية والمؤسّسات السياسية. وكلاهما طريق مسدود، يؤدّي في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، واستمرار التوتّرات الطائفية، وضعف الهوية الوطنية وينفجر أحيانًا في شكل حروبٍ أهليةٍ سرعان ما تتحوّل إلى حروبٍ بالوكالة، ومدخلًا لتدخّل أطرافٍ إقليميةٍ ودوليةٍ لتحقيق مصالحها.
أزمة الدولة العربية هي أزمة مُعقّدة ومُركّبة، لها جوانبها وأبعادها المتنوّعة، وهي مصدرٌ للكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا العربية. لقد تطوّرت هذه الأزمة على مدى سنين طويلة وتنوّعت مظاهرها من بلدٍ لآخر، وصبّت جميعها في تآكلٍ واستنزافٍ تدريجي لشرعيّتها، وازدياد الفجْوة بين الدولة ومجتمعها.
ولنا عودة لبحث هذا الموضوع إن شاء الله.
(خاص "عروبة 22")