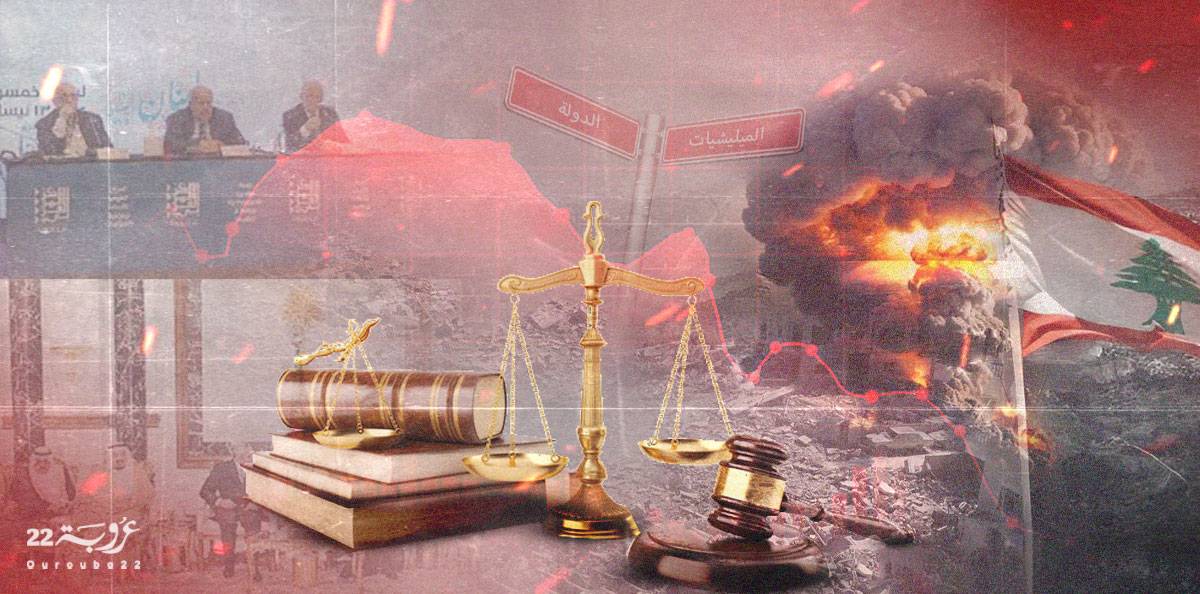تكشف خمسون سنةً العوائق التي حالت دون بناء المجتمع العادل الذي ناضل من أجله الروّاد الأوائل، وفي نقدٍ للسلطة السياسية التي لم تُعالج مفهوم الصّراع الاجتماعي القائم على محفّزاتٍ طائفيةٍ ومذهبية، ولا تزال آثارها قائمةً في تفتيت منظومات القيَم والوحدة والقانون والديموقراطية والمدن الحضرية لصالح تقسيماتٍ سياسيةٍ وديموغرافيةٍ واجتماعيةٍ جديدةٍ، وتخطيطاتٍ أكثر خطورةً في التعصّب وأشكالٍ من العنف والإحساس بالتهميش والإقصاء.
من هذا المُنطلق، انطلقت فعاليات مؤتمر "لبنان - خمسون سنة على 13 نيسان 1975"، الذي نظّمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، في فندق جفينور روتانا - بيروت، بمشاركة عددٍ من الباحثين والأكاديميين اللبنانيين والعرب، وامتدّ ليومين، خُصّصت الجلسات خلالهما لتحليل انعكاسات الحرب على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي في لبنان.
السؤال هو كيف يتأتّى للفكر العربي ربط فكرة الاستقلالية ببُعدها السياسي لتأسيس دولة القانون والديموقراطية
تصوّرات بحثيّة مُهمّة للعدالة المنقوصة في بُعدها الحداثي، والتي يحكمها احترام المُواطن اللبناني، والتوازن والاندماج داخل الجماعة، وجعل وثيقة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب قابلةً للتسويغ في المسائل التي هي مدعاة للنزاع، وتعتمد على الاتفاق حول الحُكم على مبادئ القانون الأساسية والجوهرية عندما يتعرّض لبنان للخطر مجدّدًا، وهو "أظهر تماسكه في مواجهة العدوان، ولا عودة للحرب"، وِفق ما أكّد رئيس حكومة لبنان الأسبق فؤاد السنيورة في مداخلةٍ له، في افتتاح أعمال المؤتمر، تناول فيها المقدّمات الاقتصادية والاجتماعية للحرب وما تلاها من مساراتٍ سياسيةٍ، بعد اتفاق الطائف الذي "طُبِّقَ انتقائيًا وصندوق المليارين أُجهض"، أوقعت لبنان في حلقة استعصاءٍ سياسيّ وإداريّ لا يزال يُعيق كلّ محاولات الإصلاح.
الفكرة أنّ تقرأَ تلك الحرب جيّدًا، ووضع حدٍّ نهائيّ للتلاعب بذاكرة اللبنانيين، وهي معالجة للماضي، والمصدر الذي ينهل منه المؤرّخون والباحثون أشكالًا من النّقد والمراجعة، بهدف التصويب والإغناء لسرديّات الحرب "المُملّة" وفق تعبير نائب رئيس الوزراء الدكتور طارق متري، وتجاوز ثنائية شائعة الرواية الواحدة والقبول بها، واستحالة التصالح، والحاضر كثيرًا ما يصنع الذاكرة التي لا تؤرّخ لبداية الحروب وليس إلى نهايتها، مُشيدًا بالأبحاث المطروحة، "المُتحرّرة من السلطات السياسية والإيديولوجية والتي تقارِب مناهج التاريخ والتحليل الاجتماعي".
محاولة رصد التغيّرات التي شهدها لبنان ودعوة اللبنانيين لئلّا ينجرف بلدهم في دوّامة حرب أهلية أخرى
لم ينسَ اللبنانيون شيئًا، ولم يتعلّموا شيئًا في المقابل، وحيث يبقى التاريخ اللبناني ممارسةً اجتماعيةً وبنظراتٍ قديمةٍ يغيب عنها الشباب، غير تغييرية وغير تقدّمية في تحريك البنى الديناميّة. التاريخ هو علم تطوّر المجتمعات، والسؤال الرئيسي، هو كيف يتأتّى للفكر العربي (ليس في لبنان وحده)، أن يخرج من الحروب والنزاعات الأهلية، ويُصلِح للتحرّر منها، وإقامة بنيان العدل الرّاسخ الجديد بتأسيس الأمن والطمأنينة والسعادة وطيب العيش، وربط فكرة الاستقلالية ببُعدها السياسي لتأسيس دولة القانون والديموقراطية. أي أنّ تتصرف المجتمعات باستقلاليةٍ عندما تخضع لمجموع القوانين التي يقبلها الجميع.
حسنًا فعل المركز العربي في محاولة رصد التغيّرات التي شهدها لبنان ودعوة اللبنانيين من باب التداول والحذر، لئلّا ينجرف بلدهم في التوتّرات العنيفة ويصبح مجدّدًا في دوّامة حربٍ أهليةٍ أخرى، وهو نجح بأعجوبةٍ في تلافيها.
الهدف ليس العودة إلى الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحرب والمعارك، ولا قراءة مواقف القوى التي كانت مشاركةً فيها، إنّما هو قراءة في المتغيّرات التي طاولت البنى كافّة في بيئة تطوّراتٍ إقليميةٍ وعالميةٍ، كان لها التأثير الكبير في موقع لبنان ودوره. وقد "أهدر اللبنانيون فرصًا هائلةً كان يمكن استثمارها لتعزيز دور بلدهم في مجالاتٍ مُختلفةٍ كالتعليم والخدمات والسياحة... ومن دون أملٍ كبيرٍ باستعادة هذه الفرص"، كما ورد في ورقة المؤتمر المرجعيّة لمدير المركز العربي للأبحاث في بيروت الدكتور خالد زيادة.
تناولت جلسات المؤتمر عناوين عديدةً منها التغيّرات الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد لبنان (بطرس لبكي)، اقتصاد لبنان السياسي وخضوعه لتفاعل عامل الخارج والطائفية السياسية (نجيب عيسى)، منحنيات التربية والمساءلة والتدقيق الجنائي للأحداث (سيمون عبد المسيح)، النّزوح الداخلي والهجرة (علي فاعور)، التعليم (عدنان الأمين)، الأحزاب السياسيّة (فارس أشتي)، التهجير القسري والمنهجي (حلا نوفل)، الانتقال من الأرياف إلى المدن (منذر جابر)، سرديّة الحرب (صقر أبو فخر)، ثقافة الحرب وإرثها والتكرار العقيم (محمد أبي سمرا)، تطلّعات المعرفة بلا ضفاف (زهير هواري)...
إقصاء الذاكرة يترتّب عليه عدم الاستفادة من دروس الأمس
مع ذلك، كان أثر الحرب أكبر من ذلك؛ إذ إنّ بروز ميليشيات مُسلّحة أدّى إلى تقليص نفوذ السلطة الشرعية وقواها الأمنية، ونشوء ثقافة ما بعد الحرب. خسر اللبنانيون الكثير. فكانت الدعوة للتشاور مع باحثين في جلسات وحوارات تستطيع أن تثبت أنّ الموضوعية الموسومة وعيًا يمكن أن تثبت صحّة الحقيقة التاريخيّة في صفوف الشباب وطرائقه وموضوعاته والرهانات المستقبلية، وما يكسر التحفّظ الذي يصيب العالم العربي والعالم كلّه، وسط أخطارٍ متفاقمةٍ تضع المسؤولية على الطبقة السياسية والمؤسّسات الدستورية والأحزاب والقادة والمجتمع المدني على أساس المفاهيم والقواعد العامّة للعيش المشترك.
إنّ كلّ إقصاءٍ للذاكرة يترتّب عليه عدم الاستفادة من دروس الأمس أكانت سياسية أم اجتماعية. فالدولة اللبنانية (كما بعض العربية)، دولة حديثة في مظاهرها الخارجيّة، وهي تنتمي إلى الأزمنة ما قبل المدينة في العلاقات التي يعيشها أبناء البلد (رعايا وليسوا مواطنين). هذا مهمّ لقراءةٍ مشتركةٍ في درس الحروب والنّزاعات الأهلية وصِلتها في تدمير الواقع، وصوْنًا للسّلم والأمن على الصعد كافّة، منها الوطني والإقليمي والدولي.
(خاص "عروبة 22")