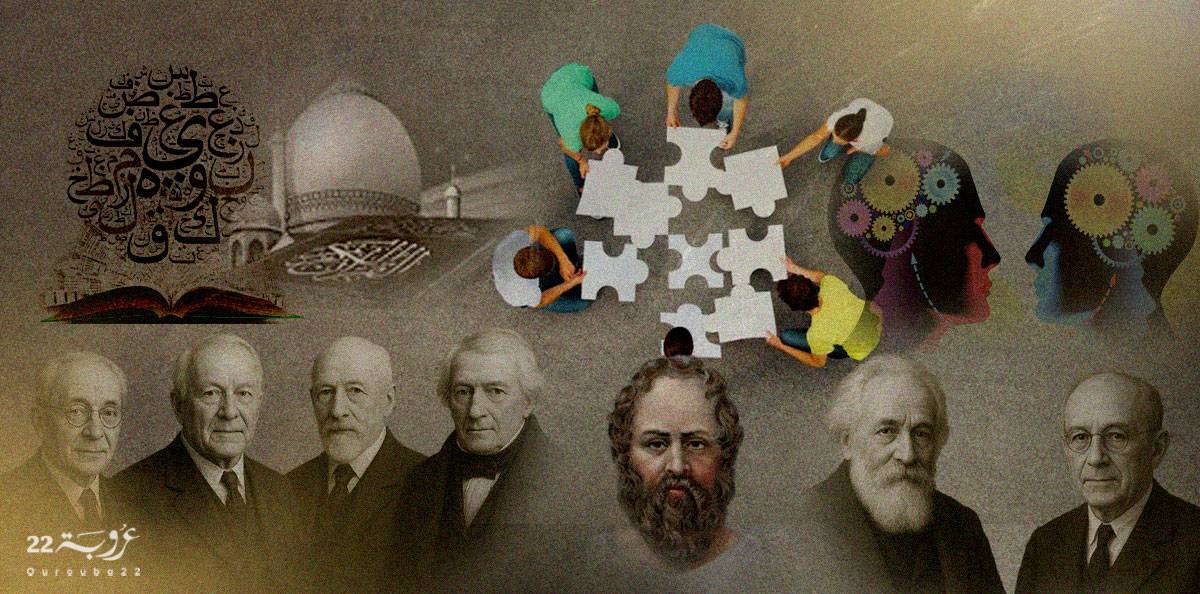المنحى الإبستمولوجي وكتابة تواريخ العلوم: وهنا، انتشرت الكتابات حول نظريات المعرفة وتواريخ المعارف العلمية وبنية العقلانية المعاصِرة والتَّعريف بفلاسفة العلم غاستون باشلار (Gaston Bachelard) وجورج كانغيلام (Georges Canguilhem) وغيرهما، وكذا تعريب كتابات نظريات المعرفة والنَّماذج العلمية وتضمينها في البرامج التعليمية؛ وهنا، لا بدّ من الإقرار بأنَّها لم تكن كتابات تأسيسيّة أو ابتكاريّة، بقدر ما هي تعريفيّة شَارحة، أو تعليميّة أو تطبيقيّة على قضايا تُلامس هموم الثقافة العربية والإسلامية. والشيء الآكد هنا، أنَّها لا تستطيع أن تكون إبداعيّة، لأنّ حركة العلوم تجري في التاريخ الغربي وليس التاريخ المُحايث لها.
المنحى التَّأويلي بمدلوله النصّي والأنطولوجي: وهذا الزَّمان، بات يعرف تقليدًا للتأويلية الغربية، بالزَّمان التَّأويلي، حيث انحصرت الفلسفة في صِلةٍ حواريةٍ مع النُّصوص بغرض استجلاب المعنى منها، وباتت الحضارة الإسلامية حضارة نصّ، يستلزم تأويلًا أو تفكيكًا أو صرفًا أو حفرًا، وحتّى إشكالات الدولة والدين والاجتماع أضحت نصوصًا يُتَلمَّسُ معناها بتطبيق مناهج النّظر التأويلي، فالثقافة نصّ والدَّولة نصّ والاجتماع نصّ وهكذا. إذًا، يمكن صرفُ القول إنَّ التَّأويليّة باتجاهاتها وأعلامها قد تسيَّدت في الوعي العربي والإسلامي، وتسيّد أعلامها تبعًا: مثل فريدريك شلايرماخر (Friedrich Schleiermacher) وفيلهلم دلتاي (Wilhelm Dilthey) وهانس غادامير (Hans-Georg Gadamer) وبول ريكور (Paul Ricœur) وغيرهم. وحتّى التأويلية الأنطولوجية كان لها حظّها أيضًا، فأصبحنا نسكن اللغة كما نسكن العلم، بخاصةٍ دروب مارتن هايدغر (Martin Heidegger) وانوجاده بين الكلمات والأشياء.
الاتجاهات الفلسفيّة في الوعي العربي المُعاصر لم تكن نُسَخًا أصلية نابعة من تربة الثقافة ومشاكل الاجتماع الذّاتي
يمكن القول، فضلًا عمّا تمّت الإشارة إليه؛ ثمّة مناحٍ أخرى مثل الاتجاه الثوري الاجتماعي، الذي أعرض عن الفلسفة في صيغتها الإبستمولوجية والتأويلية، وأخَذَ بها نحو التَّغيير والثَّورة وقلب سياسات الحكم، وكذا الاتجاه الحضاري الذي وظَّّف الفكر من أجل بناء النَّهضة واستعادة الدور التاريخي للاجتماع الإسلامي، الذي تعطَّلت حركته وتجمّدت قيمه وتغلَّب فيه منطق الغريزة والتّرف على منطق الروح والعقل.
وإذ تبيَّن هذا، فإنّنا لا نُنكر الأهميّة المنهجيّة والمعرِفيّة لهذه الاتجاهات الفلسفيّة التي سادت في الوعي العربي المُعاصر، لكنّ مدار الاعتراض أنّها لم تكن نُسَخًا أصليةً نابعةً من تربة الثقافة ومشاكل الاجتماع الذّاتي؛ بل هي نُسَخ مُقلّدة لسيرورة الوعي الغربي وإشكالاته وتحوُّلاته. وبالتَّالي، فمَن أراد أن يقرأ هذه النصوص، أو الاتجاهات؛ فليرجع إلى النُّسخ الأصلية وليس إلى النُّسخ المُقلّدة التي ينقصها الحسّ التّاريخي والخُصوصية الثقافية، فضلًا عن أنّها لا تُعاني الإبداع ولا تُكتب بدمها وروحها.
لقد آن لنا ضمن تحدّيات هذا الزّمان، أن نُفكر في فلسفةٍ تُعين الإنسان على تدبير حياته وتغيير وعيه وسلوكه؛ بخاصةٍ في الفضاء العربي والإسلامي، الذي يعيش فيه الإنسان حالة التمزّق بين الكلمات والأشياء أو بين القيم والحياة. إنّها الفلسفة بوصفها أسلوبًا في الحياة أو صيغةً من صيغ العيش، إنّها تشبه التَّطبيب الرّوحي والنَّفسي، لأنها لا تسكن في تواريخ العلوم أو في طبقات النُّصوص ولا تختزل الكينونة في حركةٍ ثوريةٍ، بل تخاطب الأنا الإنساني العميق الذي يعاني التَّخلُّف والإذلال والاحتقار والحصار الفكري والحضاري. ويمكن القول إنَّ من مقاصد هذا الخط الفلسفي الحيّ: تبديل الرؤية إلى العالم وتعديل السُّلوك من خلال حزمةٍ من الرياضات الرّوحية؛ مثل القراءة والحوار والتأمّل والعزلة الإيجابية والتذكّر وأداء الواجبات والتحرّر من الأهواء، فهذه الأفعال الرّوحية القريبة من الذَّات، هي المُعينة على تجديد التَّفلسف بوصفه صيغة من صيغ الحياة، ووسيلة ناجعة لأجل تغيير الإنسان من داخله نحو آفاق العيش الحسن وإتقان الوجود بإيجابيةٍ وتحسين التّعليم بتربية النّفس على تغليب التَّعقُّل وجودة اللغة على الهوى وانحطاط الذَّات.
البناء يقوى إذا تأسَّس على شعلة الإيمان ونداوة المعرفة واستقامة السلوك
هذا، ويُعَدُّ الفيلسوف اليوناني "سقراط" المثال الشّاهد على هذا النَّوع من العمل الفلسفي؛ فهو لم يكتب شيئًا، ليس لأنّ الكتابة لا قيمة لها من النَّاحية الفلسفية؛ وإنّما لأنّ الفلسفة هي نمط من العيش في العالم، أو هي صيغة من صيغ الوجود أكثر منها تقنيات مفهوميّة أو تعاريف منطقيّة. لقد كانت سمات العمل الفلسفي عند سقراط هي "الإنسانيّة والأخلاقيّة والإصلاحيّة"؛ تتحقَّق عن طريق الفعل الحيّ أو التّجربة، ويقوى استعمالها في المدينة ومع النَّاس أكثر، فهي أقرب إلى التصوّر الشَّعبوي منها إلى التصوّر النُّخبوي. وهكذا، فإنّ تعالُق الفلسفة والأخلاق مع سقراط، يتبدّى من جهاتٍ ثلاثةٍ أساسيّةٍ "الإنسان والإصلاح والاتّساق (أي موافقة الأفعال للأقوال)". وبهذا، يثبت أنّ الفلسفة "توجب على الفيلسوف أن يحيا حياةً أخلاقيةً؛ فصحيح فلسفته ينبغي أن يتجلّى في صالح أفعاله، وصالح أفعاله ينبغي أن يكشف صحيح فلسفته"[1]. ولأجل هذا الإقرار، عُرفت الممارسة السقراطيّة بكونها حكمة عملية، أكثر منها فلسفة نظرية.
جُماع الأمر، أنّ حاجتنا في الوعي العربي الإسلامي هي الحاجة إلى نداوة المعرفة التي غرضها تطهير الروح، كي تستعدّ للبناء، لأن البناء إنّما يقوى إذا تأسَّس على شعلة الإيمان ونداوة المعرفة واستقامة السلوك.
[1]عبد الرحمن طه، سؤال السيرة الفلسفية، بحث في حقيقة التفلسف الائتمانية، الكويت، بيروت: مركز نهوض للدّراسات والبحوث، 2023، ص 90
(خاص "عروبة 22")