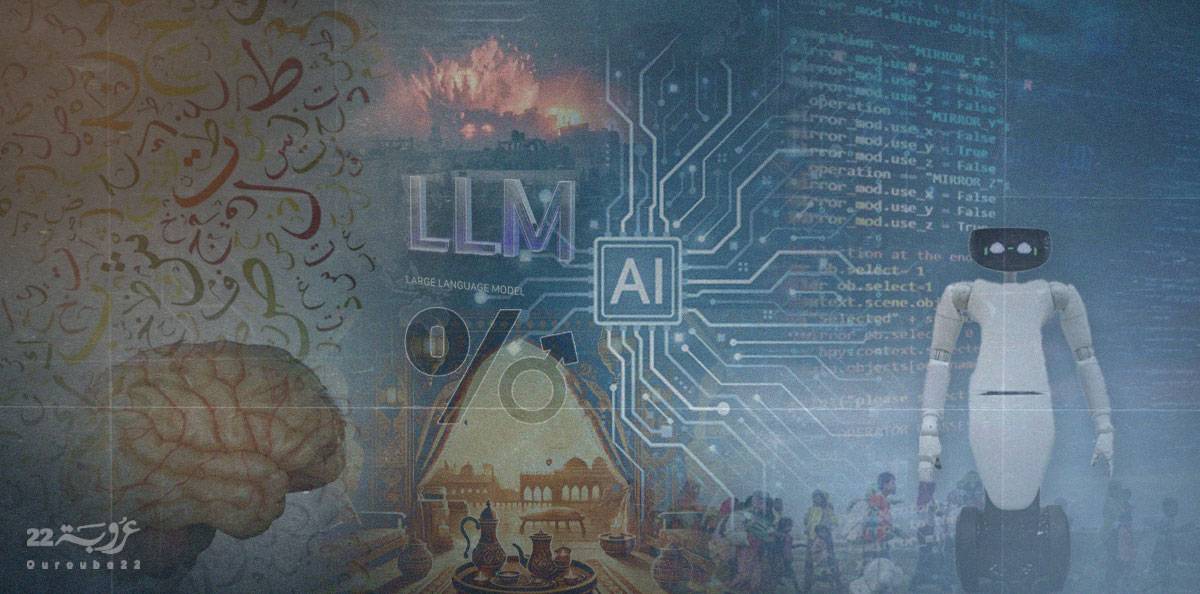إنَّ أكثر ما يُمثّل غياب العدالة بهذا المعنى هو ضعف تمثيل اللغة العربية ومنتجاتها الأدبية والفكرية والعلمية المختلفة. وغياب تنوّعنا الثقافي والجغرافي بالصورة المستحَقّة في البيانات المستخدَمة لتدريب النماذج الذكية. وبالتالي، يبرز التحيّز لصالح ثقافات أخرى على حساب ثقافتنا العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولا شكّ أنّ تغييب الثقافة يعني تغييب قيمها وقواعدها الاجتماعية، المتمثّلة في أنماط التمظهر الاجتماعي، وبناء العلاقات المجتمعيّة، والقيم التي تؤطّر السلوك البشري في البيئة العربية المحكومة بنماذج ثقافيةٍ تخصّها وترسم ملامحها من دون غيرها.
ازدياد الوعي العربي وظهور تجاوب عملي في أنشطة البحث والتطوير والتدريب والتعليم والتثقيف
على ذلك، فالهدف والطموح في هذا الشأن هو تحقيق العدالة في توزيع وتوظيف التطبيقات الذكية، بشكلٍ متوازنٍ وفعّالٍ ومستدامٍ، ما يعني المساواة في الوصول إليها، والفرص المتكافئة بين المناطق العربية وغيرها من مناطق العالم، بعيدًا عن ممارسات التهميش الخفيّ أو المركزية التقنية المُهيمنة، وضمانًا لترسيخ القوة الجيوثقافية العربية وتأثير انتماءاتها المكانيّة والثقافية على تمثيل اللغة والمعرفة في نماذج اللغة الكبيرة بشكلٍ خاص.
لمثل هذه الأسباب، يُلاحَظ ازدياد الوعي العربي شرقًا وغربًا في هذا المجال، وظهور تجاوب عملي بشأنه، يتمثّل خاصةً في أنشطة البحث والتطوير، والتدريب والتعليم والتثقيف، والمشاركات الدولية، والتعاون مع مؤسّساته الشهيرة.
من الأمثلة المهمة: أصبحت منصّة "OALL" (قائمة المتصدرين لنماذج اللغة الكبيرة العربية المفتوحة) على منصّة "Hugging Face" للذكاء الاصطناعي، تضمّ أكثر من 700 نموذج ذكي، تمّ تقديمها من قبل أكثر من 180 جهة أو مؤسّسة عربية، يعمل فيها باحثون ومهندسون ومطوّرون وفرق عربية متخصّصة.
في المغرب العربي؛ على الرَّغم من تحدّيات البنية التحتية والتمويل والدعم الحكومي، تُشير المتابعات والإحصاءات إلى عديد المشاريع الذكية التي تتبنّاها هذه الدول بالتعاون مع المؤسّسات العالمية الشهيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
حوالى 300 إلى 800 مطوّر/باحث عربي ينشطون في مجال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة
مثلًا وليس حصرًا، في ليبيا، جهات عامّة وخاصّة عدّة لديها مشاركات مع "مايكروسوفت" (Microsoft) و"أوراكل" (Oracle) و"خدمات أمازون ويب" (AWS)، لتقديم حلولٍ ذكيّة. إلى جانب مبادرات فرديّة كثيرة في برمجة الأنظمة الذكية، ومن المطوّرين مَن يعملون خارج البلاد في هذا المجال. ومنذ ألفينيّات القرن الفائت، اهتمّت ليبيا بتدريس الذكاء الاصطناعي في مؤسّسات التعليم العالي، وأنشأت أقسامًا ووحداتٍ تدريسيةً ومعامل خاصّة به في جامعة طرابلس وغيرها. كما أنّ "مجمّع اللغة العربية الليبي" له جهود توعويّة لافتة، لتفعيل اللغة العربية وتمثيلها في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ عبر محاضرات ومذكّرات تفاهم وتعاون مع بعض المؤسّسات التعليمية والعلمية في إطار اللغة العربية وخوارزميات النماذج الذكية، والمصطلحات الرقمية والفضاء السيبراني، والتنمية اللغوية التقنية... إلخ. وهناك حديث عن نموذج "LLM" ليبي (Large Language Model) سيتمّ إطلاقه قريبا.
في المغرب، يتعاون "المركز المتقدّم للذكاء الاصطناعي" التابع لجامعة محمد السادس في مشاريع بحثية ذكية مع "شركة المؤسسة الدولية للحواسيب" (International Business Machines Corporation - IBM)، و"مايكروسوفت"، في مجالات الرعاية الصحية والزراعية والتعليم...
وفي الجزائر، تعمل مراكز البحث على مشاريع التعلّم الآلي ومعالجة اللغة العربية. وهناك مطوّرون شباب يشاركون في مسابقات دولية بالخصوص، مثل التنافس عبر منصّة "Kaggle"، تحت إشراف "غوغل"، لحلّ تحديات علوم البيانات وتعلّم الآلة، وبناء النماذج الذكية القائمة على الويب...
وفي تونس، مشاريع متعدّدة في تحليل البيانات والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية. كما يوجد مطوّرون تونسيون يشاركون في مشاريع LLMs)) مفتوحة المصدر.
وفي دول الخليج العربي، هناك مبادرات عديدة؛ ففي أبو ظبي أطلق "معهد الابتكار التكنولوجي" (TII) نموذج "نور" الذكي، لمعالجة اللغة العربية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا "لايت أون" (LITEON)، وكذلك نماذج "فالكون 3" (Falcon 3) العربية عالية الأداء الذكي. وفي قطر، نموذج "الفنار" (alfanar) لمعالجة اللغة الطبيعية العربية ولهجاتها، من تطوير "معهد قطر لبحوث الحوسبة" (QCRI).
بصفةٍ عامةٍ، من المُحتمل أنّ هناك حوالى 300 إلى 800 مطوّر/باحث عربي ينشطون في مجال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة في هذه السنة 2025، ويساهمون في تطويرها؛ في الإمارات والسعودية وقطر ومصر والمغرب العربي وغيرها. بالإضافة إلى وجود حاضنات لتمويل بدء التشغيل وتطوير المواهب...
يجب التوجّه للعمل العربي المستقلّ وترسيخ السمات العربية الذكية في العتاد والبرمجيّات
مع ذلك، لا تخفى العيوب والنواقص أو العوائق التي تُعرقل التقدّم العربي المطلوب في هذا المجال، أبرزها: الاعتماد شبه الكلّي على مشاركات الشركات العالمية الأجنبية، ومنتجات التكنولوجيا المستورَدة، والأجهزة والبرمجيّات والإجراءات التقنية وأساليب الإدارة والممارسات العملية. كما أنّ لغات البرمجة الحاسوبيّة تعتمد اللغة الإنجليزية في رموزها ومفرداتها؛ وكذلك معظم العمل التكنولوجي يُدار باللغة الإنجليزية بصورةٍ أو بأخرى...
على الرَّغم من أهمية التعاون مبدئيًا مع الشريك الأجنبي، إلّا أنّه يجب التوجّه للعمل العربي المستقلّ، وترسيخ السمات العربية الذكية في العتاد والبرمجيّات. ولعلّ السؤال الأهم: إلى متى سيظلّ الاعتماد الكامل على لغات البرمجة الحاسوبيّة المنتَجة في معامل الغرب؟ وهي عصب الإنتاج التكنولوجي... وهل من فكاكٍ عربيٍّ في هذا السياق؟!.
لقراءة الجزء الأول
(خاص "عروبة 22")