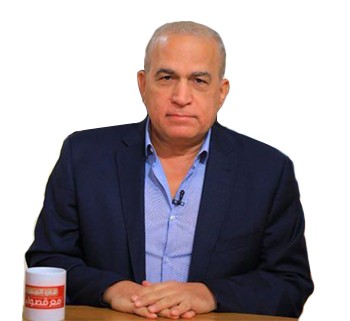لغة الحاسوب (البشرية)، بإمكانها التواصل مع "لغة الآلة" الصمّاء (شفرة الآحاد والأصفار بما تمثّله من حركة الإلكترونات في الدوائر الكهربائية المُعقّدة) عن طريق ما يعرف بالبرمجيّات الوسيطة بين الآلة والإنسان، والمُترجمات (Compilers)، والمُفسّرات (Interpreters). وتبقى بذلك اللغة الإنجليزية - التي تهمّنا في سياق هذه المسألة - هي لغة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفةٍ عامةٍ، فضلًا عن كونها لغة التجارة والصناعة والاقتصاد العالمي برمّته. أي لغة حضارة العصر!.
ليس بعيدًا عن الذهن أنَّ سيطرةَ لغةٍ ما هي سيطرةُ إنسانِها المبتكِر، وحضارتها هي حضارة نُخَبِها الفكرية والعلمية والتقنية والإبداعية، عموما. وليس بعيدًا أيضًا، جرحُنا العربيّ النازف الذي كان يومًا ما دمًا نورانيًّا يشعُّ على العالَم حضارةَ الرياضيات والهندسة والفلك والجغرافيا، إلى جانب الفلسفة والمنطق والأدب وفنون العمارة المبهرة... ألم تكن حضارةً نسيجَ وحدِها وصلتْ العالَمَ القديمَ بالحديث، وعاؤها اللغةُ العربيةُ العريقة؟!.
العلاقة طرديّة بين اللغة والحضارة وتطوّرُهما أو تراجعُهما لا يكون إلا بكليهما معًا
أما آنَ لأصحاب القرار في عالمنا العربيّ المعاصر، أن يُدركوا أنّ السّرَّ في تجسّدِ الحضارةِ تقدّمًا معنويًّا أو ماديًّا، عِلمًا وتقنيّةً وفنًّا وأدبًا، وهويّةً وخصوصيّةً... إنّما يكمُنُ في اللغة... فالعلاقةُ طرديّةٌ (Proportional) بين اللغة والحضارة، وتطوّرُهما أو تراجعُهما لا يكونُ إلا بكليهِما معًا، لا يفترقان.
ما هي العوائق، إذًا، التي تواجهُ لغتَنا العربيةَ في أن تكون لغةَ الحاسوب، لغةَ التكنولوجيا والعلوم الحديثة؟ أي لغةً حضاريّةً معاصرةً مستقلّةً، تتطوّر بذاتها وخصوصيّتها؟ وهي اللغة الغنية بمفرداتها، اشتقاقاتها، تراكيبها، وإمكانياتها المختلفة!
هناك حقائق تفرض نفسها على العالم بأسره بشأن هيمنة اللغة الإنجليزية على حضارة العصر، بخاصة من خلال اعتمادِها في لغات البرمجة الحاسوبية، كما أشرنا.
من ضمن الحقائق، أنَّ لغات البرمجة الحاسوبية، بشكلٍ عام، تتألّف من مجموعةٍ من القواعد أو التراكيب اللغوية (Syntax) والمكتبات (Libraries) التي تحوي نماذج القواعد والأشكال اللغوية المستخدمة في أجهزة الحاسوب. وغالبًا ما تتكوّن هذه القواعد من كلماتٍ مفتاحيةٍ باللغة الإنجليزية، ذات مضامين إجرائية، يُنفّذها الحاسوب ويتعامل بواسطتها، ويفهمها من خلال المُترجمات والمُفسّرات الوسيطة المُشار إليها.
كذلك الشأن، بخصوص "المكتبات البرمجيّة"، فهي الآنَ مصمَّمة عالميًّا باللغة الإنكليزية. وهنا يكمن التحدّي الرئيس في صعوبة تحويل القواعد والمكتبات والواجهات البرمجيّة (APIs) إلى لغةٍ أخرى غير الإنجليزية، نظرًا لضخامتها، وصعوبتها في ارتباطها الوثيق بشفرة الآلة. حقيقة أخرى، أنّ المبرمجين والمطوّرين في مختلف أنحاء العالم يؤدّون أعمالهم البرمجيّة باستخدام الإنجليزية، ويتبادلون المعرفة والخبرة في شتّى المشاريع المفتوحة وغيرها في المجتمعات التقنية المتنوّعة باستخدام الإنجليزية، باعتبارها أساسًا لغةَ تعليمِ الحاسوب ولغةَ التوثيقِ والمرجعية، فيرتبط المبرمج والمطوِّر ذهنيًّا باللغة الإنجليزية من بداية تعلّمه برمجة الحاسوب، ويغدو يفكّرُ من خلالها ويطوّر أفكارَه ومساهماته في آفاقها!.
ينبغي التوجّه الجاد نحو ابتكار لغة برمجة عربية والعمل على تطويرها
ممّا يزيدُ الأمرَ صعوبةً أنَّ المسألة ارتبطت بصورةٍ ما بسهولة اللغة الإنجليزية كلغةٍ تقنيّةٍ في مقابل لغاتٍ أخرى مثل الصينيةِ أو الألمانيةِ أو الهندية... ناهيك عن اللغة العربية التي يراها الكثيرون لغةً معقّدةً في الكتابة والرموز والتشكيل والرسم، ما يجعل تصميمَ قواعدِها وتراكيبِ جُمَلِها حاسوبيًّا أمرًا صعبًا للغاية، وربما تحدّيًا حقيقيًّا للخبراء والمطوّرين العرب.
لكنَّ هذه الأمور لا تمنعُ التوجّهَ الجادّ نحو ابتكارِ لغةِ برمجةٍ عربيةٍ، والعمل على تطويرها. ولنا أسوةٌ فيما قامت به دولٌ أخرى مثل الصين والهند وروسيا وبعض الدول الأوروبية غير الناطقة بالإنجليزية، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من التجارب في هذا المضمار.
يمكن، أن نبدأ عربيًّا في هذا الشأن، بتطويرِ حلولٍ ممكنة، في أربعة مساراتٍ متوازية:
أولًا: تطوير لغات برمجة عربية لأجل التعليم والتدريب، موجّهةً لأطفال المدارس والمبتدئين، لتعلّم المنطق البرمجي، واستخدام الحاسوب العربيّ بلغةِ برمجةٍ عربيةٍ بسيطة.
ثانيًا: تطويرُ واجهاتٍ برمجيّةٍ مُترجَمةٍ (IDEs) عن شفرتها الأساسية باللغة الإنجليزية، بحيث تبقى لغةُ الآلةِ كما هي، تتعامل مع المُترجمات والمُفسرات عن المفردات المفتاحية للغة الإنجليزية، بينما الواجهة المقابلة للبرمجة والتطوير والأوامر الثانوية تكون باللغة العربية.
ثالثًا: التعامل مع الكلمات المفتاحية الديناميكية في إحدى لغات البرمجة باللغة العربية بينما الحاسوب يُترجمها بأصلها الديناميكي الذي تفهمه لغة الآلة. مثلًا: كلمة (if) الشَّرطيّة بالإنكليزية، يسمح الحاسوب باستقبالها بأداة الشرط العربية (إذا)، ويُنفّذها بمضمونِ أصلِها في لغة الآلة.
رابعًا: وهو المسار الأصعب، أن يتمَّ تطويرُ لغةِ برمجةٍ حاسوبيّةٍ عربيّةٍ من الأساس، بمعنى تطوير آليّةٍ للبرمجة الإلكترونية الرقميّة بلغة الآلة التي تتعامل مع المفردات المفتاحية العربية مباشرة. بحيث تكون مستقلّةً استقلالًا كاملًا عن الاعتماد على أيِّ لغةٍ أجنبيّةٍ أخرى.
من الأفضل حاليًّا البدء بتجربة التطوير المحليّ للغة برمجة حاسوبيّة لأغراض التعليم والواجهة
الخُلاصةُ، تقنيًّا، يمكن جعلُ لغات البرمجة قويّةً وذات فعاليّةٍ عمليّةٍ بأيِّ لغةٍ بشريّة، غير أنّه حتى الآنَ، لم تَزَلْ اللغة الإنجليزية الأكثرَ قوّةً وانتشارًا، لاحتكارها المكتباتِ البرمجية، التوثيق، التعاون الدوليّ، وسهولة التكامل... من الأفضل حاليًّا، البدءُ بتجربة التطوير المحليّ للغةِ برمجةٍ حاسوبيّةٍ لأغراض التعليم والواجهة، مع استخدام قاعدةٍ إنجليزيةٍ للمكتبات والتطبيقات الواقعية، في حين يكون هناك المشروعُ الاستراتيجيّ لتحقيقِ الاستقلاليّةِ البرمجيّةِ بلغتنا العربيّة.
(خاص "عروبة 22")