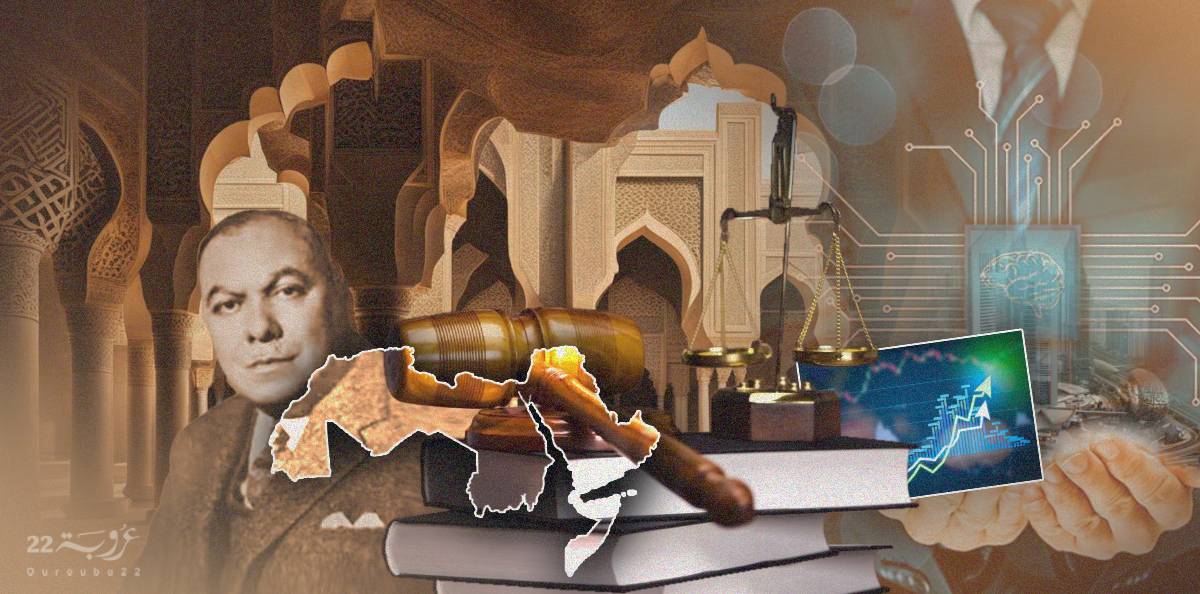القانون واحد من أهمّ العناصر التي تساهم في بناء حضارة وثقافة مشتركتَيْن لأي مجتمع لأنّه يشكّل الإطار القِيمي والأخلاقي المعروف بين النّاس، وأساس تنظيم سلوكهم اليومي، ويحدّد دوْر وصلاحيّات مؤسّسات الحكم والإدارة التّنفيذيّة والرّقابة عليها، ويرسم قواعد الإنتاج والتّجارة والمصاهرة والميراث، ويحدّد الجرائم والعقوبات.
ما سبق ليس اكتشافًا جديدًا، بل فكرة استقرّت من عقود لدى الكُتّاب والباحثين في العلوم الاجتماعيّة، بأنّ النّظام القانوني من أهمّ آليّات وحدة وترابط أي مجتمع (ثقافيًّا وحضاريًّا وسلوكيًّا). وبالمنطق عينه، فإنّ تفتّته والتعدّد في الممارسة القانونيّة بين فئات وطوائف وجماعات المجتمع الواحد يؤدّيان لتمزّقه وتناحر أطرافه وبالتالي تهديد وحدته وتآلفه وارتباطه بثقافة حضاريّة واحدة.
التنوّع لا يُضعف النّظام القانوني بل يدعمه لأنّه يجعله قادرًا على التطوّر والتّفاعل مع مكوّنات المجتمع
ولا تعني وحدة النّظام القانوني تجاهُل أو طمْس الاختلافات العقيديّة والتّبايُن في السّلوك والعادات الاجتماعيّة والخصوصيّات الثّقافية والإثنيّة. فالنّظام القانوني الواحد يُمكنه - بل يجب عليه - أن يتضمّن ويستوعب ويحترم المدارس القانونيّة والفقهيّة السّائدة، والسّلوك والعادات المتنوّعة، والممارسات التجاريّة المختلفة. مثل هذا التنوّع لا يُضعف النّظام القانوني، بل يدعمه لأنّه يجعله قادرًا على التطوّر والتّفاعل مع مكوّنات المجتمع الذي ينظّمه. ولكن بشرط أن يُبقي الاختلاف والتعدّد في إطار رؤية متّسقة لمفاهيم القانون والحقّ والالتزام والعدالة، أي ما يسمّى بالمدرسة القانونيّة التي لكلٍّ منها فلسفته وطابعه ومنهجه وأساليبه.
وبتطبيق ما سبق على الوطن العربي فسنجد أنّ التحوّل الأكبر فيه جرى خلال المئويّة الأخيرة للدّولة العثمانيّة بعد دخولها في مرحلة الضّعف المُزمن، وارتباط ذلك بالاستعمار الأوروبي الذي كانت الامتيازات الأجنبيّة تعبيرًا قانونيًّا عن مطامعه في المنطقة.
ويصف الفقيه القانوني الأستاذ الدّكتور حسام الدّين الأهواني - في مؤلّفه القصير والمهمّ "معالم النّظام القانوني العربي" الصادر عن وزارة العدل العراقيّة العام الماضي - الامتيازات الأجنبيّة التي منحتها الدّولة العثمانيّة للدّول الأوروبيّة بأنّها تعبير عن التّبعية أو الاستعمار القضائي.
فالعلاقة إذن، من وجهة نظرِه، بين التّبعيّة السياسيّة والتّبعيّة القانونيّة وثيقة للغاية، بخاصّة أنّ التّبعيّة القانونيّة تكون ضروريّةً لتحقيق التّبعيّة الثّالثة والأهم، وهي الاقتصاديّة التي أعتبرُها شخصيًّا المقصد الأوّل والنّهائي لحركة الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر.
ولكن كما أنّ ليس كل ما يأتي مع الاستعمار من تطوير وتحديث في العلوم والفنون والإدارة سيئًا، بل فيه منافع كثيرة، كذلك فإنّ المحصّلة النّهائيّة لدخول نُظُم قانون مُعاصرة ومُنضبطة ومُمنهجة إلى الوطن العربي كانت في تقديري إيجابيّة، خصوصًا حينما تلقّف هذا التطوّر أجيال من القانونيّين العرب الوطنيّين الذين عقدوا العزم على امتلاك ناصية الفنّ القانوني الأوروبّي واستخدامه بشكل وطني ومستقلّ في بناء قواعد نظام قانوني عربي جديد.
النّظام القانوني أداة أساسيّة في توحيد الأمم والمجتمعات أو في إيجاد الشّقاق بين صفوفها وتعميقه
وليست مصادفةً أن يختار الدّكتور الأهواني إهداء مؤلّفه عن النّظام القانوني العربي للعلّامة الفذّ ورائد مدرسة القانون العربي المستقلّ عبد الرزّاق السّنهوري، الذي لم يرفض القانون الأوروبّي ولم يُنكره ولم يُحاربه، بل أخذ بزمامه وتعمّق فيه وعاد فطوَّعه لصالح مجتمعاتنا العربيّة، ثم أضاف إليه الكثير بما جعله مجدِّدًا حقيقيًّا لا مجرّد ناقل.
النّظام القانوني إذن جزء لا يتجزّأ من صراع التّبعيّة والاستقلال. والأهمّ أنّه أداة أساسيّة في توحيد الأمم والمجتمعات أو في إيجاد الشّقاق بين صفوفها وتعميقه.
واليوم يقف الوطن العربي عند مفترق طرق من هذه القضيّة. ففي أعقاب نجاح حركات التحرّر الوطني في تخليص بلداننا العربيّة من الاحتلال الأجنبي، خرج معظمها منتميًا للمدرسة القانونيّة الفرنسيّة اللّاتينيّة من خلال انتمائه للإمبراطوريّة العثمانيّة التي تبنّت هذا الاتجاه أو تأثّرًا بحركة التّحديث القانوني المصريّة. وخلال النّصف الثّاني من القرن العشرين يُمكن القول إنّ مدرسةً قانونيّةً حديثةً مستقلّةً نشأت وتطوّرت في الوطن العربي، بجذورٍ في الشّريعة الإسلاميّة وبنيةٍ معاصرةٍ منتميةٍ للمدرسة اللّاتينية وتعريبٍ وتطويرٍ مصري أوّلًا ثم من مختلف أقطار الوطن العربي.
وأعود لمفهوم الثّقافة القانونيّة المشتركة الذي يتجلّى في وقوف المحامي المصري أو الأردني أو العراقي أو الكويتي أو الجزائري أمام محكمة بلده، مستندًا في مرافعته لنظريّة الالتزامات عينها المستمدّة من القانون الرّوماني ثم الفرنسي، ومستشهدًا بكتابات العلّامة السنهوري وزملائه، ومقتبسًا من أحكام محكمة النّقض المصريّة وآراء الفقهاء من مختلف البلدان العربيّة، ومشاركًا في كتابة قوانين ليبيّة ويمنيّة أو في تدريس القانون في كليّات الحقوق بالجزائر والكويت.
النّظام القانوني العربي إذن ليس فكرةً نظريّةً ولا حلمًا بعيد المنال، بل حقيقةً بُنيت عبر مئات السّنين، وترسّخت بشكلٍ معاصرٍ خلال القرن الماضي، وصارت تدريجيًّا واحدةً من أشدّ وأمتن وأعمق الرّوابط الحضاريّة والثقافيّة والقيميّة التي تحدّد هُويّتنا العربيّة.
خطر حقيقيّ يهدّد وحدة النّظام القانوني العربي مصدره العشوائيّة في اقتباس النُظُم القانونيّة
واليوم تقف الأمّة العربيّة عند مفترق طرق من هذه القضيّة... لماذا الآن بالذّات؟ لسببَيْن رئيسيَّيْن:
الأول؛ أنّ معظم بلدان العالم العربي تمرّ منذ سنوات قليلة في مرحلة إعادة صياغة أنظمتها القانونيّة والرقابيّة وبخاصّة فيما يتعلّق بالاقتصاد والاستثمار والأنشطة الماليّة والتجاريّة، سواء بلدان الخليج العربي حيث النّشاط التّشريعي الاقتصادي في ذروته، أو البلدان التي انخرطت في هذا المسار منذ عقود وقطعت فيه أشواطًا - بدرجاتٍ مختلفة من النّجاح - كمصر والمغرب وتونس والأردن، أو حتى تلك التي تعمل على رأب صراعاتها وحروبها الداخليّة كالعراق وسوريا وليبيا. بعضها يسلك هذا الطّريق إدراكًا لأهميّة التطوير التّشريعي، وبعضها تحت ضغط مؤسسات التّمويل الدوليّة، وبعضها رغبة في جذب استثمارات محدّدة وعاجلة.
المهم أنّ هناك نشاطًا تشريعيًّا اقتصاديًّا واسع النّطاق حادث في المنطقة العربيّة منذ سنوات وأظنّه سيمتدّ لسنوات أخرى مقبلة.
أما السبب الثّاني - وربما الأهمّ - فهو أنّه في غمار هذا النّشاط التّشريعي فإنّ خطرًا حقيقيًّا يهدّد وحدة النّظام القانوني العربي المبنيّة، كما سبق الذّكر، عبر القرون. هذا الخطر مصدره العشوائيّة في اقتباس النُظُم القانونيّة، والرّغبة في الإسراع بالتّحديث والتّطوير من دون بذل الجهد الكافي للتحقّق من أنّ التّشريعات الاقتصاديّة الحديثة متوافقة مع الأسُس القانونيّة والرقابيّة الموجودة بالفعل.
وهكذا مثلًا نجد اقتباسًا لتشريعات أنغلوسكسونيّة في المجالات الماليّة بغير توافق أو انسجام مع قواعد القوانين المدنيّة ذات الطابع اللّاتيني، وتوسّع في إنشاء مناطق ذات طبائع اقتصاديّة وقانونيّة خاصّة خارجة عن النّظام القانوني العام في البلد، وتعدّد في الأنظمة القانونيّة الحاكمة للموضوع عينه أيضًا في البلد ذاته كما لو كان هناك نظام للوطنيّين وآخر للأجانب بما يكاد يُعيدنا لعصر الالتزامات الأجنبيّة.
حركة التّحديث القانوني والرّقابي في أرجاء الوطن العربي تحتاج ألّا يسيطر عليها أسلوب الاجتزاء والتّفتيت
شخصيًّا، فإنني لست على الإطلاق ضدّ الاقتباس من النُظُم القانونيّة البديلة، بما فيها النظام الأنغلوسكسونيّ المتفوّق في مجالات التّمويل والاستثمار والمعاملات التجاريّة، ولكن يقلقني للغاية الأخذ ببعض أفكارها، بل ونصوصها خارج السيّاق المناسب والمتوافق مع القواعد الرّاسخة للنّظام اللّاتيني التي تشكّل أساس النّظام القانوني العربي المعاصر.
لهذَيْن السببَيْن فإنّ علينا - نحن القانونيّون والاقتصاديّون والمفكّرون والسياسيّون العرب - أن ندرك أوّلًا أنّ النّظام القانوني العربي حقيقة واقعة وتراث عظيم بُني عبر القرون، وثانيًا أنّ حركة التّحديث القانوني والرّقابي الجاريّة في مختلف أرجاء الوطن العربي، وهي في حدّ ذاتها حركة محمودة وإيجابيّة، تحتاج ألّا يسيطر عليها أسلوب الاجتزاء والتّفتيت بل تظلّ في إطار فهمٍ ثقافيٍ واجتماعيٍ يُدرك القيمة الحضاريّة والسياسيّة للإبقاء على وحدة النّظام القانوني العربي والدّفاع عنه وتطويره بما يتوافق مع متطلّبات العصر واحتياجات النّهوض الاقتصادي.
(خاص "عروبة 22")