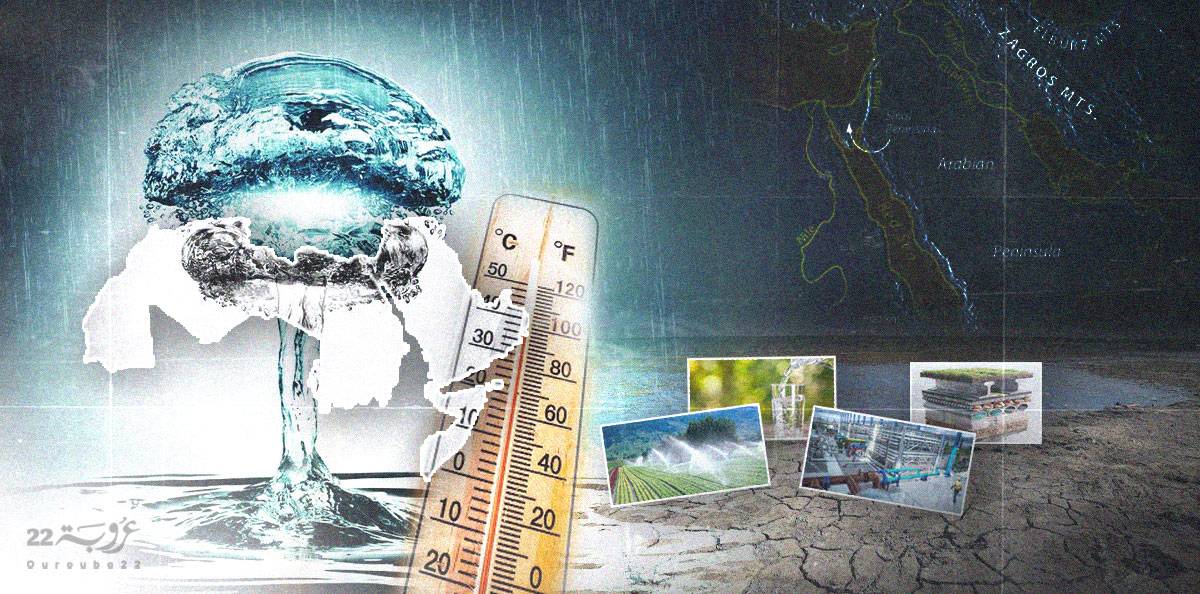تُـواجه الموارد المائية في المنطقة العربية العديد من التحدّيات والضغوط المتشابكة على مختلف الأصعدة. ونتيجةً للزيادة السكانيّة السريعة التي تتجاوز نسبتها 2% سنويًا، أصبحت 19 دولةً من أصل 22 تحت عتبة النّدرة المائية التي تُقدّر بـ1000 مترٍ مكعّبٍ سنويًا للفرد. من بين هذه الدول، هناك 13 دولة وصلت إلى مستوى النّدرة المائية المُطلقة، أي أقلّ من 500 مترٍ مكعبٍ سنويًا للفرد. هذا الوضع يؤثّر في حوالى 390 مليون نسمة يعيشون في بلدانٍ تعاني من ندرة مائية حادّة.
ومن المتوقّع أن تتّسع الفجوة المائية لتصل إلى 130 مليار مترٍ مكعبٍ خلال الفترة من 2020 إلى 2030، ممّا يزيد من خطورة تهديد الأمن المائي، الذي يُعدُّ محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وصحة الإنسان وسبُل العيش.
شهدت المياه الجوْفية انخفاضًا كبيرًا مما يُثير مخاطِر كبيرة على استدامة الموارد المائية في المستقبل
ومع زيادة الطّلب على المياه، بخاصة في المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية أو تعجز عن تلبية احتياجاتها المُتزايدة، ارتفعت معدّلات استخراج المياه الجوْفية إلى مستوياتٍ تتجاوز حدود السحب الآمن. في الوقت نفسِه، تراجعت معدّلات تغذية المياه الجوْفية بسبب موجات الجفاف المتكرّرة، مما أدّى إلى استنزاف كمياتٍ كبيرةٍ منها. في أجزاء واسعة من المنطقة العربية، شهدت المياه الجوْفية انخفاضًا كبيرًا في منسوبها وتدهورًا في نوعيّتها، متجاوزةً بذلك الحدود الاقتصادية لعملية الضخّ، خصوصًا في الخزّانات غير المتجدّدة، مما يُثير مخاطِر كبيرة على استدامة الموارد المائية في المستقبل.
وقد تناولنا في مقاليْن سابقيْن (الأول - الثاني) مظاهر الشحّ المائي، وأبرز التحدّيات المائية التي تواجه العالم والدول العربية في ظلّ تغيّر المناخ، وزيادة الطلب العالمي، والتوتّرات الإقليمية التي تضيف مزيدًا من الضغوط على الأمن المائي. كما تطرّقنا إلى الاستراتيجية الشاملة للأمن المائي في الوطن العربي عن الفترة ما بين 2010 و2030 والتي أقرّها المجلس الوزاري العربي للمياه، التابع لجامعة الدول العربية في عام 2011.
وفي مايو/أيار من عام 2014، تبنّى المجلس الوزاري العربي للمياه خطة عملٍ تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي. وقد صُمّمت هذه الخطة لتغطّي الفترة حتى عام 2020 مع مراجعتها وتحديثها كلّ خمس سنوات لضمان فعاليتها واستجابتها للتغيّرات والاحتياجات المستقبلية.
يجب تنمية القدرات البشرية والمؤسّسية لضمان تطبيق استراتيجيّات فعالة لإدارة الموارد المائية
وفي الاجتماع التحضيري الإقليمي الذي عُقد في بيروت في مارس/آذار 2018 حول قضايا المياه، ضمن المنتدى العربي للتنمية المُستدامة والمُنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018، اتفق ممثلو الدول الأعضاء في "الإسكوا" و"المجلس الوزاري العربي للمياه"، إلى جانب ممثلين عن المؤسّسات الوطنية والإقليمية والدولية ومنظّمات المجتمع المدني، على أهميّة الإدارة المُتكاملة للموارد المائية في تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة لعام 2030.
تمّ تسليط الضوء على وسائل تنفيذ أساسيّة يمكن من خلالها دعم الإدارة المُتكاملة للموارد المائية، ومن أهمّ هذه الوسائل: تعزيز التعاون الإقليميّ بين الدول، تحقيق الاتّساق الوطني والتنسيق الفعّال بين القطاعات المختلفة، اعتماد نُهُجٍ تشاركيةٍ تشمل جميع الأطراف المعنية، نقل التّكنولوجيا لتطوير حلولٍ مائيةٍ مبتكرة، توفير التمويل اللّازم وزيادة الاستثمارات المخصّصة لمشاريع المياه، وتنمية القدرات البشرية والمؤسّسية لضمان تطبيق استراتيجيّات فعالة لإدارة الموارد المائية.
على المستوى الإقليمي، صدرت الاستراتيجية الموحّدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي (2016–2035). وتهدف الاستراتيجية إلى إنشاء أنظمةٍ فعّالةٍ وعادلةٍ وآمنةٍ لإدارة الموارد المائية بحلول عام 2035، بحيث تُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المُستدامة. وتعكس هذه الرؤية المفاهيم الحديثة للأمن المائي التي تُركِّز على الاستدامة والعدالة. ومع ذلك، تُشدّد الاستراتيجية أيضًا على القضايا التقليدية للأمن المائي، مثل الحماية من الحروب والهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى حماية مياه الشرب من التلوّث.
وتشترك الاستراتيجية الموحّدة مع الاستراتيجية العربية للأمن المائي في معالجة تحدّيات رئيسية عدّة، مثل الاعتماد الكبير على تحلية المياه، والاستخدام المُفرط للمياه الجوْفية المُتجدّدة وغير المُتجدّدة وتدهورها. ومع ذلك، تُقدّم الاستراتيجية الخليجية رؤيةً مفصَّلةً ومنهجيةً للتعامل مع هذه التحدّيات من خلال خمس ركائز استراتيجيّة أساسيّة هي: تنمية الموارد المائية واستدامتها، والاستخدام الكفء والعادل للموارد المائية، وتعزيز أمن إمدادات المياه البلدية، والإدارة الفعّالة والتوعية المائية، والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية.
ومن بيْن أشكال التعاون الممكنة، ما هو أقلّ رسميّةً ويشمل أنشطةً ثنائيةً أو على مستوى أحواض المياه المُشتركة، يمكن أن تؤدّي إلى تعاونٍ رسميّ أكثر اتّساعًا. تتضمّن هذه الأنشطة بناء القدرات، ومراقبة البيانات وتبادلها، وإجراء دراسات مشتركة لتحسين المعرفة بالموارد المائية المُشتركة، وتنظيم بعثات لتبادل المعرفة، وجولات دراسية بين الدول المُشاطِئة. على سبيل المثال، صادقت تشاد ومصر وليبيا والسودان على اتفاقيةٍ إقليمية (برنامج العمل الاستراتيجي) لتنسيق إدارة الخزّانات الجوْفية المشتركة في عام 2013. ويضع البرنامج الأساس لأنشطة المجتمع المتّفق عليها لإدارة طبقات المياه الجوْفية، مسلّطًا الضوء على الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسّسية الأساسية على المستويَيْن الإقليمي والوطني لمواجهة التحدّيات الرئيسية العابرة للحدود، التي تضرّ بطبقة المياه الجوْفية وأسبابها الأساسية. ولكن نظرًا للحرب في ليبيا فلم يتم تفعيل هذه الاتفاقية بشكلٍ كامل.
تعزيز التعاون في مجال المياه يتطلّب وجود إرادة سياسية قوية على الصعيدين الوطنيّ والإقليميّ
وتشمل الأنشطة - الأكثر تقدّمًا - إنشاء آلياتٍ مشتركةٍ للتشاور بشأن أحواض المياه المشتركة. على سبيل المثال، تعاونت تونس والجزائر وليبيا، التي تتشارك نظام طبقة المياه الجوْفية لشمال الصحراء الغربية، من خلال مشاريع مشتركة مموّلة دوليّا. وفي عام 2008، وبدعمٍ من مرصد الصحراء الكبرى والساحل، أنشأت الدول الثلاث آليةً للتشاور حول شبكة طبقات المياه الجوْفية لشمال الصحراء الغربية وواصلت تبادُل البيانات وتحديث قاعدة البيانات المشتركة.
يتطلّب تعزيز التعاون في مجال المياه وجود إرادةٍ سياسيةٍ قويةٍ على الصعيديْن الوطنيّ والإقليميّ، بالإضافة إلى دعمٍ إقليميّ ودوليّ. في بعض الحالات، يمكن استكشاف روابط تتجاوز قطاع المياه، مثل التّرابط بين الأمن المائي والطاقة والغذاء، لتوفير حوافز إضافيةٍ للتعاون وتعزيز الثقة بين الدول المُشاطِئة.
لقراءة الجزء الأول، الجزء الثاني
(خاص "عروبة 22")