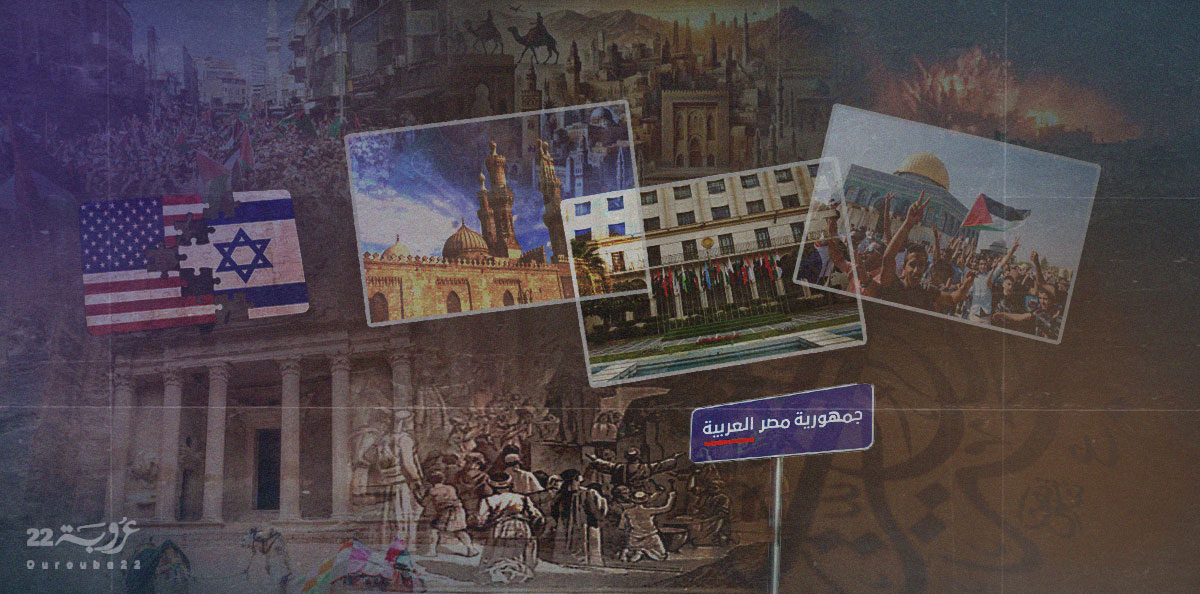يُغْفِلُ هذا الخطاب أنّ العروبة لم تكن يومًا وعدًا بالخلاص السريع، بل كانت دائمًا مشروعًا طويل النّفَس، يتطلّب بناءً ثقافيًا، وتراكمًا سياسيًا، واستعادةً للكرامة الجمعيّة. أسوأ ما في هذا الخطاب أنّ من يُطالبون اليوم بقتل الهوية، لا يملكون بديلًا، وفقدوا القدرة على الحلم، وارتضوا بالنجاة الفردية بدلًا من التحرّر الجماعي.
إذا كان الانكسار قد دفع البعض إلى إعلان موت العروبة، فإنّ السؤال الأعمق لا يتعلّق بالهوية ذاتها، بل بمَن احتكر تمثيلها، وبالسلطة التي شوّهتها. هنا تبدأ المفارقة: هل نحن أمام أزمة هوية؟ أم أمام أزمة سلطة احتكرت الحديث باسمها؟
ساهمت الأنظمة العربية في تشويه العروبة حين جعلتها خطابًا فوقيًا فارغًا أو غطاءً لسياسات انعزالية وقمعيّة
ليس من الإنصاف أن يُحمّل المشروع العربي وزر إخفاقات الأنظمة التي ادّعت تمثيله. فالعروبة ليست مسؤولةً عن القمع، ولا عن الفساد، ولا عن التواطؤ السياسي الذي مارسته أنظمة عربية متعدّدة على مدى عقود.
الخلط بين الهوية والسلطة هو أحد أخطر أشكال التبسيط. فلقد ساهمت الأنظمة العربية، من دون استثناء، في تشويه العروبة، حين جعلتها خطابًا فوقيًا فارغًا، أو أداة تعبئةٍ موقتةٍ، أو غطاءً لسياسات انعزالية وقمعيّة. هذا التشويه لا يعني أنّ الهوية نفسها فاسدة، بل يؤكد أنّ من تولّى تمثيلها قد خانها. فهل نُدين الفكرة لأنّ من حملها قد أساء إليها؟ وهل نُعلن موت العروبة لأنّ الأنظمة التي ادّعت الدفاع عنها قد تواطأت ضدّها؟
كره الهوية، في هذا السياق، ليس فعلًا نقديًا، بل هو استسلامٌ لردّ فعلٍ عاطفيّ، يُحمّل العروبة ما لا تحتمله، ويُفرغُها من مضمونها التاريخي. ويُغفِل أنّ العروبة ليست نظامًا سياسيًا، ولا حزبًا، ولا سلطةً، بل هي مجالٌ للانتماء، وللتضامن، وللذاكرة المشتركة. وهي، في جوهرها، مشروع حُلم، لا مشروع حُكم. ومن يخلط بينهما، يُسهم في قتلها، من دون أن يدري.
لا يمكن فهم أزمة الهوية العربية من دون التوقّف عند مركزها التاريخي والثقافي: مصر. فحين تتراجع مصر عن دورها، لا تخسر وحدها، بل يتراجع معها المشروع العربي. من هنا، يصبح الحديث عن العروبة حديثًا عن مصر، وعن علاقةٍ وجوديةٍ لا ظرفية.
مَن يروّج لفكرة أنّ مصر يمكن أن تتجاوز العروبة يُسهم في تفكيك ما تبقى من المشروع العربي
ليس من المبالغة القول إنّ العروبة من دون مصر تفقد قلبها، وإنّ مصر من دون العروبة تفقد حقيقتها. فالعلاقة بين الطرفَيْن ليست علاقة مصلحةٍ أو ظرفٍ سياسيّ، بل علاقة تكوينية، تشبه علاقة الروح بالجسد، أو الذاكرة بالوعي. مصر ليست مجرّد دولة عربية كبرى، بل هي مركز الثقل التاريخي والثقافي الذي منح العروبة شرعيّتها، واحتضن مشروعها، وصدّر رموزها.
كانت مصر، عبر قرون، حاضنةً للفكر العربي، ومنصّةً للنهضة، ومركزًا للمقاومة. من الأزهر إلى الجامعة العربية، ومن عبد الناصر إلى نجيب محفوظ، كانت مصر تمدّ الوجدان العربي، وتمنحه لغته، وإيقاعه، وأحلامه. وحين تراجعت مصر عن هذا الدور انتكس معها المشروع العربي.
مصر لا تستطيع أن تنهضَ وحدها، مهما بلغت من القوة أو الطموح. فالجغرافيا وحدها تُلزمها بالانتماء، والتاريخ يُحاصرها بالذاكرة، والواقع يُجبرها على الاعتراف بأنّ أمنها القومي، وازدهارها الاقتصادي، ومكانتها الحضارية، كلّها مشروطة بوجودٍ عربيّ متماسك.
جرّبت مصر الانكفاء، وجرّب العرب التشرذم، وكانت النتيجة عهودًا من التيه، ومن التبعية، ومن الانكسار.
تشويه العروبة جرى عبر ربطها بالاستبداد وتجريدها من السرديات الجامعة وإنتاج بدائل هوياتية
مَن يروّج لفكرة أنّ مصر يمكن أن تتجاوز العروبة، أو أنّ العروبة يمكن أن تستمرّ من دون مصر، يُسهم في تفكيك ما تبقّى من المشروع العربي، ويُعيد إنتاج الهزيمة بوصفها خيارًا. فالعروبة ليست مجرّد انتماء لغوي أو ثقافي، بل هي شرط وجودي لمصر، كما أنّ مصر هي شرط حيويّ للعروبة. مَن يفصل بينهما، يُفرّغ كليهما من المعنى.
وإذا كانت مصر قد تراجعت، فإنّ السؤال لا يقتصر على دورها، بل يمتدّ إلى طبيعة المشروع العربي نفسه: كيف تم تشويهه؟ ومن حوّله من طاقة تحرّر إلى عبءٍ رمزيّ؟ هنا تبدأ رحلة تفكيك العروبة المُفترى عليها، لا بوصفها فكرةً فاشلةً، بل كهويةٍ تمّ استهدافها عمدًا.
لقد عملت قوى إقليمية ودولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى عقودٍ، على ضرب العروبة في جوهرها، لا في مظاهرها. لم يكن الهدف فقط إسقاط الأنظمة، بل تفريغ الشعوب من ذاكرتها، وتحويل الانتماء إلى عبءٍ، والهوية إلى تهمة.
وقد جرت عملية التشويه عبر ثلاث آليات مُتكاملة:
أولًا: ربط العروبة بالاستبداد إذ جرى تصوير العروبة بوصفها خطابًا سلطويًا، مرتبطًا بالقمع، وبالأنظمة العسكرية، وبالشعارات الجوفاء. وهكذا تمّ اختزالها في تجربة عبد الناصر، ثم تحميلها مسؤولية كلّ ما تلاها من انكسارات، على الرَّغم من أن مَن خلفوه تخلّوا عنها فعليًا، لا أنّهم ورثوها.
العروبة فكرة خطرة على مَن يريدون السيطرة على هذه المنطقة
ثانيًا: تفكيك اللغة الرمزية للعروبة فتمّ تجريد العروبة من رموزها الثقافية، ومن سرديّاتها الجامعة. لم تعدْ فلسطين مركزًا للوجدان، ولا المقاومة فعلًا مشتركًا، ولا اللغة العربية مجالًا للتراكم الحضاري. تمّ تحويل كلّ ذلك إلى عناصر مشتّتة، تُستخدم عند الحاجة، وتُنسى عند الضرورة.
ثالثًا: إنتاج بدائل هوياتية مشوّهة في مقابل العروبة، فتمّ الترويج لهويات قُطرية ضيّقة، أو دينية مُغلقة، أو إيديولوجية مستوردة، لا تملك جذورًا في الواقع العربي. فتحوّلت الهوية من مجالٍ للتضامن إلى ساحةٍ للتنازع، ومن طاقة انعتاقٍ إلى أداة تفكيك.
هذا التشويه لم يكن مجرّد مؤامرة خارجية، بل وجد له وكلاء محليين، في الإعلام، وفي الثقافة، وفي السياسة. بعضهم فعل ذلك عن وعيٍ، وبعضهم انساق خلف خطاب الهزيمة، واعتقد أنّ الخلاص لا يكون إلّا بقتل الذاكرة. فساهمت النّخب المهزومة في إعادة إنتاج هذا التشويه، حين تخلّت عن اللغة الجامعة، وارتضت بالانكفاء القُطري، واحتفت بالانفصال عن التاريخ، وخيانة المستقبل.
العروبة لم تُهزم لأنّها فكرة فاشلة، بل لأنّها كانت، وما تزال، فكرةً خطرةً على مَن يريدون السيطرة على هذه المنطقة. فهي، في جوهرها، مشروع تحرّر، لا مشروع تبعية. ومن هنا، فإنّ الدفاع عنها لا يعني التمسّك بالماضي، بل يعني استعادة القدرة على الحلم، وعلى الفعل، وعلى بناء مستقبلٍ لا يُصاغ في غرف الآخرين.
يُقال إنّ العروبة ماتت. لكنّ السؤال الأصدق ليس عن موتها، بل عمّن أعلن وفاتها، ولماذا.. فالموت، في هذا السياق، ليس حدثًا بيولوجيًا، بل خطابًا سياسيًا، يُراد له أن يُصبح حقيقةً بالتكرار، لا بالبرهان.
العروبة لم تُشوّه لأنّها فشلت، بل لأنّها أزعجت، وأربكت، وهدّدت مشاريع الهيمنة.
ما مات، في الحقيقة، هو النظام العربي الرسمي، الذي تخلّى عن العروبة حين لم تعدْ تخدم مصالحه الضيقة. وما مات هو الخطاب التعبوي الذي استُهلك حتّى فقد صدقيته. وما مات هو الحلم الساذج بالوحدة الفورية، من دون شروط أو سياقات. لكنّ العروبة، كهوية، وكذاكرة، وكطاقة مقاومة، لا تموت بهذه السهولة. لأنّها ليست مشروعًا فوقيًّا، بل وجدانًا شعبيًّا، يتجدّد كلّما ظنّ البعض أنّه انتهى.
العروبة ستبقى حيّة على الرغم من نكوص الأنظمة وخذلانها
إنّ إعلان موت العروبة ليس تحليلًا موضوعيًا، بل رغبة سياسية، هو ـ في جوهره ـ إعلانٌ عن فوز مشروع الهيمنة، وعن نجاحه في تحويل الانتماء إلى عبءٍ، لكنّه انتصار مؤقت، لأنّ الشعوب لا تُستبدل هوياتها بقرارات فوقية.
العروبة ليست في حاجةٍ إلى مَن يُعلن وفاتها، بل إلى مَن يُعيد اكتشافها، بعيدًا عن الشعارات، وبالقرب من الناس، ومن اللغة، ومن الألم المشترك.
مصر، في قلب هذا السؤال، لا تملك أن تتنصّل من عروبتها من دون أن تتنصّل من ذاتها. والعروبة، في المقابل، تكتمل بفاعلية مصر. فالعلاقة بينهما ليست ظرفًا سياسيًا، بل موقفًا حضاريًا، لا يُفهم إلّا في سياق إعادة بناء الذات الجماعية التي تمّ تفكيكها عمدا.
كُرهُ الهوية يأسٌ لا يليق بأمّة العرب، ولا يمكن أن يكون حلًّا. بل هو بداية موتٍ جماعيّ بطيء، لا يُفضي إلى حرية، بل يسوقنا إلى فراغ. أمّا العروبة، المُفترى عليها، فهي ما تزال وستبقى حيّةً في اللغة، وفي الذاكرة، وفي المشاعر، وفي بقاء فلسطين في قلب الوجدان العربي، على الرَّغم من نكوص الأنظمة وخذلانها.
(خاص "عروبة 22")