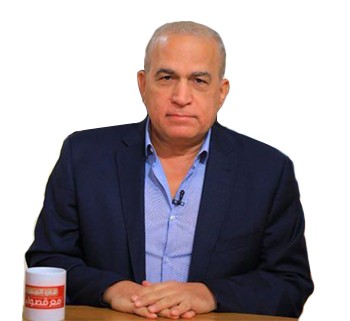من هنا، يمكننا أن نعتبرَ بشكلٍ مسبقٍ أنّ مسألة الصراع على الأساس الديني أو الصراع ما بين الأديان موجود حاليًا في قلب السياسة الدولية بشكلٍ أو بآخر، إذ يُمثّل الصراع العربي - الإسرائيلي اليوم نموذجًا دراسيًا للّاهوت الجيوسياسي المُعاصِر وتأثيره في بناء وتوجيه العلاقات الإقليمية والدولية.
لقد ساد الاعتقاد منذ سيادة فكرة التقدّم الذي أُحرز في مجال حرية الوعي بفضل النهضة الأوروبية ثم فلسفة الأنوار، وكذلك بفضل انتشار مبادئ الجمهورية الفرنسية في جميع أنحاء العالم، أنّ الدين تمّ تحجيمه وتهميشه تحت مطلب الدولة العِلمانية.
لكن هذا التقدّم الذي تمّ حصر معناه، بمعنى ما، في التراجع الديني، لم يلبث طويلًا لتنكشف في ثناياه توجّهات دينية وعِرقية على مستوى رسم الحدود الجغرافية والسياسية وبناء التحالفات الإقليمية والدولية. وقد يكون التحالف الأميركي - الأوروبي - الإسرائيلي في تحديد جغرافيا الشرق الأوسط أبرز مثال على ذلك.
يُستعمل الدين في الداخل الإسرائيلي للسيطرة على المجتمع كما أنّه وسيلة لتمديد هذه السيطرة إلى الخارج
إنّ الفكرة التي تأسّست عليها دولة إسرائيل هي الحرب الدائمة لرسم الوجود كما قدمته السرديّة التوراتية، وهي توجهاتٌ استعانت بالفكر الأنواري الغربي لتحقيق التنبّؤ الديني، ومن ثم استلهمت الفكر التطوّري القادر على رسم مستقبلٍ أبعد ممّا هو كائن. وقد برزت معالم هذا التوجّه خلال سبعينيّات القرن الماضي، بخاصّة بعد استيلاء إسرائيل على كلٍّ من القدس والخليل والأماكن المقدّسة، واعتبرت الصهيونية هذا الحدث معجزةً من الله لصالح الشعب اليهودي. هذه البشارة الدينية هي بشارة لإمكان تحقّق إسرائيل الكبرى داخل العمق العربي، ممّا جسّد نقطة البداية الحقيقية لاستغلال الدين في ظلّ هذا الصراع الجيوسياسي.
قد يسمح لنا هذا بالقول:
ــ غالبًا ما يكون الدين حاضرًا في السلوكات السياسية، بشكلٍ رسميّ أو غير رسميّ، والحال أنّ إغفال هذا الاضطراب، سواء في الغرب أو في الإسلام، والقول بقبول وجود تجانسٍ بين الهويات وحيادية التوجّهات السياسية الداخلية والخارجية، هو قولٌ لا يستقيم ما دام يتناسى ما هو حيويّ في كلّ ثقافة.
ــ يُستعمل الدين في السياق الإسرائيلي بشكل داخلي وخارجي، فعلى المستوى الداخلي يُساهم في السيطرة على المجتمع، كما أنّه وسيلة لتمديد هذه السيطرة إلى الخارج، وكلّما كان الاستخدام الخارجي للدين قويًّا، كلّما تطلّب الأمر أن يمتدّ إلى النظام الداخلي. ولكنّ هذه العلاقة قد ينتج عنها توجّه سلطوي ديكتاتوري حيث يتمّ الاستناد إلى القيم أو العقائد الدينية لتبرير السلطة الداخلية، وفي المقابل الاستمرار في إشعال حروب خارجية لتعزيز واستدامة السلطة الداخلية.
ــ ارتباط المبدأ الديني في تحديد الأرضيّة الجيوسياسية للرجل العربي المسلم تختلف عن تلك التي قدّمناها عند الرجل اليهودي، لأنّ الرجل العربي المسلم لا ترتبط لديه بتحالفِ الديني/الجغرافي مع السياسي، خصوصًا أنّ العالم الغربي استطاع منذ مطلع القرن التاسع عشر أن يستوطن، بشكلٍ مّا، مفهوم العِلمانية في البقاع العربية في إطار فهم حدّي تطرّفي يقول بفصل الدين عن الأمور السياسية، فلم يجعل من الأمر السياسي ترجمةً أو توالفًا أو ترادفًا للمطلب الديني بقدر ما خلق تنافرًا بينهما، فيتمّ في الغالب صهر أحدهما في جوف الآخر (القالب الديني/العلماني).
منطق التحالفات بين الدول يتحكّم فيه بالدرجة الأولى القُرب الديني والإيديولوجي
ــ إنّ ما نعيشه اليوم من صدمةٍ إنسانيةٍ أو صدمة انهيار القيم الأخلاقية الإنسانية، كما تمّ الترويج لها من خلال المشروع الحداثي الغربي، هي صدمة تعكس نمط تمثّلنا لهذا المشروع وكذا درجة انصهارنا معه لدرجةٍ غابت فيها أدنى مستويات القراءة النقدية. فالإشكال هنا لا يَكمن في هذا الانزياح ــ الذي يدخل في مجال المتوقّع ــ عما اعتقدناه مُستقيمًا، بقدر ما يَكمن في نمط فهمنا ودرجة انغراس هذا المشروع في وعينا الثقافي.
ــ نمط التوسّعات الغربية في الشرق الأوسط ترسم، بمعنى ما، تداخلًا للمصالح الثقافية، وخاصّةً ذات البعد الديني. ففي سياق النزعات، تتدخّل كلّ دولة لصالح من يشاركها الهوية الدينية، وبالنتيجة، سيظلّ منطق التحالفات بين الدول يتحكّم فيه بالدرجة الأولى القُرب الديني والإيديولوجي، وهو ما على الجانب العربي الإسلامي استيعابه.
(خاص "عروبة 22")